قراءة أوَّليّة في الأبعاد الاستراتيجيّة لجائحة كورونا
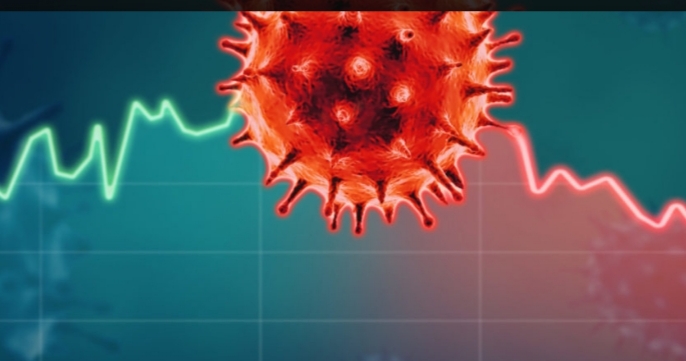
د. كمال حمدان _ مفكّر وخبير اقتصادي من لبنان/
العالَم ما بعد كورونا لن يكون كما قبله. هذا في اختصار ما يُمكن استنتاجه بشكلٍ مَبدئيّ من تعاقُب تداعيات هذا الوباء على الصُّعد الدوليّة كافّة، السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والصحيّة والاجتماعيّة. ولأنّ هذه التداعيات لم تكتمل فصولاً بسبب استمرار تفشّي الوباء واستمرار تواتُر مُندرجاته المتنوّعة وتفاعُلها، ولأنّ ما يجري تداوله عالَميّاً من مُعطياتٍ إحصائيّة حول آثاره المتعدّدة لا يزال مجرّد تقديرات أوّليّة قابِلة للتعديل والمُراجَعة تبعاً لمَسار تطوُّر هذه الجائحة، فإنّ مُقارَبتنا التحليليّة سوف تسلِّط الضوء على ما تنطوي عليه هذه الظاهرة من إشكاليّات بنيويّة عميقة تتّصل بمَوقِع الإنسان في مَسار النمط الرّاهن للعَولَمة وعالَم رأس المال، ومُستقبل علاقته بالدولة، وصيرورة تموضعه ضمن توازنات الطبيعة ومُحدّداتها.
بدايةً، ينبغي الإقرار بأنّ فاتورة وباء الكورونا تُعتبَر غير مسبوقة في العصر الحديث. فقد تمخّض هذا الوباء عن مئات ألوف الوفيّات وملايين المُصابين (والحبل على الجرّار) وأَحدث خللاً كبيراً في الأسواق، وأطاح بالأرباح المُتراكِمة منذ سنوات في أسواق المال العالَميّة، وعرَّض كفاءة الحكومات وتخطيطها ونمط قيادتها للشكّ والمُساءلة. وأهمّ ما يُلخِّص تداعيات هذه الجائحة وأخطره هو إجماع المؤسّسات الدوليّة المَعنيَّة، وفي طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على توقُّع ركودٍ اقتصادي يشمل – وإن بمعدّلات مُتفاوِتة من بلد إلى بلد – كلّ أصقاع العالَم، مُتراوِحاً بين 6% و 12% من إجمالي النّاتج المحلّي القائم، تبعاً للفترة التي سوف تستغرقها الدورة الزمنيّة لهذه الأزمة. وتُرجِّح منظّمة العمل الدولي، من جِهتها، أن تتركّز القطاعات الأكثر عرضة لتدعيات الأزمة في مجالاتٍ مُحدَّدة، أهمّها الغذاء والسياحة والترفيه والصناعة والبناء وتجارة الجملة والمفرّق، حيث يعمل أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في العالَم، نصفهم عُمّال وعاملون غير نظاميّين يفتقدون أيّ حماية أو تأمينات اجتماعيّة. وسوف ينطوي هذا المعطى الكلّي الدراماتيكي على ارتفاعٍ غير مسبوق في معدّلات البطالة إلى ما بين 15% و20% من إجمالي القوى العاملة، أي إلى ما بين ضُعفَي وثلاثة أضعاف مُعدّله عشيّة الأزمة، مع ما ينجم عن ذلك من ارتفاعٍ مُوازٍ في معدّلات الفقر. باختصار، إنّه “العزل الكبير” كما وَصفته غيتا غوبيناث (كبيرة خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي)، وسوف تكون مفاعيله الأشدّ عمقاً منذ “الكساد الكبير” في العام 1929، حين انكمش الاقتصاد العالَمي بـنسبة 10% ما بين العام 1929 والعام 1932.
كورونا في إطار الأزمة الاقتصاديّة الأشمل
تداعيات جائحة كورونا ليست مُسقَطة من فراغ، وهي بالتالي لن تحفر آثارها الاقتصاديّة المُستقبليّة على “ورقة بيضاء”، بل هي سوف تُضاف وتَندرج بشكلٍ مُلتبِس ومُعقَّد ضمن واقعٍ اقتصاديّ عالَميّ كان في الأصل مأزوماً، ولاسيّما في حقبة طغيان المُقاربات النيوليبراليّة وتَنامي ظاهرة العَولَمة. فقد ارتدَت هذه المُقاربات صِيَغاً جدّ متنوّعة بعدما أُعيد بعثها في السبعينيّات، بعد نحو نصف قرن على انكفائها، في مُحاولةٍ لضبْط تناقضات النظام الرأسمالي: من التاتشيريّة، إلى الريغانيّة، إلى “اتّفاق واشنطن”، إلى اقتصاد “جانب العرض” (Supply Side Economy)، إلى المدرسة النقديّة والعديد من المَدارِس الأخرى التي سعت كلّها إلى تخفيف القيود عن رأس المال وحفَّزت عمليّاً الترويج لأنماطٍ من “ديكتاتوريّة” السوق المحكوم بالتنافُس غير المضبوط بين الشركات والتكتّلات الاحتكاريّة. ولكنّ انتشار تطبيقات هذه المَدارِس لم يَحُل دون استمرار الأزمات وتجدُّدها، ولَو بأشكالٍ مُختلفة عن سابقاتها، مع تركُّزها أحياناً في بلدٍ واحد وانسحابها أحياناً أخرى على بلدانٍ عدّة في آن معاً. وبحسب جوزيف ستيغليتز – حامل جائزة نوبل للاقتصاد – تجاوزَ عددُ هذه الأزمات المئة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتراكَمت مَفاعيلها العميقة لتُمهِّد السبيل أمام تفجُّر أخطر صيَغها في العام 2008؛ وإذ يطرح عالَم ما بعد كورونا تحدّيات هائلة على صعيد سياسات التحفيز الاقتصادي المطلوبة والدَّعم المُفترَض توفيره لحماية المؤسّسات والعاملين فيها والمُتعطّلين عن العمل، فضلاً عن إعادة صياغة مُجمل أنظمة الحماية الاجتماعيّة، وبخاصّة الصحيّة منها، فإنّ تنفيذ هذه المهمّات سوف يفرض زياداتٍ حادّة في الإنفاق العامّ وفي العجوزات الماليّة للدول، وبالتالي في قيمة الدَّين العامّ العالَمي. ويتوقّع أن يزيد هذا الأخير بفعل جائحة كورونا، بحسب تقديرات دوليّة مُتطابِقة، نحو 13 نقطة مئويّة إضافيّة ليتجاوَز 96% من الناتج المحلّي العالَمي الإجمالي في العام 2020، مع وجوب التذكير بأنّ هذه المشكلة بالذّات (تفاقُم العجوزات والدَّين العامّ) كانت وما تزال تحتلّ صدارة المُشكلات، وخصوصاً في أوروبا المعرَّضة للتفكُّك وفي العديد من البلدان الناشئة، بما فيها البلدان العربيّة غير المُنتِجة للنفط.
التّبعات البعيدة على نمط العَوْلَمة الرّاهن
لقد وَضعَت تداعيات وباء الكورونا النمط الرّاهن للعَولَمة على مشرحة المُساءلة والمُراجَعة في أكثر من مجال، وكَشفت (ولو بعد حين) طبيعة المُحدّدات البنيويّة السلبيّة المُلازِمة للمُقارَبات التي رَعت وما تزال نِظام العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة القائم. وينبغي أن تشمل هذه المُراجَعة العديد من الموضوعات الخلافيّة، ومن ضمنها: الإمعان في تقديس الحريّة المُطلَقة للتجارة والأسواق، على الرّغم من الوعود بعد أزمة عام 2008 بالعودة إلى صيغة ثانية من الكينيزيّة لضمان توازُنٍ أكبر في المُعادَلة النّاظِمة للعلاقة بين دَور الدولة ودَور الأسواق؛ المُراهَنة غير المسؤولة على المضيّ قدماً في ترسيخ “أمْوَلَة” الاقتصاد العالَمي (Financiarisation)، أي تعظيم دَور تدفّقات رؤوس الأموال “الساخنة” فيه على حساب تنمية الاقتصاد الحقيقي والنشاطات الإنتاجيّة الأساسيّة؛ الإصرار على السَّير في تقسيمٍ دوليّ للعمل يقضي بتركيز الحلقات ذات القيمة المُضافة الأعلى من التكنولوجيا والإنتاج الصناعي وإدارة العمليّات في دُول “المَركز” حصراً وبنقْل وتجْزئة وتوزيع، بل تشتيت، غيرها من الحلقات في الدول الناشئة والدول الأطراف في مُحاولةٍ للاستفادة من فارِق كلفة العمل والتحرُّر من عبء الأضرار البيئيّة؛ الاستمرار في إطلاق العنان من دون ضوابط للمُنافَسة الدوليّة المهجوسة أساساً بتعظيم الربح بين الدول والشركات العابرة للجنسيّات، حتّى مع بروز مَعالِم العَودة الجزئيّة مؤخّراً إلى أشكالٍ من الحمائيّة الآحاديّة الفجّة والعشوائيّة؛ يُضاف إلى ما سبق، ما واكب كلّ ذلك من تراجُعٍ في دَور الدولة ووظائفها وفي نُظم تقديماتها الصحيّة وتأميناتها الاجتماعيّة، في وقتٍ كانت آليّات “اليد الخفيّة” تُشجِّع وتُعزِّز التركُّز في الثروة والدخل لدى القلّة القليلة من المُتنفّذين وأصحاب رأس المال الكبير على امتداد العقود الأربعة الأخيرة.
النّظام العالَميّ وارتباك الإدارة الأميركيّة
إنّ ما أَسهَم مؤخّراً في تعميق الجوانب البنيويّة المذكورة أعلاه، هو اتّجاه إدارة الرئيس ترامب نحو إعادة النّظر في العديد من الاتّفاقات والمُعاهدات الدوليّة، لا لتحسينها وتحقيق المزيد من التوازُن في تطبيقها في عالَمٍ مُتغيّر، بل لزيادة إحكام السيطرة الآحاديّة للولايات المتّحدة على النّظام العالَميّ نفسه. واعتَمدت هذه الإدارة على استراتيجيّة مثلّثة الأضلاع تحقيقاً لأهدافها: البدء بإعلان الانسحاب الصريح من هذه الاتّفاقات، تليه من جانب الطرف الأميركي مُمارَسة العقوبات أو التلويح بها ضدّ خصومه، ومن ثمّ الانتقال إلى التفاوُض مُجدّداً إذا ما لاحت فُرص تحسين الشروط لصالحه. ومن الأمثلة الساطعة على هذا النَّهج المُتقلّب، التعديلات التي فرضتها الولايات المتّحدة على مشروع الشراكة عبر المحيط الهادي، وانسحابها من منظّمة اليونسكو ومن مجلس حقوق الإنسان ومن اتّفاق باريس حول المناخ، ثمّ تجميد تمويلها مؤخّراً لمنظّمة الصحّة العالَميّة، وانخراطها المُلتبِس في ملفّ النفط والطّاقة العالَميّة، فضلاً عن لجوئها من جانب واحد إلى استخدام التعرفات الجمركيّة في مُواجَهة أهمّ شُركائها التجاريّين، ولاسيّما الصين وألمانيا وروسيا والعديد من الدول الأخرى. وإذا كان أشدّ ما يُقلق الإدارة الأميركيّة هو تنامي الوزن السياسي والاقتصادي للصين في المُعادلات الدوليّة واتّجاه ناتجها المحلّي نحو تجاوُز النّاتج الأميركي خلال عقْدٍ من الزمن، فإنّ مضيّ الولايات المتّحدة في مُحاوَلة عزْل الصين وتقييد مُبادلاتها ومنْعها من امتلاك المزيد من القدرات التكنولوجيّة وإخضاعها للشروط الصارمة المتعلّقة بحماية الملكيّة الفكريّة، لن يُغيِّر بشكلٍ جذريّ في مجرى التاريخ الذي تولّت الصين بناءه لَبِنة لَبِنة وبشكلٍ تراكُميّ مُستدام منذ إطلاقها الإصلاحات الاقتصاديّة الكبرى في أواسط السبعينيّات، فضلاً عن أنّ الصين أصبحت اليوم لا تستقوي بقوّتها الاقتصاديّة وتقدّمها التكنولوجي وعلاقاتها مع شركائها في مجموعة البريكس فحسب، بل هي باتت تَجِد آذاناً صاغية، وخصوصاً في أوروبا وفي العديد من البلدان المشمولة بمشروعها الطموح المتعلِّق ببناء طريق الحرير، في وقتٍ يعيش فيه الصينيّون فضلاً عن ذلك “حقبة تفجُّر الشعور بفائض الثقة الثقافيّة بالذّات” على حدّ تعبير العديد من الأوساط الأكاديميّة الغربيّة. وإذا ما كانت هذه الوقائع قائمة قبل تفشّي وباء الكورونا، فمن المؤكّد أنّها سوف تتعزّز أكثر بعد هذا الوباء. فالذي خرجَ متفوّقاً – والبعض يقول مُنتصِراً – من أزمة الكورونا، هو المرشّح للاضطلاع بالدَّور الأبرز في رسْم مَعالِم المُستقبل.
ماذا بعد كورونا؟
إنّ ما تمخَّضت عنه أزمة الكورونا من حقائق ومُعطيات سوف يَدفَع في اتّجاه عَولَمةٍ أقلّ مُقارَنةً بنَسَق العَولَمة الحالي المُستمرّ منذ عقود. ويرجَّح أن ينتقل العالَم في القرن الحادي والعشرين، بحسب العديد من مراكز الأبحاث الدوليّة، نحو عَولمةٍ مُتبادَلة أو ثنائيّة – أي أكثر توازناً – على أنقاض النَّسق الآحادي الرّاهن، في ضَوء تسارُع نضوج الظروف الجيوسياسيّة والاقتصاديّة القادرة على فرْض منظومة جديدة للعلاقات الدوليّة، تتشارك في إدارتها الولايات المتّحدة والصين. وهذا ما سوف يستدعي بالضرورة إعادة تحديد وظائف المُنظّمات الدوليّة وأدوارها، التي تخدم في معظمها، راهِناً، مَصالِح الطرف أو الأطراف المتحكِّمة بمنظومة العلاقات الدوليّة القائمة. وقد تكون العَولَمة البديلة أقلّ طموحاً لجهة قدرتها على تحقيق معدّلات نموّ اقتصادي مُرتفعة، ولكن سوف توفِّر في الوقت ذاته قدراً أكبر من الاستقرار في مُواجَهة الصدمات الكبيرة، بما فيها الصدمات المتأتّية عن تزايُد “أَمْوَلة” الاقتصاد وانتشار الأوبئة والتردّي المُفرط للشروط البيئيّة وإساءة استخدام بعض مُخرجات التطوّر التكنولوجي المُتعاظِم. وسوف تضطرّ الحكومات وكذلك الشركات والمُجتمعات إلى تعزيز استعداداتها وقابليّاتها للتكيُّف أكثر مع حِقَب أطول من الانكفاء الاقتصادي النسبي، وربّما العودة المُتدرِّجة إلى سياساتٍ حمائيّة في ظلّ تنامي دَور الدولة الراعية مُجدّداً، حتّى لو بقيَت التساؤلات والهواجس المشروعة تُظلِّل الإطار النظري والجيوسياسي الذي يحكم هذا المفهوم في عالَمنا المُتغيّر. وسوف تنشأ تبعاً لذلك وتتعزَّز الحاجة إلى بلْورة نظرة ثانية أكثر توازناً حيال العديد من القضايا الدوليّة المحوريّة، ومن ضمنها: مسألة التوازُن بين الدولة والسوق ربطاً بتعاقُب النظريّات الاقتصاديّة المُستوحاة من واقع التحدّيات الرّاهنة وتطوّرها، ومسألة كبْح جماح الاحتكارات الدوليّة والشركات المتعدّدة الجنسيّات في إطار نمط العَوْلَمة البديلة وعَودة انبعاث الدولة الوطنيّة، والمَسائل الشائكة المُتعلّقة بقواعد المُنافَسة وبمَسارات التقسيم الدولي للعمل وبالتموضُع الجغرافي لحلقاته الأساسيّة، وكذلك إعادة التفكير في الأنماط الحاليّة لاستخدامات التكنولوجيا المطلوب تحريرها من المصالِح الخاصّة والمُباشرة للمجمّع الصناعي- العسكري وتصحيح علاقتها بمتطلّبات حماية البيئة ومُكافَحة التصحُّر وارتفاع درجات الانبعاث الحراري في الكَوكب. وإلى هذا كلّه، بل ربّما قبله، يجب إحلال موضوع صياغة نُظم جديدة للحماية الصحيّة والاجتماعيّة صدارة الاهتمامات (في ضوء تداعيات جائحة الكورونا)، ولكنْ مع الحرص على تجنّب الإيغال في “أمْنَنَة” securitisation موضوع الصحّة بالذّات وتحويل كلّ ما يتعلّق بصحّة المُواطن (الفرد) إلى حقلٍ يخضع بامتياز لشتّى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبَرامِج الإلكترونيّة الشاملة وتجميع المعلومات (الإفراديّة)، الأمر الذي ينطوي على تدخّلٍ فجّ في الشؤون الشخصيّة للمُواطِن ويُقيِّد الحرّيات الخاصّة والعامّة ويفسح المجال أمام التوظيف السياسي لهذا الموضوع.
مؤسسة الفكر العربي






