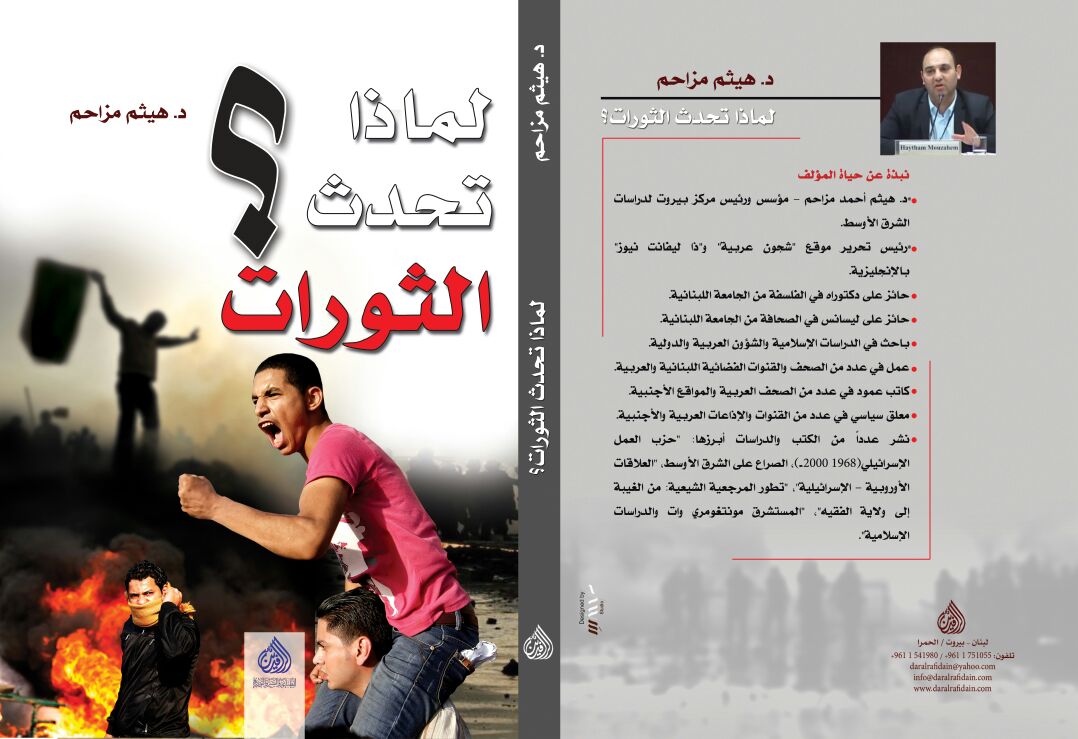الإسلام والآخر

بقلم: د. رضوان السيد* — لاحظتُ في كتابي: مفاهيم الجماعات في الإسلام (1984) أنّ هناك تجاذُباً في القرآن بين اعتبار الفرد بحسب عمله: { فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره}- { وأنْ ليس للإنسان إلاّ ما سعى، وأنّ سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاهُ الجزاءَ الأَوفى}، وبين اعتباره جزءًا من مجموعةٍ لها سمةٌ أو سِماتٌ عامةٌ، فهناك النصارى ويهود وأهل الكتاب والمؤمنون والكفار. وفي هذه الحالة: كيف يتحدد الفرد، هل يتحدد بعمله أم يتحدد بانتمائه الديني . ثم إنّ التعبير ذاتَه عن مجموعةٍ مثل يهود أو بني إسرائيل، هل هو تعبيرٌ مُحايدٌ أم أنه يملك ظلالاً سلبيةً أو إيجابية؟ ثم هل يمكنُ ثالثاً القول إنّ الفرد يتحدد بعمله، أما المجموعة فتتحدد باعتقادها أو دينها؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن مقولة الشعوب والقبائل التي يقسم القرآن البشر إليها: { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتَعارفوا. إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم}. إنّ الواضح هناك أن مفرد شعب أو قبيلة هو مفردٌ مُحايدٌ بالفعل، وهو يشير إلى التنظيم الاجتماعي. ولذلك يختلف المفسِّرون للقرآن في تحديد المعنى والفروق بين الشعوب والقبائل. فيقولون حيناً إنّ الشعوب هم المقيمون أما القبائل فهم البدو الرحَّل، أو أنّ الشعوب هم الفلاّحون، بينما القبائل هم رُعاة الإبل والماشية. لكنْ هناك أخيراً من يقول إنّ الشعوب هم الأعاجم أما القبائل فهم العرب أو الأعراب.
على أنّ هذه الحيادية الظاهرة التي تحدّد الانتماء إلى هذه الفئة او تلك، تعود فتكتسب في القرآن وخارجه صفات وخصائص أخلاقية ودينية. ففي القرآن: { قالت الأعراب آمنّا، قل لم تؤمنوا ولكنْ قولوا أسلمْنا}. أو { الأعرابُ أشدُّ كفراً ونفاقاً}. وفي الحديث النبوي وَصْفُ الأعراب بأنهم جُفاةٌ، ووصف الفلاّحين أو المُزارعين بأنهم راكدون أو أذلاّء وراء أذناب البقر. ثم إنّ هذه السِمات أو الخصائص تتخذ عند ابن خلدون في المقدمة كما نعرف أوصافاً حضارية فيقال إنّ الأعراب أو العرب ما استولَوا على ديارٍ إلاّ أسرع إليها الخراب!
هناك مستوياتٌ متعددةٌ إذن لتحديد الآخر أو الآخَرين إذا صحَّ التعبير. هناك المستوى اللغوي، أو المعروف عند العرب قبل القرآن، والذي تفاعَلَ معه القرآن. وهناك المستوى الاجتماعي، والذي ينفتح ويجري عليه الخلاف في التفصيل بين الحواضر والبوادي أو العجم والعرب. وهناك في كل الحالات المستوى الديني، والذي يتعامل معه القرآن بكثرةٍ، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الفردي، والذي يجري الاحتكام فيه إلى الاعتقاد والعمل، والقسم الفئوي أو الجمعي والذي يقال فيه إنّ هناك ديانات معترفاً بها مثل اليهود والنصارى وأهل الكتاب، وأُخرى غير معترفٍ بها أو أنه تجري إدانتها وهم المشركون أو الكفار.
وإلى هذه المستويات الثلاثة، تبقى هناك تصورات عميقة وموروثة.B. Lewis على سبيل المثال يرى أنّ هناك تصوراً قديماً يشترك فيه اليهود والمسلمون في التفرقة بين الأحرار والعبيد أو أبناء الأحرار وأبناء العبيد: أبناء سارة، وأبناء هاجر، ويتفرع عليه التفرقة بين البياض والسواد. في حين يرى G. Rotter أنّ القرآن والإسلام ضدّ هذا التمييز. فالعرب المؤمنون هم أبناء إسماعيل وأمهم هاجر، ومنهم آخِر الأنبياء محمد وأمته. أما البياض والسواد بحسب Rotter فإنهما لا يلعبان دوراً ملحوظاً، لأنّ عرب الجزيرة شديدو السُمرة، والسُمرة الشديدة دليلٌ على الأصالة والعراقة، يقول الشاعر العربي: أخضر الجلدة من جنس العرب!
II
كيف كان يتمُّ تصنيفُ الناس إذن في العصور الوسطى الإسلامية؟ هنا أيضاً ينبغي التفرقةُ بين زمانين إذا صحَّ التعبير: زمان البدايات وقيام الدولة، وزمان استتباب الثقافة الإسلامية، والنُظُم الإسلامية. من الزمن الأول نجد صحيفة المدينة التي تعتبر المهاجرين من مكة مع النبي إلى يثرب أو المدينة، وأهل المدينة الذين أسلموا على مختلف قبائلهم، واليهود- تعتبر صحيفة المدينة أو دستور المدينة ( بحسب M. Watt) أنهم “أمةٌ واحدةٌ من دون الناس”. والأمة الواحدة هنا ليست موحَّدةً في الدين، ولذا يكون المقصود من الأمة الواحدة، الانتماء إلى كيانٍ سياسيٍّ واحد هو الذي قام في المدينة في زمن النبي بين 623م و632م.
على أنّ تصنيف البدايات هذا يتغير بعد قيام الدولة الإمبراطورية، وظهور نُظُمها القانونية. في هذه الأزمنة الكلاسيكية يظهر تصنيفٌ واضحٌ بالنسبة للدولة، وتصنيفاتٌ أُخرى في المجتمعات والفكر والثقافة. ففي الدولة ظهر نظام أهل الذمة، والذي يشمل بالدرحة الأولى اليهود والمسيحيين. وهؤلاء هناك اعترافٌ بأديانهم من جانب الدولة والمجتمع استناداً إلى القرآن. لكنّ عليهم أيضاً أن يدفعوا الجزية، أو ضريبة الرأس، وهي ضريبةٌ سنوية. ولهم حرياتهم في العبادة والتعليم والحياة الاجتماعية بل والقانونية. فهم لا يتقاضَون إلى القضاء الإسلامي، بل لهم قضاؤهم الخاصّ. وقد سمّي هذا النظام أيام العثمانيين: نظام المِلَل. والنظام هذا في الأصل خليط من تقريرات القرآن، وأحاديث النبي، وتعاملات الدولة معهم في زمنها الأول، ثم ما طوَّره الفقهاء من أحكام عبر القرون من أجل الضبط والتنظيم.
بيد أنّ شعوب الدولة الإسلامية الإمبراطورية ما كانوا يهوداً ونصارى فقط، بل كان منهم الزرادشتيون الذين تسميهم المصادر: المجوس، من أتباع الديانة الفارسية القديمة. وكان منهم البوذيون، والذين تسميهم المصادر السُمَنية أو الشامانيين. وكان منهم الهندوس. والقرآن لا يذكر هذه الديانات. لكنّ الدولة الإسلامية الأُولى (660-750م) روى فقهاؤها قولاً عن النبي بشأن المجوس مفادُهُ: سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب، أي أنه تُركت لهم حرياتهم الدينية والاجتماعية، ودفعوا الجزية أو ضريبة الرؤوس، لكنّ المسلمين لا يأكلون من ذبائحهم ولا يتزوجون نساءَهم. والكُتّاب والجغرافيون يميزون المجوس عن البوذيين، لكنهم يخلطون أحياناً بين البوذيين والهندوس باستثناء البيروني. بيد أنّ الأحكام المتبعة بشأنهم من جانب الدولة، تشبه أحكام المجوس.
الثقافة الإسلامية تجاه الآخر، مختلفة كثيراً عن ثقافة الفقهاء، وقليلاً عن سياسات الدولة. فقد كان لدى الثقافة العالِمة فضولٌ شديدٌ في معرفة اليهود والمسيحيين وفِرَقهم وكتبهم المعاصرة وخلافاتهم ونشأ أدبٌ للجدل سُمّي الرد على النصارى، لا يستند إلى القرآن فقط؛ بل وإلى المنطق والإلزامات بحسب ما هو معروف في جدليات العصور الوسطى. وفيما عدا الجدال وبعض الخصومات مثلما حدث بالأندلس، كان هناك إعجابٌ خفيٌّ لدى الصوفية المسلمين بحياة الرهبان وسلوكهم. بل إنّ ابن تيمية المتشدد يصف نساء المسيحيين بأنهن: “متعفِّفات”. وتظهر هذه النظرات الإيجابية في كتب التاريخ والجغرفيا والأدب. وهناك احترامٌ لدى المتفلسفين المسلمين بالثقافة الكلاسيكية للمسيحيين، والتي قام رجال الدين السريان بترجمتها إلى العربية. و ترقّت التجربة إلى حدود “العيش المشترك” لعدة قرونٍ في الأندلس.
لكنْ، هل زال التمييز أو تضاءل؟ لقد تضاءل في فترات الطمأنينة والازدهار، لكنه لم يَزُلْ بل كان يتصاعد في فترات الحروب مثل الحروب الصليبية. ويذكر الأب Fiey أربع موجاتٍ للاضطهاد ضد المسيحيين في المشرق قبل العصر العثماني. والطريف أنه في ثلاثٍ من تلك الحالات، كانت الهجمات من جانب العامة والغوغاء، وليس من أجهزة الدولة الرسمية. وحوادث الاضطهاد لليهود أقلّ لأنهم بسبب قلة أعدادهم ما كانوا ظاهرين كثيراً في الحياة العامة، ولا يشكِّلون تحدياً. والمعروف أنه في زمن حروب الاسترداد؛ فإنّ المهجَّرين من اليهود آثروا الذهاب مع المسلمين إلى المغرب أوإلى أقطار الدولة العثمانية.
إنّ علينا أن نتصور الأمر بالنسبة للآخر الديني في العصور الوسطى الإسلامية على النحو التالي: هناك اعترافٌ من جانب الدولة بالديانات الرسمية، وليس ديانات أهل الكتاب فقط؛ بل وبالزرادشتية (المجوس)، والبوذية والهندوسية. وكما يقول الماوردي(-1055م) هناك أمانٌ عامٌّ، يُعتبر سياسةً رسمية. وطبعاً هناك إخلالٌ أحياناً من جانب العامة أو بعض المسؤولين بأمن الآخرين الديني والاجتماعي بأعذارٍ مختلفةٍ مثلما فعل محمود الغزنوي بالهند مثلاً. وهذا الأمان أو العقد أو العهد هو الذي كان يلجأ إليه رجال الديانات الأُخرى أيام العباسيين والعثمانيين للطلب من السلطات مراعاة مقتضيات العهد، أو ضبط بعض أتباعهم الذين خرجوا عليهم لسببٍ ما . وهذا يقودنا للدخول في مسألةٍ حسّاسة، وهي الانشقاق الديني أو الهرطقة أو الزندقة، والتي لعبت دوراً في العصور الوسطى الإسلامية، ولعبت دوراً أكبر في العصور الوسطى الأوروبية. هناك اتهاماتٌ كثيرةٌ بالانشقاق والانحراف الديني والكفر بين أتباع الفِرَق الإسلامية منذ القرن الثامن الميلادي. وما كانت السلطات تتدخل لصالح فريق باستثناء مرتين أو ثلاث. في المرة الأولى أيام المأمون طلبت السلطة من علماء الدين أن يقولوا بخلْق القرآن، وتابعها على ذلك الأكثرون، بينما أصرَّت قلةٌ بزعامة أحمد بن حنبل على القول إنّ القرآن هو كلام الله القديم. فجرى اضطهاد القائلين بِقِدم القرآن على مدى أربعة عشر عاماً، بالعزل من المناصب والسجن. ثم أعرضت الدولة عن التدخل. وفي المرة الثانية تدخل وزيرٌ لدى الفقهاء للحكم بالهرطقة على متصوفٍ شارد هو الحسين بن منصور الحلاّج، وجرى صَلْبُهُ، لذلك شبّهه ماسينيون بالمسيح. وفي المرة الثالثة تدخل الخليفة العباسي القادر ببيانٍ أو إعلان يُحدّد العقيدة السنية الصحيحة، وينهى القُضاة وموظفي الدولة عن التشيُّع والاعتزال. ولا ندري إن كانت لذلك الإعلان عواقب على المخالفين.
إنّ الحالة الوحيدة التي ظهر فيها ما يشبه محاكم التفتيش القروسطية، هي حالةُ المانوية. وهؤلاء مختلفٌ فيهم هل هم ديانة مستقلة، أم أنهم انشقاقٌ عن الزرادشتية، أسسها ماني المقتول من جانب الشاهنشاه الفارسي عام 274م. وقد كانت لها جاذبيةٌ بين المثقفين في القرون المسيحية الأولى( كان القديس أوغسطين منهم)، واستمرت هذه الجاذبية في ظلّ الإسلام. فجأةً قرر الخليفة العباسي الثالث المهدي، إنشاء” ديوان الزنادقة” ضد المانوية بالذات، وظلُّوا ملاحَقين لأكثر من قرنٍ، وقُتل منهم عشرات.
III
بدأت الأزمنة الحديثة في ديار المسلمين بإشاراتٍ مختلطة. فمن جهة كثرت المحاولات والمبادرات للتجديد السياسي وتجديد مشروع الدولة، في ظل الشروط الحديثة. ففي العام 1857 أصدر السلطان العثماني مرسوماً سلطانياً (= خط همايون) يقرُّ مبدأ المواطنة بين شعوب الإمبراطورية. وإلى جانب المُضيّ في قانون الولايات للحكم الذاتي (1864)، صدر عام 1876م الدستور العثماني، وانتخُب على أساسٍ منه مجلسٌ للنواب(= مجلس المبعوثان). وكان الوزير الأول التونسي خير الدين باشا قد عمل مع زملاء له على دستور لتونس صدر عام 1864. وفي العام 1867 صدر كتاب خير الدين نفسُه: أقوم المسالك والذي يدعو فيه من أجل استيعاب السيل الأوروبي للأخذ بأنظمة الدولة الحديثة. وقد لقيت هذه المبادرات جميعاً انتكاسات، لكنها كانت قد تحولت إلى تيارٍ زاخرٍ نشأت على أساسٍ منه الحركات الوطنية والاستقلالية في إيران وتركيا ومصر، وبلاد عربية وإسلامية أُخرى.
ومن الجهة الأُخرى، جهة السلبية، كانت الهجمات الاستعمارية تتقدم لاحتلال أجزاء جديدة من العالمين العربي والإسلامي، منطلقةً من فرنسا وبريطانيا وأسبانيا وفيما بعد إيطاليا. ففي عام 1830-31 احتلت فرنسا الجزائر، وانطلقت حركةٌ جهاديةٌ بزعامة عبد القادر الجزائري ضدها. وفي العام 1857، عام صدور قانون المواطنة العثماني، استطاع البريطانيون إخماد تمرد كبير بين مسلمي الهند. إنّ الجديد في المشهدين الجزائري والهندي وفيما بعد المغربي والسوداني والليبي، أنه في كل مرةٍ كانت تحدث فيها هجماتٌ استعماريةٌ؛ تصدُرُ فتاوى تدعو للجهاد، فإن لم يمكن فالهجرة من الديار. لأنّ الدار لم تعُدْ دار إسلام! فأول مرةٍ منذ حروب صقلية والأندلس، يقال إنّ الغزو الأوروبي أحدث حالةً من انعدام الشرعية، يستحيل معها البقاءُ في الديار. وكانت تلك نكسةً كبرى في العلاقة مع الغرب والمدنية الحديثة، تركت آثاراً فاجعةً على الرؤية للآخر الاستعماري والمسيحي. وقد قال الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية علماء الجزائر مرةً إنّ العلاقة بالغرب هي كمن يلحس المبرد. ذلك أنّ الظاهر لذيذ، لكنها كالسم في الدسَم.
لقد عرفنا ردَّةَ فعل أنصار الحداثة المتلائمة مع الغرب الأوروبي، فكيف نحدّد أو نكيّف ردَّة فعل جماعات الهجرة وانعدام الشرعية. الظاهر أنّ هذا الردَّ هو ردٌّ تقليديٌّ عرفته المذاهب الفقهية في زمن انهيار الأندلس. ومعروفةٌ رسالة الونشريسي: أسنى المتاجر فيمن غلب على وطنه النصارى ولم يُهاجِرْ. لكنها تقليديةٌ بدأت تلفظ أنفاسَها، بمعنى أنّ الهنود ما هاجر إلاّ قليلٌ منهم، وكذلك الجزائريون. وقد قال فقيه جزائري حنفي إنّ ترك الديار تكليفٌ بما لا يُطاق. إنما ماذا اختار الذين بقوا بالديار، اختاروا التلاؤم العاجز أو شبه العاجز مثلما فعل سيد أحمد خان بالهند، والأمير عبد القادرالجزائري بعد هزيمته عام 1847. وإذا كان الجهاد والهجرة كلاهما قد تُركا؛ فإنّ الذي خَلَفَهما ليس الحركة الإصلاحية التي كانت توردُ تعليلاتٍ دينيةً لتبرير الانضواء في الحداثة. بل الذي فاز في المدى المتطاول فريقان: فريق الانفصال، وفريق المفاصلة. أمّا الانفصال فتجلَّى في الباكستان، وفي مفارقة فقه العيش المشترك القديم بداخل بلدان الإسلام. وأما المفاصلة وهي القتال المستمر فقد تجلّى في السودان وليبيا ثم الجزائر. والطريف أنه في مصر في الستينات من القرن الماضي ظهرت مجموعة سمت نفسَها: جماعة الانفصال الشعوري. والانفصال في هذه المرة ما كان عن الخارج الاستعماري فقط بل وعن الداخل السياسي والاجتماعي باعتباره صار متغرباً، وسقط ضحية الغزو.
لقد اعتبر خبراء كثيرون أنّ فشل التقليد الفقهي والعقدي الإسلامي في مواجهة الاستعمار، دفع باتجاه أحد خيارين: الحركات الوطنية والإصلاحية، أو العمل عند المستعمرين. وهذا صحيحٌ، لكنْ بقيت هناك نافذة أُخرى كانت ضيقةً ثم اتسعت لتيار الإحيائيات أو الصحوات الناجمة عن الحداثة والمعادية لها كما هو معروف، وهو ما صار يُسمَّى حركات الهوية الدينية والقومية.
ولا يجوز هنا نسيان الحركات الوطنية والإصلاحية، والتي كانت ضد التقليد، وتريد انتزاع الاستقلال من المستعمرين بالوسائل السلمية أو القتالية. وقد كانت تلك الحركات أقوى ما تكون في مصر، وهي التي اشترعت دستور العام 1923، وقد ظهرت مثائل لها في سائر أنحاء العالم الإسلامي. وقد وفّقت هذه الحركات في بقاعٍ بآسيا وإفريقيا، لكنها ما كانت محظوظةً في العالم العربي، لأنها انهزمت في فلسطين، ثم انهزمت في الستينات عدة مرات. وخلال ذلك تحولت إلى أنظمةٍ أمنيةٍ وعسكرية استبدادية، وفقدت شعبيتها، كما فقدت غطاءها الشرعي لأنّ الفقهاء الإصلاحيين بالمشرق والمغرب غادروها، وحاصرها الإسلاميون بالشارع ثم بالتمردات المسلَّحة.
مرت رؤية الآخر أو رؤية العالم في القرن العشرين إذن بمرحلتين: مرحلة تراجع التقليد وتقدم الإصلاحيات والإحيائيات، ومرحلة الهبوط السريع للدولة الوطنية، وبدء التأزم في رؤية العالم. ولنأت إلى الحرب الباردة العالمية، والحرب الباردة الثقافية. في الحرب الباردة الأولى أو الكبرى اصطف العرب والمسلمون على الجانبين، فريق مع الولايات المتحدة، وفريق مع الاتحاد السوفياتي. وقد استخدم الطرفان الحرب الثقافية. استخدم الأميركيون وحلفاؤهم العربُ والمسلمون إسلاميي الصحوات ضد الشيوعية وأنصارها. واستخدم الروس وحلفاؤهم المثقفين اليساريين ضد الرأسمالية والإمبريالية والثقافة الغربية الاستعمارية. وكانت النتيجة أنّ الثقافة الغربية الليبرالية والمنفتحة تضررت من الطرفين: من الإسلاميين الحريصين على الهوية، ومن اليساريين الحريصين على التحرر من الاستعمار وثقافاته. وعندما شاهد الشيخ يوسف القرضاوي الطرفين يتنافسان في شتم الثقافة الغربية، قال مثلما قال القذافي فيما بعد: لنمض باتجاه الطريق الثالث، طريق الثورة الإسلامية فالدولة الإسلامية على النحو الذي شرحه المودودي وقطب. وهذا أصل مقولة: حتمية الحل الإسلامي! وعلى أنقاض الدولة الوطنية ذات الثقافة الغربية قامت الدولة الإسلامية الإيرانية، والتي ما يزال الإسلاميون المناضلون السنة يسعَون لمثلها. وقد انقسموا في ذلك إلى قسمين: إسلام سياسي، يريد الوصول للدولة بالسلم والانتخابات، وآخَر جهادي، وهو يريد إقامة الدولة بالجهاد والقوة. وقد بدأ بن لادن بالعدو البعيد، أما البغدادي فأقام دولته على أرض العدو القريب.
********
في التقليد الإسلامي رؤيةٌ للعيش وترتيباته، ورؤيةٌ للدين وملاءماته مع فقه العيش. وقد حطّم الاستعمار والحداثة العيش التقليدي وترتيباته. فحاول الإصلاحيون أن ينتجوا فقهاً جديداً أو فهماً جديداً للدين يتلاءم مع ترتيبات العيش الجديد. وما استطاعوا ذلك، لأنّ الحداثة ماضيةٌ كالسهم، ولأنّ الدولة الوطنية فشلت، ولأنّ الأميركيين وحلفاءهم استخدموا الإسلام السياسي والثقافي والآخر الجهادي في حربهم على الاتحاد السوفياتي؛ فجعلوا له قضيةً وهدفاً. ولقد اضطربت رؤية العالم في الإسلام المعاصر تحت وطأة هذه الصدمات. ومع اضطراب الرؤية اضطرب مشهد الآخَر ناظراً ومنظوراً إليه. فعالم المسلم اليوم مكوَّن من شظايا وبقايا التقليد القديم، مضموماً إليها فذلكات الجماعة الإسلامية المودودية والإخوان، ومضموماً إليها القراءة الخاصة للقرآن، والهُيام بإقامة دولة دينية ضد كل الآخرين- وإلى ذلك كله أشواق عارمة لدى العامة للسكينة الدينية والأخلاقية.
فهل يكون عنوان هذه المداخلة، أي الإسلام والآخر، مبالَغاً فيه أو شديد العمومية؟ قد لا يكون كذلك، إنما الأصح فيه: المسلمون والآخرون؛ باعتبار أنه ينبغي أن يحضر الجميع وإنْ بدرجاتٍ متفاوتة، وكثيرٌ من المسلمين يعتقدون أنهم بمجموعهم غير حاضرين على الإطلاق، وقد يكون ذلك بين أسباب العنف المنتشر في أوساطهم وفي العالم.
——————–
*مفكر وأستاذ جامعي لبناني مختص بالفكر العربي والإسلاميات.
(**) محاضرة أُلقيت بكلية اللغات والترجمة في جامعة إشبيلية بتاريخ 6/5/2016.