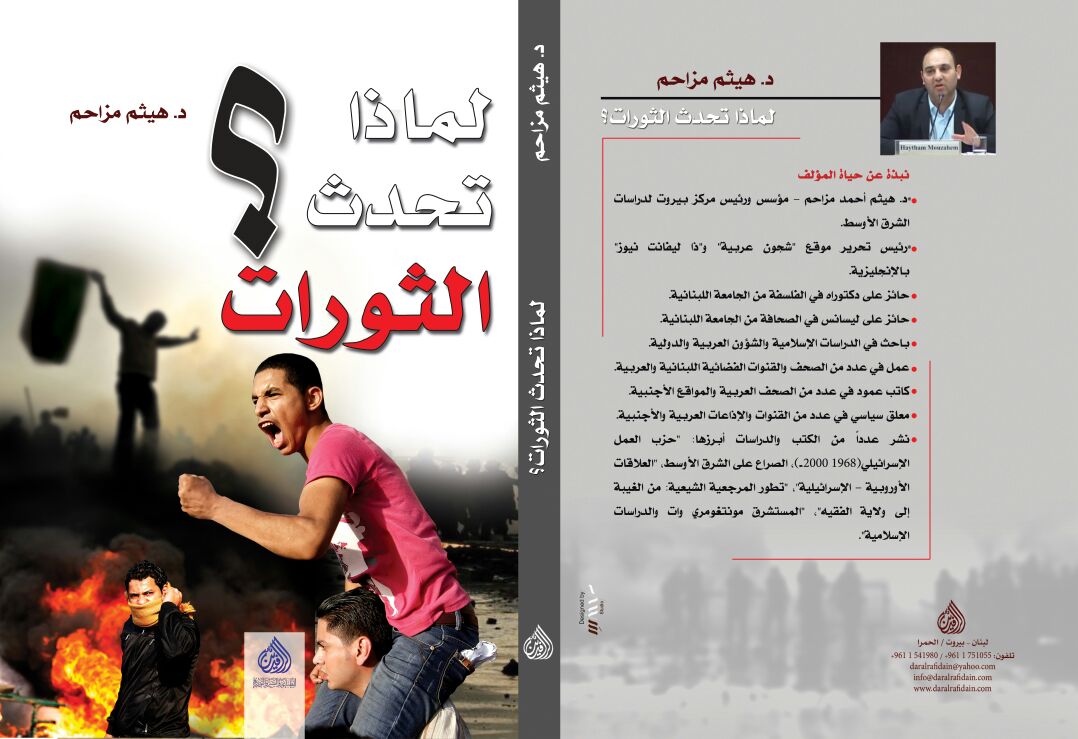تونس :الرئيس الجديد بلا مشروع وطني

توفيق المديني/
يتوجه يوم الأحد 15سبتمبر/ أيلول الجاري، حوالي 7 ملايين و155 ألفاً من الناخبين التونسيين المسجلين،(أي بزيادة بلغت مليوناً و490 ألفاً على العدد المسجّل في آخرانتخابات شهدتها البلاد في مايو2018)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية ،حيث يتنافس على هذا المنصب 26مترشحًا، وتشرف على هذه الانتخابات الرئاسية هيئة مستقلة منتخبة من قبل البرلمان.
ومن الصعب جدًّا أن يتم فوزأحد المترشحين في الانتخابات الرئاسيةهذه من الدورة الأولى نظرًا لشدةالمنافسة وتشتيت الأصوات (وعندما نتحدث عن الانتخابات الرئاسية في العالم العربي فإننا عادة ما نعرف من سيفوز، وبنسبة 99%..)، أما اليوم في تونس فلا نعلم من سيفوز، لهذا لا بد من المرور إلى الدورة الثانية، التي ستنتظم بعد أن تجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/شهر تشرين الأول2019 ، لتتم العودة إلى الدورة الثانية ونعرف الرئيس المقبل لتونس.
المتابع للحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 2سبتمبر/ أيلول الجاري، يمكن اعتبار تعدد الترشيحات ،والمبارزات الفكرية و السياسية بين المترشحين التي تثيرها هذه الانتخابات في المناظرات التلفزية الثلاث التي شهدها المواطنون التونسيون على القنوات التلفزية بمنزلة دليل على حيوية الديمقراطية الناشئة في الدولة العربية الوحيدة التي لم يؤد فيها ربيع 2011 إلى حرب أهلية ولا إلى إعادة إرساء الديكتاتورية، حيث باتت هذه الديمقراطية الفتية تُشَكِّلُ لحظة إفلات حقيقي من عقال أدوات الضبط والتحكّم السياسي التقليدية التي اعتادت توجيه الناخب وتوظيفه في غير هدى استحقاقاته المشروعة.
وفيما استحكم الصراع على هوية المجتمع في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية خريف 2014، وتمكن الرئيس الباجي قائد السبسي من الفوزبها في مواجهته لخصمه منصف المرزوقي المدعوم من حركة النهضة ، فإنّ الصراع الهوياتي قدتم تجاوزه مؤقتا في هذه الانتخابات الرئاسية التي سيطرت فيها عناوين جديدة تتعلق بالأمن القومي والحفاظ على استقرار البلاد، والدبلوماسية والسياسة الخارجية التي تعد من صميم صلاحيات الرئيس الدستورية ومعالجة التفاوت الطبقي و الجهوي، وسوء الإدارة واستشراء الفساد وسيطرة الأقلية الأوليغارشية على الثروة.ولكن هذا الصراع الهوياتي يمكن أن يعود بقوة في الدورة الثانية ،فيما لووصل مرشح حركة النهضة الشيخ عبد الفتاح مورو إلى الدور الثاني في مواجهة منافس ينتمي إلى المنظومة القديمة.
يجمع المحللون السياسيون في تونس من خلال متابعتهم للحملة الانتخابية التي اشتدت وطأتها بين المتنافسين في الأسبوع الثاني ،أنَّ الصراع القائم بين المتنافسين في هذه الانتخابات ظل قائمًا على الشخصيات أكثر منها حول البرامج والقدرات السياسية والفكرية للمرشحين، وتركزأساسًا على صلاحيات غير مشمولة ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى درجة أنّ التنافس حول البرامج جعل البعض يتحدث عن برامج واهية وعن تطوير نسب النمو وتقليص راتب رئيس الجمهورية، بعيداً عن السياسة الخارجية والأمن الداخلي والخارجي لتونس والمبادرة التشريعية والأزمة السياسية في البلاد، فضلاً عن تقريب وجهات النظر وبلورة برنامج مستقبلي لتونس يمكّن الشعب من اختيار الأفضل ويكون مبنياً على أسس سليمة.
الرئيس المقبل أمام أزمة النظام السياسي التونسي
ينتسب عدد كبير من المترشحين في الانتخابات الرئاسية إلى العائلة الوسطية الحداثية التي هزمت حركة النهضة في انتخابات 2014، حين كان حزب “نداء تونس ” هوممثلها السياسي بزعامة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، (ونجد اليوم ستة سياسيين منحدرين من هذه العائلة الوسطية من بين المرشحين للرئاسة:عبد الكريم الزبيدي،يوسف الشاهد، مهدي جمعة، محسن مرزوق، وناجي جلول ،ونبيل القروي الذي يوصف بأنه برلسكوني تونس، نظرا لملكيته قناة نسمة التلفزيونية، والذي اعتقل عشية الحملات الانتخابية بسبب التهرب الضريبي والفساد، وهي اتهامات ينفيها،والمرشحة عبير موسى، الداعمة لابن علي وتبني برنامجها على الحنين لعهد الرئيس السابق الذي ينمو في بعض الدوائر عبير موسى ).
أما العائلة الإسلامية التي تظل حركة النهضة أهم تشكيلها السياسي المنظم،فهي مهددة بالتشتت في الأصوات والانقسام ، لا سيما بعد أن عينت مرشحها عبد الفتاح مورو، و بعد أن قرر رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي هو الآخر المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية ، تماما مثل الرئيس السابق للمرحلة الانتقالية منصف مرزوقي، الذي كان في سنة 2014 مرشح الإسلاميين غير المعلن.
وفي العائلة اليسارية نجد نفس الانقسام إذ ترشح ثلاثة قياديين هم:حمه الهمامي، منجي الرحوي،ووعبيد البريكي.
ويؤكد المترشحون في برامجهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية انتماءهم الى هذا الإرث العائلي الذي كان له التأثير الأكبر في تاريخ تونس السياسي المعاصر.
المتابعون من الخبراء و المحللين السياسيون و الإعلاميين للعروض الانتخابية في الحملات الانتخابية التي يقدمها المترشحون سواء من المنتمين لهذه العائلات الإيديولوجية الثلاث ، أو من خارجها، يلمس بوضوح ، أنّ هناك بونًا شاسعًا بين الوعود وما يمكن إنجازه ، خصوصًا وأنَّ هناك العديد من الوعود الشعبوية التي أطلقها العديد من المترشحين لا تتلائم البتَّة َ مع مهام صلاحيات رئيس الجمهورية .
وقد احتدم الجدل في هذه النقطة حول صلاحيات رئيس الجمهورية ، بين الذين يَتَقَيَّدُونَ بالطابع القانوني الصرف الذي يرتكز على هذا الفصل أو ذاك من الدستور، وبين الذين يُرَكِّزُونَ على الجانب السياسي الذي يمثل طابعًا جوهريًا في الإنتخابات الرئاسية،مؤكدين أنَّ دور الرئيس وصلاحياته في النظام السياسي التونسي شبه البرلماني وشبه الرئاسي لا ترتبط فقط بالفصول الواردة في الدستور. بل ترتبط أساسًا بميزان القوى بين الكتل البرلمانية المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية.
الرئيس المنتخب في تونس ، لا سيما إذا كان من العائلة الوسطية، سيتعزز وضعه إذا فاز حزبه في الانتخابات التشريعية، ذلك أنَّ العامل الأساسي الذي يحدد صلاحيات الرئيس هو فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية و ليس فقط صلاحياته المتضمنة في هذا الفصل أو ذاك من الدستور. فعندما يفوز الرئيس بالأغلبية البرلمانية يصبح زعيمًا للأغلبية البرلمانية و بالتالي فهو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية و يصبح رئيس الحكومة الذي يعينه مسؤولاً أمامه.
سيصطدم الرئيس المنتخب الجديد بطبيعة النظام السياسي التونسي ،الذي تأسس في ضوء دستور 2014 بوصفه نِظَامًا شاذًا وهَجِينًا، لأنَّ الفكر السياسي الذي تبنته الأحزاب التي فازت في الانتخابات، سواء في سنة 2011، أو في سنة 2014، الإسلامية التي ارتبطت بالهوية، أو العلمانية التي نادت بالمساواة في الميراث، كان فِكْرًا تَقْلِيدِيًا، وغير متطابق مع انتظارات الثورة. فبفوز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية، وفوززعيمه الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية، استطاع الأخيرأن ينجح في استمالة كوادر النظام السابق لحزبه، ويواصل تمثيل مصالح برجوازيّة “بلدية العاصمة وعصبية الساحل”، والاحتفاظ بدعم القاعدة الاجتماعية التقليديّة للحزب الحاكم منذ الاستقلال. وعرف قائد السبسي كيف يستثمر الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها حركة النهضة، لا سيما ضعف الكفاءة في إدارة الحكم، والعجز عن تقديم أجوبة شافية على المطالب الاقتصادية – الاجتماعية، وانتظارات الشعب التونسي من الثورة.
كانت طموحات الشعب التونسي تتمثل في بناء نظام سياسي ديمقراطي، يقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بوصفه مِعْيَارًا كَوْنِيًا في تصنيف النظم الديمقراطية من غيرها، وهو ما يتطلب من الأحزاب التونسية التي تنطحت لعملية البناء أن تكون حاملة لمشروع فكري وثقافي وطني وديمقراطي، وهوما افتقدته كُلِّيًا الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، أو الأحزاب العلمانية التي تبنت المرجعية البورقيبية، المرتهنة للمافيات الداخلية، و،المرتهنة أيضا لهيمنة الدول الأوروبيّة والأمريكية والخليجية والتركية و الصهيونية،التي باتت تتحكم في القرار الوطني السيادي التونسي، وتحاصر المسار الديمقراطي التونسي ، لمنع انتشاره في باقي الدول العربية.ولهذا السبب عجزت الطبقة السياسية الحاكمة بأحزابها المختلفة عن بناء نظام ديمقراطي جديد، وإعادة بناء الدولة الوطنية.
فالنظام السياسي الذي أسسه، السبسي والغنوشي، وكرّسه دستور 2014، شاذ وهجين، حيث تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين طرفين، رئيسي الجمهورية والحكومة، مع صلاحيات أوسع للثاني، وهو المتسبب الرئيس في الأزمة التي تعيشها تونس في الوقت الحاضر، فهو ليس نظامًا برلمانيًا قائمًا على الفصل بين السلطات، كما في الأنظمة البرلمانية التي تقوم على الفصل المرن بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، ولا نظامًا رئاسيًا، مثل الأنظمة الرئاسية التي تعرّف بأنها تقوم على الفصل الصارم بين السلطتين. وعلى الرغم من أنّ دستور 2014 يحدّد مركز الثقل السلطة التنفيذية في البرلمان والحكومة، فإنّنا نجد أن مركز الثقل الحقيقي داخل السلطة التنفيذية في الفترة الممتدة من نهاية سنة 2014 ولغاية استلام يوسف الشاهد رئاسة الحكومة في صيف 2016،ليس في الحكومة، ولكن في قصر الرئاسة في قرطاج.
وذهب الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري قيس سعيد ،والمترشح إلى الانتخابات الرئاسية،إلى أبعد من ذلك وبيّن أن تونس تعيش في ظل نظامين اثنين أحدهما ظاهر وهو الذي يَنُصُّ عليه الدستور وآخر خَفِيٌ وهو الذي بيده كل مقاليد السلطة.. فالظاهر لا يتحرك إلا في الحدود التي يرسمها له النظام الخفي، فَإِنْ تجاوز بعض الحدود أو بعض الخطوط دَفَعَ الثمن، واستشهد محدثنا بما حصل لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.
لم يتخلص بعد ساسة تونسيون كثيرون يقودون هذا النظام ويسيرونه من الفكر السياسي القديم،بينما تعيش تونس على إيقاع القطيعة التامة بين الفكر السياسي السائد لدى عموم التونسيين والفكر السياسي الذي يتبناه في السرّوالعلن عدد غير قليل من السياسيين، في الحكم والمعارضة. ويتحمل الرئيس الباجي السبسي مسؤولية تاريخية في إعادة إنتاج النظام السابق على مقاس الطبقة السياسية الحاكمة، وبما يخدم دولة الظل العميقة القديمة -الجديدة التي تدير هذا النظام الظاهر والحكومة من وراء الستار، حين أفسح في المجال لعودة وجوه من حزب التجمع الدستوري (حزب بن علي) القديمة التي تقلدت مناصب حكومية وحزبية وبرلمانية، بناء علی رغبة الباجي السبسي نفسه، النابعة من الخوف من إضعاف الدولة، بعد الهزات المرتدة من الثورة، كما أنّها أيضًا ناتجة عن تحول حزب نداء تونس إلی حزب تجمعي صريح، وهو المسيطر علی الائتلاف الحكومي مع حركة النهضة الاسلامية، على الرغم من أنّ الهدف التأسيسي لهذا الحزب في سنة 2012 كان إزاحة الإسلاميين من الحكم، والدفاع عن النمط المجتمعي والإرث البورقيبي، بتحالف بين الحداثيين والعلمانيين عبر أربعة روافد يسارية ودستورية ونقابية ومستقلين. فقد خدم هذا النظام السياسي الشاذ و الهجين مصلحة حركة النهضة، باعتبارها هي من أوجدته على مقاسها للإستمرار في الحكم.
فلقد أظهرت التجارب في الديمقراطيات الكلاسيكية الغربية، مثل فرنسا ،أنَّهُ عندما تسبق الإنتخابات الرئاسية بقليل الإنتخابات البرلمانية فإنَّ الثقة التي يمنحها الناخبون لرئيس الجمهورية يُجَدِّدُونَهَا في الإنتخابات البرلمانية لِيُعْطُوا الرئيس أغلبية برلمانية مريحة تُمَكِّنُهُ من الحكم لمدة ولايته.فإذا تحققت هذه الفرضية في الواقع التونسي، فإنّ الرئيس المنتخب مطالب بتقديم مشروعه السياسي لإعادة بناء النظام السياسي الرئاسي بصورة ديمقراطية ومعدلة، تَحُولُ دُونَ العودة إلى النظام الرئاسي القديم كما كان سائدًا في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
الرئيس المقبل والحاجة إلى إعادة بناء الدولة الوطنية
يُرَجِّحُ العديد من المحللين السياسيين ومتابعي الشأن السياسي العام في تونس ، أنْ يَمُرَّ مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو إلى الدور الثاني ، لكنَّ رؤية أي رئيس قادم من عائلة الإسلام السياسي إلى قصر قرطاج، تصطدم بمقولة إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية.فحركة النهضة المنتمية إلى الإسلام السياسي تعيش حالة انفصام في هويتها بين الجانب الدعوي وحلم بناء الدولة الإسلامية بالتدرج من خلال تطبيق استراتيجية “التمكين” و السيطرة على مفاصل الدولة ،وبين القبول بالتمشي السياسي والذي يقتضي الانخراط في النظام السياسي وقبول اللعبة الديمقراطية .وقد ظهرت بعض المؤشرات التي تؤكد بالرغم من محافظة حركة النهضة على وحدتها، دخول الحركة ومختلف حركات الاسلام هذا المخاض وهذه الولادة العسيرة.
بالرغم من محافظة حركة النهضة على وحدتها مقارنة بالعائلات السياسية الأخرى وبصفة خاصة العائلة الوسطية الحداثية والعائلة اليسارية، فإنَّها تعيش كأغلب الحركات السياسية في المشهد السياسي مخاضًا عسيرًا وأزمة هوية ستكون محددة ومؤثرة في مستقبلها السياسي .وهذه الأزمة والمخاض تخص قدرتها على الخروج والقطع مع النهج الإخواني الداعي إلى بناء الدولة الإسلامية من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية، والانخراط في النظام الديمقراطي من خلال التحول إلى حركة سياسية مدنية محافظة وتؤمن بقيم الجمهورية العلمانية.
وفضلاً عن ذلك، فقد عرفت حركة النهضة تراجعًا هامًا في نتائجها الانتخابية منذ المحطة الانتخابية الأولى في سنة 2011 (مليون و450 ألفًا)،مرورًا بالمحطة الثانية في سنة 2014(950 ألفًا)، ولغاية محطة الانتخابيات البلدية في سنة 2018 (450ألفا)، ولهذا من الصعب جدّا أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية التونسية من حركة النهضة، لا سيما أنَّ الحركة لا تزال تلاحقها ملفات شائكة وخطيرة، مثل ملف اغتيال القائدين اليساريين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على يد متطرفين إسلاميين، وملف الجهاز السرِّي ،ما زاد حالة الاستقطاب بين القوى العلمانية والإسلامية في البلاد.
أما الرئيس المنتخب من العائلة الوسطية الحداثية، الذي تُرَجِّحُهُ استطلاعات الرأي للمرور إلى الدور الثاني في هذه الانتخابات الرئاسية : وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، أو رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أو المرشح القابع في سجن المورناقية نبيل القروي ،فإنّه يعاني بدوره من أزمة المشروع الوسطي الحداثي وتراجع وانحسار هيمنته على المجال السياسي.
فهذا المشروع الحداثي الذي أسسه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وسار على نهجه كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والرئيس الراحل الباجي قائدالسبسي، يعيش أزمة هوية على الصعيدين الفكري و السياسي.فقد وصل هذا المشروع الحداثي والوسطي إلى مأزقه المحتوم من جراء عدم قدرته على تجسيد القطيعة مع أنموذج التنمية السابق القائم على التبعية لبلدن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية،وخضوعه الكامل لشروط المؤسسات الدولية المانحة، لا سيما صندوق النقد الدولي، الذي تعهدت الحكومات التونسية المتعاقبة بعد سنة 2011، بتنفيذ برنامجه المتعلق بالإصلاحات الهيكلية .
فقد عجزت أغلب الحكومات منذ بداية الألفية عن بناء أنموذج تنموي جديد ووضع حدٍّ لآفة البطالة وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .ولا وجود في الوقت الحالي لأي شخصية توافقية قادرة على فرض نفسها من هذه العائلة الوسطية الحداثية، فبالإضافة إلى الاشتباكات الانتخابية، هناك عامل مشترك يجمع بين المرشحين يتمحور حول عجزهم المحتمل عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه البلاد.
فالأحزاب السياسية المنتمية لهذا المشروع الحداثي والوسطي ،ولا تزال المرجعية البورقيبة تشكل أساسها الإيديولوجي ،أصبحت عاجزة في زمن القرن الحادي و العشرين عن إعادة بناء الدولة الوطنية ، وهي تعيش أزمة تشتت و انقسام ، فضلاً عن ظهور مشروع سياسي منافس لها، وهو مشروع الإسلام السياسي ،الذي نجح في حشد القوى التقليدية والفئات المهمشة حول مشروع رفض ونقد المشروع السياسي الحداثي الوسطي .وما أسهم في بقاء هذه العائلة السياسية الوسطية و الحداثية ،وفي فوزها في انتخابات 2014، هوالصراع الذي خاضته ضد خطر تيار الإسلام السياسي الذي يستهدف تغيير نموذج المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والعلماني.
ورغم أنّ الانتقال الديمقراطي المتعثرالذي عرفته تونس يُعَّدُ ناجحًا نسبيًا،فإنّ أغلب المحاولات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة المنبثقة عن الانتخابات الديمقراطية التي جرت في سنتي 2011، و2014، من أجل إصلاح الدولة التونسية، تحت مسمى إعادة بناء الدولة، باءت بالفشل، لأنّها جميعها كانت خاضعة لاستراتيجية الدول الغربية (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي)، ولشروط وإملاءات المؤسسات الدولية المانحة(صندوق النقد والبنك الدوليين)، ولم تكن نابعة من استراتيجية وطنية في إعادة بناء الدولة.
ومن يتابع الصراع الدائر في تونس منذ ثماني سنوات، يلمس بوضوح أنّ الصراع ليس على برامج سياسية بين حركة (النهضة) وبقية الأحزاب الديمقراطية المؤمنة ببناء دولة ديمقراطية تعددية، بل هو في حقيقة الأمر صراع على المشروع المجتمعي لتونس خلال المرحلة المقبلة، والذي لم يحسم بعد، فلا يمكن أن تتعايش مرجعية فكرية وسياسية ديمقراطية تؤسس لدولة القانون، ولدولة مدنية تعددية، تقوم على مبدأ سيادة الشعب، وعلوية القانون، والإرادة الشعبية، مع مرجعية حركة “النهضة” التي لا تزال ترفض تجسيد القطيعة الإيبستيمولوجية مع حركة (الإخوان المسلمين)، التي تؤسس موضوعيًا لدولة دينية تقوم بالتدرج.
ورغم أنّ المسار الثوري ما بعد 2011،أَسْهَمَ في تأسيس لثقافة جديدة قائمة على الاختلاف والتنوع وتعدد الأفكار والبرامج ،فَإِنَّهُ مع ذلك، تُوَاجِهُ الديمقراطية الناشئة في تونس صعوبات حقيقية في التَحَوُّلِ من مجرّد عمليّة انتخابيّة إلى ثقافة تُرَسِّخُ قيم المواطنة، والدولة المدنية.
إضافة إلى كل ذلك، فإنّ الطبقة السياسية الحاكمة لم تفهم معنى الديموقراطية ولا حتى الوطنية، ونظرًا لتورطها في الفساد، وعلاقتها بالمافيات الداخلية والخارجية ،فقد انتفى عنها أي شعور بالفهم الحقيقي للحرّية، ولكنَّ أيضًا أيَّ شعورٍ بالتوازنِ الوطنِي. من هنا يمكن الاعتقاد أنّ الأحزاب السياسية الحاكمة من اليمين الديني (الإسلام السياسي) واليمين العلماني (حزب نداء تونس وتشقاقته، والأحزاب الليبرالية الأخرى) ليست جديرة بالديموقراطية، وأنّ هذه النخبة السياسية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في إدارة الدولة. وما نراه من اضطرابات في البلاد ناشئ عن ترسيخ الديموقراطية في الدولة، ولكنَّ في المقابل، فإنّ هذه الدولة غير قادرة على إنهاء الاضطرابات. الديموقراطية الناشئة في تونس ولو أنها ترسخت سياسيًا، يصعب تقبلها من طرف الطبقة السياسية الحاكمة ومن طرف رجال الأعمال الفاسدين،وأصحاب المصالح،والمافيات.
خاتمة:
ولذلك، فإنَّ الرئيس الفائز في الانتخابات التونسية ، سواء أكان من العائلة الوسطية الحداثية ، اومن عائلة الإسلام السياسي، لا يمتلك مشروعًا وطنيًا ديمقراطيًا لإعادة بناء الدولة التونسية وفق مستلزمات العصر، وانتظارات الشعب التونسي،لكي تلعب تونس دورًا إقليميًا رائدًا يكون تأسيسيًا على الصعيد العربي، من خلال إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي فيها والمرور إلى الفضاء المُحَرَّم ِ دَوْلِيًّا على الدول العربيّة: فضاء الديمقراطيّة والتداول السلمي على السلطة، كخطوة أولى على درب التحرير الشامل للمنطقة العربيّة.
فهذا الرئيس المنتخب سيظل مُمَثِلاً لمصالح البرجوازية التونسية التي ارتبطت تاريخيًا بالاستراتيجية الشاملة للإمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي، وفق معادلات الجغرافية السياسية الخاصة بكل بلد عربي ، لأنَّها لاتعتبر أن برنامج الثورة الديمقراطية في تعارضاته مع مصالح الدول الإمبريالية الغربية، والكيان الصهيوني ،والمؤسسات الدولية المانحة ،هو برنامجها.
ففي مجال السياسة الخارجية،سيظل الرئيس المنتخب يسير في ركاب الدولة القطرية التونسية التي بناها الزعيم الحبيب بورقيبة، والمحكومة لقانون التجزئة والتبعية للغرب ، والمتجاوبة مع التقسيم الإمبريالي للعمل كما أقرته اتفاقية سايكس بيكو، بين الإمبرياليات المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، حيث شكلت اتفاقية سايكس بيكو هذه ولا تزال الأساس الموضوعي الاجتماعي – الاقتصادي – السياسي للمأزق العربي الراهن، مأزق غياب الشروط المادية لدولة السوق القومية البرجوازية المدنية المعاصرة.
وقد عمق هذا المأزق العربي وواكبه تأسيس الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية، ودخوله على خط تقسيم العمل الدولي الإمبريالي في المنطقة، ودوره كركيزة للإمبريالية المنتصرة ألا وهي الولايات المتحدة الأميركية. فالمشروع الصهيوني هو ثنائي التجزئة داخل معادلة التبعية والتأخر، وتحويل العرب إلـى كيانية وجغرافية لا حول لها ولا قوة داخل تاريخ العولمة الرأسمالية مباشرة، أو في البعد الإقليمي الصهيوني لهذا التاريخ. والمشروع الصهيوني فوق كل ذلك شكل ولا يزال الأساس الموضوعي الثاني للمأزق العربي الراهن.
لهذا كلّه،لنْ يَجْرُؤَ الرئيس التونسي المنتخب على بلورة استارتيجية جديدة للأمن القومي تكون متصادمة مع استراتيجية الهيمنة الإمبريالية الغربية و الصهيونية ،أو يبلورسياسة خارجية تحافظ على السيادةالوطنية للدولة التونسية، وتدافع عن القضايا العربية العادلة ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتفك ارتباط تونس بسياسة المحاور الإقليمية والدولية، بما يجعل السياسة الخارجية التونسية مستقلة، وقادرة على إقامة شراكة مغاربية حقيقية بين البلدان المغاربية الخمسة لتشكيل قطب إقليمي مغاربي يتفاوض مع الاتحادالأوروبي من موقع النديّة ، لإقامة شراكة أورو-متوسطية متكافئة وعادلة تحمي الفلاحة التونسية خاصة ،والفلاحة المغاربية عامة، وإقامة أيضًا شراكات اقتصادية مماثلة مع القوى الإقليمية الناشئة والصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا ، ودول جنوب شرق آسيا، و كذلك مع القوى الدولية الكبيرة كالصين وروسيا ، التي تناضل من أجل إقامة نظام دولي جديد متعددالأقطاب ، يدافع عن مصالح دول الجنوب.
مجلة البلاد اللبنانية:تصدر أسبوعيًا عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان،العددرقم 197، تاريخ السبت 14سبتمبر2019