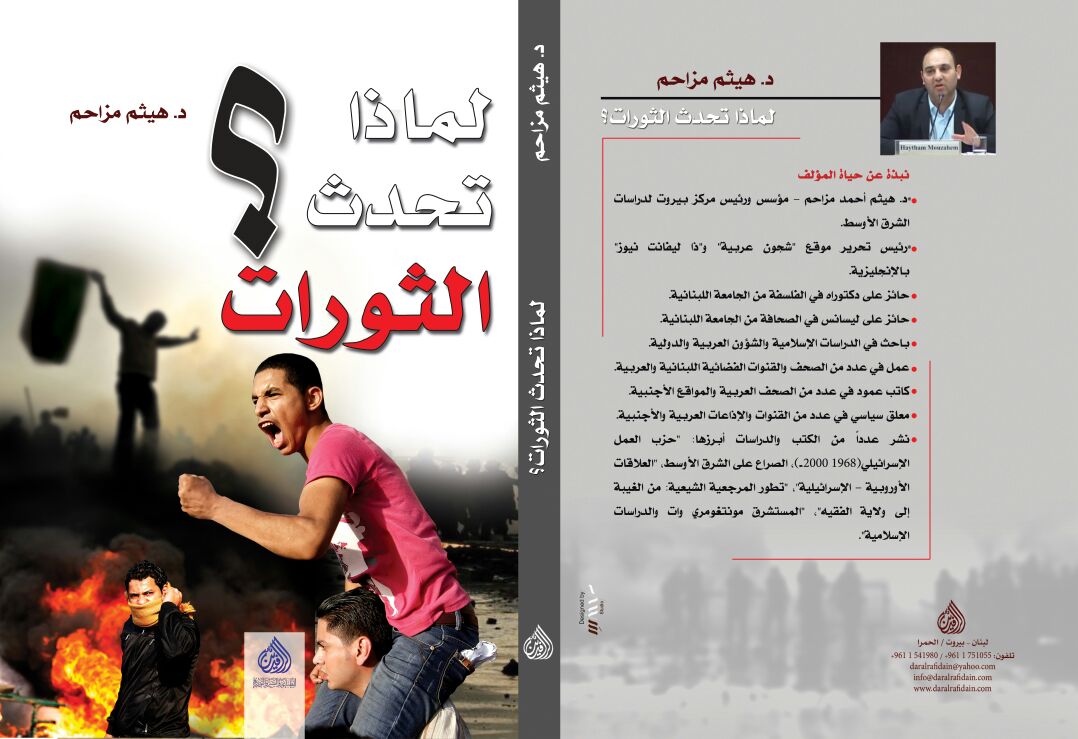تطوّر الاجتهاد لدى الشيعة الاثني عشرية

خاص مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — بقلم: د. هيثم مزاحم* —
قبل الدخول في البحث عن الأدوار التي مرّ بها الفقه الشيعي الإثنا عشري وخصوصاً نشأة الاجتهاد وعلم أصول الفقه وتطوّره بعد الانتقال من المرحلة الأخبارية الأولى إلى المرحلة الأصولية، لا بدّ من تعريف ما هو المراد من الاجتهاد وأصول الفقه.
الاجتهاد لغةً واصطلاحاً
الاجتهاد لغةً مأخوذٌ من كلمة «الجهد» بالضم بمعنى الطاقة أو بالفتح بمعنى المشقة أي «بذل الجهد والطاقة».
أما في مصطلح الفقهاء والأصوليين فيطلق الاجتهاد على معنيين: عام وخاص. والمعنى الخاص فهو المرادف للقياس عند الإمام الشافعي(ت 210هـ) الذي يقول: «فما هو القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى واحد» ونفى أن يكون الاستحسان من الاجتهاد.
ويقول الشريف المرتضى الفقيه الشيعي المتقدم (توفي 410هـ): «وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعيّن أصله الذي يقاس عليه، والاجتهاد ما لم يتعين… وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعم».
يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق في تعريفه للقياس والاجتهاد: «فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس، وهو أيضاً مرادف للاستحسان والاستنباط».
ويذهب العلاّمة الشيعي المعاصر محمد تقي الحكيم إلى القول «إن الاجتهاد بمعناه الخاص مرادف للرأي، وإن القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونظائرها إنما هي من قبيل المصاديق لهذا المفهوم».
وهكذا فإن الاجتهاد كان يفهم منه هذا المعنى الخاص أي الرأي عند أهل السنّة وقد استمر العمل به من القرن الأول حتى القرن الخامس هجري تقريباً. ومنذ القرن الخامس أخذ الاجتهاد مفهوماً أوسع من ذلك.
وكان أئمة الشيعة يعارضون الاجتهاد بهذا المعنى وذلك لبطلان القياس والاستحسان وغيرهما عندهم. واستمرت هذه المعارضة من عصر «الأئمة المعصومين» حتى القرن السابع للهجرة، حيث تغيّر مفهوم الاجتهاد إلى مفهوم أوسع ومختلف عند الشيعة فتقبلوه بعد حذفهم ما يخالف مبادئهم الفقهية كالقياس والاستحسان وأمثالهما عنه.
ولعل من أبرز كتب الشيعة آنذاك في نقد الاجتهاد بمعناه الخاص، كتاب الشيخ المفيد(ت 380هـ)، «النقض على إبن الجنيد في اجتهاد الرأي».
أما المعنى العام للاجتهاد وتعريفه فهو «بذل الوسع لتحصيل الحجة على الواقع أو على الوظيفة الفعلية الظاهرة» وهو ما يقبل به علماء الإثني عشرية.
الاجتهاد زمن الرسول(ص)
يذهب البعض إلى أن بدايات الاجتهاد والقواعد الأولى لعلم أصول الفقه قد وضعت زمن الرسول محمد(ص). ويستند هؤلاء في ذلك بما روي عن النبي(ص) أنه أذن لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أن يجتهد فيما إذا لم يجد نصاً من الكتاب والسنّة في الواقعة محل الابتلاء. وكان الفقيه في هذا الدور، زمن النبي والخلفاء الراشدين، هو من حفظ أيات القرآن الكريم وعرف معانيها وناسخها من منسوخها ومتشابهها من محكمها. وسمي الفقهاء آنذاك بالقراء وكان معروفاً بالفتوى عدد كبير من الصحابة أبرزهم: الإمام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو بكر وعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وجابر الأنصاري وعثمان بن عفان وزيد وأبو رابع وغيرهم.
وكان الإمام علي بن أبي طالب(ع) المرجع الأعم في تشخيص الحكم الشرعي بعد وفاة النبي(ص). ويستدل على ذلك من أقوال النبي(ص) ومن بعده من أقوال الصحابة في علي ومنها قول عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي: «علي أعلم الناس بالسنّة»، وقول عمر: «أقضانا علي» «ولولا علي لهلك عمر»، «ولا يفتين أحد بالمسجد وعلي حاضر»، وكلام إبن عباس: «إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا فلا نعدوها».
وتبيّن أقوال الصحابة أن الناس بعد وفاة الرسول كانوا يعودون إلى الإمام علي وغيره من الصحابة لأخذ الأحكام الشرعية منهم، مما عرفوه من فهمهم للسنة أو من خلال اجتهادهم في المسائل المستحدثة.
كما اشتهر من الفقهاء في هذا الدور عبد الله بن عباس وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي بن كعب. وتميّز هذا الدور بسهولة الاستنباط لوجود ملكة العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لوجود الكتاب والنبي(ص) بينهم خلال حياته أو لقرب عهدهم به بعد وفاته.
ولعل قول النبي(ص): «للمجتهد أجران إذا أخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب كان له أجران» خير دليل على تشجيعه للاجتهاد والمجتهدين في حياته وبعد وفاته.
وكان بعض الصحابة إذا عرضت لهم مسألة يحاولون أن يجدوا حلّها من الكتاب والسنّة، فإن لم يجدوا حلّها فيها كانوا يعملون بما وصل إليه رأيهم في المسألة فيما كان البعض الآخر يتوقف عن الإفتاء بالرأي.
ففي حديث ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وان لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها، فان أعياه خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله(ص) قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله(ص) فيه قضايا، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله(ص) جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به».
كذلك ينقل عن عمر بن الخطاب قوله لشريح: «فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله(ص) ولم يتكلم في أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، وإن شئت أن تجتهد برأيك لتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك».
كما ينقل إبن مسعود قوله «من عرض له منكم قضاء فليقضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضِ بما قضى فيه نبيه(ص)، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضِ به نبيه ولا الصالحون فليجتهد برأيه، فإن لم يحسن فليقُمّ ولا يستحي».
وكان ثمة اتجاهان في ذلك الدور: اتجاه يتمثل في الاجتهاد والعمل بالرأي أي استنباط الحكم من الكتاب أو السنّة أو قول صحابي في المسألة، فإن لم يجد فتوى في أي من هذه المصادر الثلاثة كان الفقيه يرى رأيه في إعطاء الجواب عن المسألة.
أما الاتجاه الثاني فكان يرفض العمل بالرأي والاجتهاد بهذا المعنى أي أخذ الفتوى في ما ليس فيه نص من الكتاب أو السنّة وهو اتجاه عرف بمدرسة الحديث عند السنّة وبالأخباريين عند الشيعة في مقابل مدرسة الرأي عند السنّة والأصوليين عند الشيعة.
الاجتهاد في مدرسة أهل البيت
يذهب بعض علماء الإثني عشرية إلى أن الاجتهاد قد مرّ منذ وفاة الرسول(ص) وحتى عصر الغيبة الكبرى بثلاثة أدوار رئيسية هي:
1-دور يمتد من وفاة الرسول(ص) إلى بداية حياة الإمامين الباقر والصادق(الصادقين).
2- دور يمتد من بداية حياة الإمامين الباقر والصادق حتى نهاية الغيبة الصغرى.
3- دور ثالث يبدأ من بداية الغيبة الصغرى وينتهي مع بداية الغيبة الكبرى.
الدور الأول
ويبتدىء الدور الأول من زمان وفاة النبي محمد(ص) حتى انتهاء القرن الأول هجري وتشمل هذه الفترة حياة أريعة من أئمة الإثني عشرية هم علي بن أبي طالب وإبنيه الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين.
وكان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك هو الكتاب، أي القرآن الكريم، والسنّة أي قول المعصوم (النبي أو الامام) وفعله وتقريره. وكان الإمامية يرفضون القياس والرأي رفضاً باتاً ويروون عن علي بن أبي طالب قوله: «لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره».
وكان الاجتهاد عند الشيعة في ذلك الحين هو الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة ولم يكن يعتمد على أصول في استنباط الحكم بل كانوا يرجعون في ما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة المعاصرين لهم الذين كان لهم دور مهم في بيان الأحكام للناس في هذه المرحلة وخصوصاً الإمام علي الذي كان الصحابة يرجعون إليه في كل مشكلة تواجههم ولا يتوصلون إلى حل لها.
ويؤكد الإثنا عشرية أن علياً وإبنيه الحسن والحسين لم يعملوا بالقياس ولم يروا للإجماع -بالمعنى المشهور في عصرهم- أي قيمة بل كانت أقوالهم تستند إلى الكتاب والسنّة فقط.
الدور الثاني
ويبتدىء هذا الدور من أوائل القرن الثاني ويمتد حتى أواخر القرن الثالث هجري أي من بداية إمامة الإمام محمد الباقر حتى نهاية الغيبة الصغرى(260هـ). وقد شهدت هذه المرحلة إفساحاً للمجال لأئمة أهل البيت كي يمارسوا أعمالهم العلمية اذ أتاحت فترة ضعف الحكم الأموي ومن ثم انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين للإمامين الباقر والصادق فرصة نشر علومهما وتدريس مذهبهما الفكري والفقهي. فقد كان الخلفاء الأمويون مشغولين بالحروب الداخلية مع العباسيين فانصرفوا عن ملاحقة الشيعة وأئمتهم نوعاً ما. وكانت مصادر التشريع في هذا الدور تتمثل أيضاً في الكتاب والسنّة ورفض القياس والاستحسان على غرار الدور الأول. وكانت للإمام الصادق مواقف واضحة في رفض القياس وله مناظرة مشهورة في هذا الصدد مع الإمام أبي حنيفة النعمان (80 -150هـ).
لكن ذلك لا يعني أن الإثني عشرية لم يكونوا يعملون بالاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة. كان الباقر والصادق يأمران أصحابهما باستنباط الأحكام وإفتاء الناس. ويروى أن الباقر أمر تلميذه أبان بن تغلب أن يجلس في مسجد الرسول في المدينة ويفتي الناس إذ قال له: «إجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس فإنني أحب أن يرى في شيعتي مثلك».
ويرفض الشيعة الزعم القائل أن عملية الاجتهاد كانت مختصة بأهل السنّة في تلك المرحلة وأن الشيعة لم يكونوا آنذاك بحاجة إلى الاجتهاد ما دام أئمتهم بينهم إذ أنهم كانوا إذا احتاجوا إلى مسألة أو حكم شرعي أخذوه مباشرة من الأئمة. فيقولون إنهم كانوا يضطرون إلى اللجوء إلى الأصول العلمية لاستنباط الحكم الشرعي مع تعذر الوصول إلى الأئمة الذين كانوا غالباً ما يعيشون في المدينة المنورة أو العراق، فكان يتيسر للشيعة القاطنين هناك الوصول إليهم وأخذ الأحكام منهم. أما بقية أتباعهم الذين كانوا يعيشون في البلدان الأخرى كالعراق أو خراسان أو غيرهما، فكانوا يراجعون تلامذة الأئمة وأصحابهم ورواة الحديث عنهم، حتى أنه كانت لبعض أصحاب الأئمة كتب ورسائل كانت تحتوي على ما سمعوه من الأئمة.
وتارة كانت المسائل التي يرجع فيها الشيعة إلى الرواة وأصحاب الأئمة من المسائل المستحدثة التي لم يسبق لهم معرفة بأحكامها، فكان عليهم البحث عن أحكام هذه المسائل. فكان الشيعة في العراق وخراسان وسائر البلدان يجمعون أسئلتهم ويرسلونها مع الحجاج إلى الأئمة في المدينة المنورة وكان الجواب يصل بعد ستة أشهر أو سنة أو يكون الأئمة في السجن أو الإقامة الجبرية أحياناً، الأمر الذي جعل الشيعة يلجأون إلى شكل من أشكال الاجتهاد لاستنباط أحكام المسائل المستحدثة التي واجهتهم.
وهناك رواية عن الإمام الصادق ينقلها الكليني يقول فيها: «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا أو نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوه حكماً.. ».
وينقل الإثنا عشرية عن الإمام علي الرضا قوله لصاحبه عبد العزيز المهتدي الذي سأله: «إني لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال الرضا(ع): خذ عن يونس بن عبد الرحمن»، وهو أحد أصحاب الامام وتلاميذه.
وفي رواية أخرى ينقلها علي بن المسيب الهمداني عن الإمام الرضا أيضاً، قال: «قلت للرضا(ع) شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فمن آخذ عنه معالم ديني؟ قال(ع): زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا».
فكان على الرواة في هذه الحالة لكي يفتوا الناس عليهم أن يرفعوا التعارض بين الروايات الواردة عن الأئمة والتي فيها العام والخاص والمطلق والمقيّد، أو أن يطرحوا بعضاً منها، وما هذا إلا عملية «الاجتهاد والاستنباط» وإنْ في أشكاله الأولى.
نشأة أصول الفقه
يرى الإثنا عشرية أن علم أصول الفقه الذي يقوم عليه الاجتهاد عند الشيعة قد وضعت أسسه الأولى في عصر الأئمة، بل ويذهبون أيضاً إلى أنه كانت لبعض أصحاب الأئمة وتلاميذهم آنذاك رسائل وتأليفات في مختلف مسائل الأصول. ويزعم الإمامية أن إمامهم محمد بن علي الباقر هو أول من وضع علم أصول الفقه ثم أكمل ذلك من بعده إبنه جعفر الصادق، وأنهما أمليا على أصحابهما قواعد هذا العلم وجمعوا مسائله التي رتبها لاحقاً المتأخرون وفقاً لترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة إليهما متصلة الإسناد.
ويذهب مؤرخو أصول الفقه الإثني عشري إلى أنّ أول من صنف في أصول الفقه، في التأليف في هذا العلم هو المتكلم الشيعي المعروف هشام بن الحكم (ت199 هـ)، أحد تلاميذ الإمام الصادق، متقدماً على الإمام الشافعي (ت204هـ) الذي وضع كتابه الشهير «الرسالة» في أصول الفقه.( )
يقول مؤرخو علم أصول الفقه الإثني عشري أن كتب الفقه وأصوله المروية عن الإمامين الباقر والصادق قد جمعها علماء الشيعة في كتب عدة منها «أصول آل الرسول في استخراج أبواب الفقه من روايات أهل البيت» للعلامة محمد بن هاشم بن زين العابدين الخونساري الأصفهاني (ت1318هـ). وقد جمع فيه الأحاديث المأثورة عنهما في قواعد الفقه والأحكام ورتبها على مباحث أصول الفقه.
وقد وضع هشام بن الحكم كتاب (الألفاظ ومباحثها) وهو يعتبر أهم مباحث أصول الفقه. كما صنف بعده من الإمامية يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين في هذا العلم كتاب (اختلاف الحديث ومسائله)، وهو مبحث تعارض الحديثين، ومسائل تعارض الترجيح في الحديثين المتعارضين، وقد نقله عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ت260هـ).
ويذكر الشيعة أيضاً أن من أبرز علماء أصول الفقه الأوائل لديهم في زمن الأئمة كان أبو سهل النوبختي اسماعيل بن علي بن اسحاق بن أبي سهل الفضل بن نوبخت، ومن أبرز كتبه «كتاب الخصوص والعموم»، وهو يعد من أهم مباحث أصول الفقه، وكتاب «إبطال القياس»، وكتاب «نقض اجتهاد الرأي على إبن الراوندي». ويروي الاثنا عشرية أن ابا سهل هو ممن لقي الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري.
وكانت قواعد علم الأصول في هذه المرحلة أكثرها على شكل روايات ولم تكن بحسب التعبيرات والاصطلاحات المعمول بها في المراحل المتأخرة. وكانت المدينة المنورة مركز مدرسة الإمامين الباقر والصادق وكان مسجد المدينة ومنازل أئمة أهل البيت بمثابة المدارس التي تنظم فيها حلقات الدروس في مختلف العلوم الإسلامية. وتتابعت الوفود من جميع المدن والقرى على المدينة للنهل من علوم أهل بيت النبي وخوصاً في عهد الإمام الصادق حيث نشطت الحركة العلمية بعدما زالت الحواجز التي كانت تحول بينه وبين الناس.
وكان من أبرز تلامذة الباقر والصادق أبان بن تغلب الذي عاصر أيضاً الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وزرارة بن أعين. ومن أعيان تلامذة الصادق محمد بن مسلم الثقفي ومحمد بن النعمان الملقب بـ «مؤمن الطاق» ويزيد العجلي وبريد العجلي وغيرهم.
ويذكر مؤرخو الإثني عشرية أن أبان قد روى عن الصادقين أكثر من ثلاثين ألف حديث في مختلف المواضيع وأكثرها في الفقه، وقد ذكر له إبن النديم في كتابه «الفهرست» ثلاثة كتب في القراءات والقرآن وأصول الحديث. أما زرارة، فهو يعتبر مرجعاً في الفقه والرواية لدى الإمامية إذ قال فيه الصادق: «لولا زرارة لظننت أنّ أحاديث أبي ستذهب».
وقد ضمت مدرسة الإمام الصادق نحو أربعة آلاف من حملة العلم وقد ألف أربعمائة منهم أصولاً يعتمد عليها في الفقه الجعفري تسمى بـ«الأصول الأربعمائة» وجمعت في أربع موسوعات تضم أحاديث الرسول والأئمة تعرف بـ«الكتب الأربعة»، وهي «الكافي في الأصول والفروع» للشيخ أبي جعفر محمد إبن يعقوب الكليني (توفي 329هـ)، وكتاب «من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي القُمّي (ت381هـ)، وكتابا «تهذيب الأحكام» و «الاستبصار» للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (توفي 460هـ).
وفي هذا الدور وضعت نواة القواعد العامة لأصول الفقه الإثني عشري التي نقلت إلينا على شكل روايات، ثم وضعت لاحقاً على طاولة البحث العلمي فخرجت منها القواعد الأصولية والفقهية للاجتهاد الشيعي التي لا تزال حتى اليوم وأبرزها: الاستصحاب، والبراءة الشرعية، وقاعدة اليد، وترجيح الروايات المتعارضة، والعمل بالخبر الواحد.
وهكذا وجدت بذور التفكير الأصولي لدى أصحاب أئمة أهل البيت وخصوصاً أيام الصادقين، ولكن تطور علم الأصول لدى الشيعة الإثني عشرية قد بدأ فعلياً منذ غيبة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر، واستمر إلى يومنا هذا وهو يشكّل الدور الثالث في تطور الاجتهاد لدى الشيعة الإثني عشرية.
لا شكّ أن علم الأصول قد نشأ في أحضان علم الفقه الذي نشأ بدوره في أحضان علم الحديث. فقد بدأ هذا العلم في صدر الإسلام من خلال قيام عدد كبير من الرواة بحفظ الأحاديث الواردة في الأحكام وجمعها، وكان العمل الأساسي آنذاك يكاد يكون مقتصراً على جمع الروايات وحفظ النصوص ولم تكن طريقة فهم الحكم الشرعي من تلك النصوص سوى الطريقة الساذجة التي يفهم بها الناس كلام بعضهم بعضاً. وتعمقت بالتدريج طريقة فهم الحكم الشرعي من النصوص فأصبحت عملاً لا يخلو من الدقة ويتطلب عمقاً وخبرة فانصبت الجهود لاكتساب هذه الدقة لاستنباط الحكم الشرعي وبذلك نشأت بذور التفكير العلمي الفقهي وولد علم الفقه وتطور من مستوى علم الحديث إلى مستوى الاستدلال العلمي الدقيق.
ومن خلال نمو علم الفقه والتفكير الفقهي بدأت العناصر المشتركة في عملية الاستنباط تظهر وتتكشف «وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إيذاناً بمولد التفكير الأصولي وعلم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاهاً أصولياً».
وهكذا أصبح الممارسون للعمل الفقهي يعون العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، التي كانوا يستخدمونها سابقاً دون وعي كامل بطبيعتها وحدودها وأهمية دورها في هذه العملية، ويدرسون حدودها. ثم بدأت تتّضح معالم هذه العناصر المشتركة وأهمية دورها وتتعمق تدريجاً من خلال التوسع في العمل الفقهي وتطور عمليات الاستنباط. وقد عاش البحث الأصولي ردحاً من الزمن ممتزجاً بالبحث الفقهي غير مستقل عنه في التصنيف والتدريس إلى أن بلغ ثراء الفكر الأصولي ووضوحه درجة أتاحت له الانفصال عن علم الفقه. كما كان علم أصول الفقه يختلط أحياناً بعلم أصول الدين والكلام كما يشير إلى ذلك السيد المرتضى في كتابه «الذريعة».
ولم ينجز استقلال أصول الفقه بوصفه علماً للعناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي وانفصاله عن باقي العلوم الدينية الأخرى من فقه وكلام إلاّ بعدما اتضحت أكثر فأكثر فكرة العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وتمايزها عن طبيعة البحوث الفقهية والكلامية، فتبلورت فكرة ضرورة وضع نظام عام لها وهو ما أطلق عليه اسم «علم أصول الفقه».
ونجد في كتاب «الذريعة»، أحد أقدم المصادر الأصولية لدى الاثني عشرية، نصاً يُبيّن لنا وجود تصورات دقيقة نسبياً ومحددة عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط في تلك المرحلة. فقد كتب المرتضى: «إعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه… ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلة والطرق إلى أحكام وفروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولاً، لأن الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التفصيل، وأدلة الفقهاء إنما هي على نفس المسائل، والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل».
وهذا النص يميّز بين البحث الفقهي والبحث الأصولي على أساس التمييز بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية أي بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. ولذلك نجد معظم الأصوليين الأوائل قد عرفوا علم الأصول بأنه «علم أدلة الفقه على وجه الإجمال» وحاولوا التعبير عن ذلك بفكرة «العناصر المشتركة».
ويفسر آية الله محمد باقر الصدر تأخر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور علمي الفقه والحديث بارتباط العقلية الأصولية بمستوى متقدم نسبياً من التفكير الفقهي من جهة، ولأن علم الأصول وجد تعبيراً عن حاجة ملحة شديدة لعملية الاستنباط التي تتطلب من علم الأصول تموينها بالعناصر المشتركة التي لا غنى لها عنها، وهي كانت في الواقع حاجة تاريخية وليست حاجة مطلقة، إذ برزت بعد ابتعاد الفقه عن عصر النصوص. فبوجود النبي محمد(ص) لم تكن ثمة حاجة إلى علم الأصول لمعرفة الحكم الشرعي الذي تسمعه من النبي مباشرة.
وقد أدرك الرواد الأوائل ذلك التفسير لسبب نشأة علم أصول الفقه، فقد كتب حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي (ت585هـ) في كتابه «الغنية» يقول: «ولما كان الكلام في فروع الفقه يبنى على أصول له وجب الابتداء بأصوله ثم اتباعها بالفروع، وكان الكلام في الفروع من دون أحكام أصله لا يثمر، وقد كان بعض المخالفين سأل فقال: إذا كنتم لا تعملون في الشرعيات إلاّ بقول المعصوم فأي فقر بكم إلى أصول الفقه، وكلامكم فيها كأنه عبث لا فائدة فيه». ففي هذا النص يربط إبن زهرة بين الحاجة إلى علم الأصول والثغرات في عملية الاستنباط، «لأن استخراج الحكم إذا كان قائماً على أساس قول الإمام المعصوم مباشرة فهو عمل ميسر لا يشتمل على الثغرات التي تتطلب التفكير في وضع القواعد والعناصر الأولية لملئها».
ونجد في نص للمحقق محسن الأعرجي (ت1227هـ) في كتابه الفقهي «وسائل الشيعة» وعياً كاملاً لفكرة الحاجة التاريخية لعلم الأصول، فقد تحدث عن اختلاف القريب من عصر النبي عن البعيد منه في الظروف والملابسات إذ قال: «أين من حظى بالقرب ممن ابتلى بالبعد حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر؟ كلا إنّ بينهما ما بين السماء والأرض، فقد حدث بطول الغيبة وشدة المحنة وعموم البلية، ما لولا الله وبركة آل الله لردّها جاهلية. فسدت اللغات وتغيّرت الاصطلاحات وذهبت قرائن الأحوال وكثرت الأكاذيب وعظمت التقيّة واشتد التعارض بين الأدلة حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه، مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف، وليس هنا أحد يرجع إليه بسؤال. وكفاك مائزاً بين الفريقين قرائن الأحوال وما يشاهد في المشافهة من الانبساط والانقباض… وهذا بخلاف من لم يصب الا أخباراً مختلفة وأحاديث متعارضة يحتاج فيها إلى العرض على الكتاب والسنّة المعلومة… فإنه لا بد له من الإعداد والاستعداد والتدرّب في ذلك كي لا يزل، فإنه إنما يتناول من بين مشتبك القنا».
ولعل بيان أن الحاجة إلى علم الأصول هي حاجة تاريخية يفسر لنا الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في التفكير الفقهي السني وازدهاره في التفكير الشيعي الإثني عشري. فقد ترعرع علم الأصول وازدهر نسبياً لدى أهل السنّة قبل ترعرعه وازدهاره لدى الشيعة ودخل علم الأصول في المدرسة الفقهية السنية دور التصنيف في أواخر القرن الثاني حيث أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي (ت 150-179هـ) ثمّ محمد بن الحسن الشيباني (ت189هـ) بينما لا نجد تصنيفاً واسعاً ومحدداً في علم الأصول لدى الإثني عشرية إلا في أعقاب الغيبة الكبرى (329هـ) أي في مطلع القرن الرابع على الرغم من وجود رسائل سابقة لأصحاب الأئمة في مواضيع أصولية متفرقة. ويعود ذلك كما أسلفنا إلى أنه بمجرد انتهاء عصر النصوص عند الإثني عشرية أي مع بدء الغيبة الكبرى(329هـ)، برزت الحاجة إلى أصول الفقه فأقبل علماء الشيعة على غرار الحسن بن أبي عقيل العماني ومحمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي في القرن الرابع على دراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط أي علم الأصول والاجتهاد الفقهي.
ويقول السيد بحر العلوم عن إبن أبي عقيل: «هو أوّل من هذّب الفقه واستعمل النّظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى».
وكان الأصوليون القدامى تقتصر أهمية علم الأصول عندهم على استنباط القواعد وكانت قراراتهم ترتبط بشدة بالمنهجية التقليدية في فهم النص ومناقشة مدلولاته ضمن حدود المعنى الظاهري للنص. وقد قاد الشيخ المفيد مجموعة الفقهاء (القدامى) الذين أظهرت أعمالهم منهجية عقلية في الأحكام الشرعية المستنبطة، وقد عرف باسم الشيخ ورجع إليه الإمامية في كل أعمالهم الفقهية.
وكان ثمة اتجاهات متفاوتة في فقه الشيعة قبل الشيخ المفيد، أحدهما اتجاه برز فيه علي بن بابويه(ت329هـ) نستطيع تسميته باتجاه القُمّيين. وكان أستاذ المفيد في الفقه، جعفر بن قولويه (ت368هـ) من ممثلي هذا الاتجاه أيضاً وكانت الفقاهة في هذا الاتجاه تعني الإفتاء حسب نصوص الروايات بحيث أن كل فتوى في كتب هؤلاء الفقهاء تحكي عن وجود رواية في مضمونها وهي فقاهة بسيطة جداً «وعارية عن الأسلوب الفني المعمق والفروع المذكورة في الكتب الفقهية لهذا الاتجاه تنحصر بالفروع المنصوصة وهي قليلة ومحدودة». وهذا هو سبب توجيه خصوم الشيعة طعونهم لفقههم متهمين إياه بقلة الفروع الأمر الذي حفّز الشيخ الطوسي على تصنيف كتاب «المبسوط» في أصول الفقه دفعاً لهذا الطعن.
أما الاتجاه الثاني الذي كان لدى الإمامية قبل المفيد فهو اتجاه يستند إلى الاستدلال والظن الغالب، متخذاً من أصول الفقه لدى أهل السنّة منطلقاً، وهو الاتجاه الذي مثله إبن أبي عقيل العماني وإبن الجنيد. وعلى الرغم من أن علماء الإثني عشرية لم يحفظوا آثار هذين الفقيهين لكونهما عملا بالقياس والرأي، غير أنه كان لإقدامهما على ذلك تأثير على ما توصل إليه الشيخ المفيد لأول مرة من قاعدة صحيحة للفقاهة، بل كان المقدمة لعمل الشيخ المفيد العلمي.
إبن الجنيد
بعد وفاة سفراء الإمام المنتظر الأربعة، أصبح فقيه الشيعة الإثني عشرية ومرجعها الشيخ الحسن بن علي العثماني الذي انبـرى للاجتهاد والفـتيا بـعد الغــيبة الكبرى سـنة 329هـ وصنف كتاب «المتمسك بحبل آل الرسول» وعاصر الكليني محمد بن يعقوب وعلي بن بابويه النعماني. ثم جاء بعده محمد بن أحمد بن جنيد الإسكافي(ت381هـ) وهو فقيه بارز له مصنفات عدة أبرزها كتاب «تهذيب الشيعة» و «كتاب الأحمدي». والجنيد من قدماء فقهاء الإمامية وصاحب اتجاه مستقل وفريد في الاجتهاد الشيعي إذ يقول بالقياس ولذلك تركت تصانيفه.
ويقول عنه الشيخ الطوسي في كتابه «الفهرست» إنّه «كان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس فترك لذلك كتبه ولم يعوِّل عليها وله كتب كثيرة».( ) ومع ذلك لم يترك الإثنا عشرية جميع أقواله بسبب عمله بالقياس إذ يقول العلاّمة بحر العلوم عنه: «وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة ورياسة وعظم محله قد حكى عنه القول بالقياس ونقل عنه جماعة من أعاظم الأصحاب».( ) ثم يذهب إلى القول: «ومما ذكرنا أن الصواب اعتبار أقوال إبن الجنيد في تحقيق الوفاق والخلاف كما عليه معظم الأصحاب، وان ما ذهب إليه أمر القياس ونحوه لا يقتضي إسقاط كتبه ولا عدم التعويل عليه أما قاله الشيخ رحمه الله فإن اختلاف الفقهاء في مباني اللأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم لأنهم قديماً وحديثاً كانوا مختلفين في الأصول التي تبنى عليها الفروع كاختلافهم في خبر الواحد والاستصحاب».
وقد صنف إبن الجنيد كتباَ عدة أبرزها: «كتاب كشف التموين والالباس على اغمار الشيعة في امر القياس»، وكتاب «إظهار ما ستره أهل العباد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد»، وكتاب «تهذيب الشيعة» في عشرين مجلداً يشتمل على جميع أبواب الفقه، وكتاب «المختصر في الفقه الأحمدي» اختصر به كتابه «تهذيب الشيعة»، وهو الذي وصل إلى أيدي المتأخرين ومنه انتشرت مذاهبه وأقواله، حيث قام بتحرير المسائل الفقهية على وجه الاستدلال. وقد أدرك إبن الجنيد زمان وكيل الإمام المهدي، السمري والكيلني صاحب كتاب «الكافي».
وقال المحدث القُمّي عن الإسكافي: «يروى عنه المفيد وغيره»،( ) وهو الذي دون الأصول على مذهب الأمامية وكذلك تحرير الفتاوى في الكتب الفقهية.
ومن فقهاء هذه الفترة أيضاً محمد بن داود بن علي بن الحسن (توفي 368هـ) وكان شيخ الطائفة وفقيهها آنذاك وله كتاب «مسائل الحديثين المخلفين» في أصول الفقه.
الشيخ المفيد
يعتبر الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان المفيد البغدادي(336-410هـ) مؤسس الحركة العلمية في علمي الكلام والفقه لدى الإثني عشرية والتي طوّرها من بعده تلميذاه السيد المرتضى علم الهدى (ت 436هـ) والشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت 460هـ).( ) وكان الشيخ المفيد في تلك المرحلة من العلماء الذين وضعوا الركائز الأولى لعلم أصول الفقه لدى الإثني عشرية حيث دخل علم الأصول مرحلة التصنيف والتأليف بسرعة، فألف الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد (ت413هـ) كتاباً في الأصول واصل فيه الخط الفكري الذي سار عليه إبن أبي عقيل وإبن الجنيد قبله، ونقدهما في جملة من آرائهما. وكانت له مصنفات كثيرة أبرزها «كتاب في الأعلام» و«جواب المسائل في اختلاف الأخبار» وكتاب «النكت في مقدمات الأصول».
وقال عنه العلاّمة آغا بزرك أن كتابه في «أصول الفقه» الذي ذكره النجاشي قد رواه عن العلاّمة الكراكجي وأدرجه مختصراً في كتابه «كنز الفوائد» وهو مشتمل على تمام مباحث الأصول باختصار.( ) وقد جمع الشيخ المفيد فقه الشيخين القديمين إبن بابويه وجعفر بن قولوية وعلم كلام إبن قبه وبني نوبخت الذين أخذوا عن المعتزلة وعلم رجال الكشي والبرقي، وحديث الصدوق والصفار والكليني، إلى جانب قدرة الجدل والمقارعة الفكرية القوية التي كان يتمتع بهما.
وكان المفيد شيخ الطائفة الشيعية في العراق وكانت داره في بغداد دائرة للمعارف العالية ومدرسة للعلوم الإسلامية تخرج منها الشريفان الرضي والمرتضى والطوسي والنجاشي وآخرون لا يحصون. وقد لقبه بـ«المفيد» علي بن عيسى الرماني النحوي عند مهاجمته لقاضي قضاة بغداد ابي بكر الباقلاني ونظرائه. واتصل المفيد بالدولة البويهية في بغداد وبنى معها علاقة وثيقة فموّلوا مدرسته وخصّصوا له جامع (براثا) في منطقة الكرخ لإمامة الصلاة والوعظ. وكان عضو الدولة البويهي يزوره مما يدل على عظم شأنه.
ومن أبرز كتب المفيد «المقنعة»، الذي قام الشيخ الطوسي بتبيان مصادره وذكر أدلته من الأخبار والأحاديث في كتابه الموسوعي «تهذيب الأحكام» أحد الكتب الأربعة الرئيسية.
وقال عنه العلاّمة المجلسي في كتابه «مرأة العقول»: «وهو المستمر والمطلع على كثير من أصول القدماء وكتبهم». وقال فيه إبن النديم(ت380هـ) في «الفهرست» إنه شيخ كل الشيعة في الفقه والكلام والحديث. كما قال عنه الذهبي في تاريخه «إنه كان فريداً في كل العلوم: في الأصولين، والفقه، والأخبار، ومعرفة الرجال، والقرآن، والتفسير، والنحو والشعر… وكان يناظر أرباب جميع العقائد».
يقول العلاّمة الحلّي في مقدمة كتابة «المنتهى» أنّ تعبير (الشيخ) عندما يرد في كتابه يقصد به الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي أو الشيخ المفيد وأنه يقصدهما معاً عندما يقول (الشيخان). ويشير الحلّي أيضاً إلى أن الطوسي يعتبر الإمام الأعظم للشيعة بسبب مساهمته الكبيرة في العلم الإمامي عموماً والفقه خصوصاً.
ويرى الباحث عبد العزيز ساشدينا أن الشيخ المفيد كان يكتب في ظروف مناسبة نسبياً تحت حماية الحكم البويهي الشيعي وهو ما ظهر أحياناً في آرائه تجاه السلطان العادل. وقد قام فقهاء السياسة الشيعة خلال الفترة البويهية خصوصاً في مدرسة بغداد مع المفيد وتلميذيه المرتضى والطوسي بتوضيح مبادىء توسيع صلاحيات الفقيه وهي مبادىء استند إليها عبر التاريخ الفقه الشيعي بأكمله. كما أنشأوا مجموعة جديدة من مصطلحات الأصول أتاحت لهم التعامل بمرونة وبراغماتية مع حكومات الأمر الواقع من أجل الاستمرار التشريعي. وقد كانت هذه البراغماتية في الفقه السياسي أساساً لتفسير عقلاني وأحياناً راديكالي عبر استقراء النصوص الإسلامية المذكورة في الروايات التي جمعها الكليني وإبن بابويه. وهكذا فإن عبارة «السلطان العادل» وردت في أحكام شرعية تعاملت مع الوظائف السياسية المقتصرة على الإمام المعصوم.
ويرى السيد الخامنئي أن أهمية دور الشيخ المفيد التأسيسي في الحركة العلمية الشيعية تتركز في تعيينه حدود مدرسة أهل البيت وخصائصها المميزة لها عن المدارس الإسلامية الأخرى في الفقه والكلام، وهو قام بإنجاز مجموعة من الأعمال العلمية لتحقيق هذا الهدف الكبير فصنف كتاب «المقنعة» في الفقة، وهو دورة تكاد تكون كاملة في الفقة وفيه نهج الصراط المستقيم والطريق الوسط من الاستنباط الفقهي الذي هو مزيج من استخدام الأدلة اللفظية والقواعد الأصولية مع تجنب القياس والاستحسان والأدلة الأخرى غير المعتبرة.
كما ألف المفيد كتاب «التذكرة في أصول الفقه» الذي جمع فيه لأول مرة قواعد الاستنباط الفقهي وأفتى على أساسها، وكذلك كتاب «الأعلام» الذي ذكر فيه مواضع من إجماع فقهاء الشيعة على حكم واجماع فقهاء السنّة على عدم الافتاء بذلك الحكم. ودوّن المفيد كتاب «المسائل الصاغانية»، وهو يجيب فيه على إشكالات فقيه حنفي على عدد من مسائل فقه الشيعة ويرسم فيه الحدود الفقهية بين الحنفية والإمامية. ويعتبر كتاب «النقض على إبن الجنيد» من الأعمال العلمية الأساسية للشيخ المفيد، لأنه قام فيه بتبيين الخصائص المميزة لفقه الإثني عشرية، وكان له تأثير كبير على عدم استمرار اتجاه القياس بين فقهاء الشيعة الذي مثله إبن الجنيد الإسكافي والحسن بن أبي عقيل العماني.
ولم يقتصر دور المفيد في مجال تثبيت الهوية المستقلة للتشيّع على علم الفقه، بل كان له دور كبير في بيان الفصل بين عقائد الشيعة الإثني عشرية وسائر الفرق وخصوصاً المعتزلة والمذاهب الشيعية الأخرى، وذلك لإزالة الاتباس والشبهة لدى الناس حول نسبة بعض الأفكار الشيعية إلى الاعتزال أو تسرّب بعض العقائد المنحرفة من هذه الفرق إلى التشيّع.
ولعل أهم آثار الشيخ في هذا المجال هو كتابه المعروف «أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» الذي ألفه لبيان الفرق بين الشيعة والمعتزلة، إذ تناول فيه الاختلاف بين ما اتفقت عليه الفرقتان في بعض المسائل الأصولية كالعدل، والفرق في فهم كل فرقة لهذه الأصول. وينقد المفيد في هذا الكتاب أيضاً عقائد بعض علماء الإمامية الذين أخذوا بعض آراء المعتزلة وشابوا كلام الشيعة بها، ومنهم بنو نبوخت.
الشريف المرتضى
ومن أبرز تلامذة الشيخ المفيد السيد الشريف المرتضى (355-436هـ) الذي تولى الزعامة الدينية والسياسية للإثني عشرية من بعده والمرتضى أخ الشريف الرضي ولقبه علم الهدى، وكان عماد الشيعة ونقيب الطالبيين ببغداد بعد أخيه الرضى ووالده.( )وقد صنّف كتباً عديدة أبرزها كتبه في أصول الفقه، ومنها «الذريعة في علم أصول الشريعة» في جزئين «لم يصنف مثله جمعاً ولا تحققا استوفى فيه كل مباحثه وتعرّض لنقل الأقوال في مسائله وحقق الحق فيها وكان هذا الكتاب هو المرجع في هذا العلم والذي ظل يقرؤه الناس إلى زمان المحقق نجم الدين الحلّي»،( ) الذي صنف «المعارج». وكان كتابه سهل العبارة والمأخذ فعكفت الطلبة عليه ومع ذلك يعد كتاب «الذريعة» للمرتضى إلى اليوم من أشهر كتب أصول الفقه عند الشيعة وأحسنها.
وهكذا لم يكن قبل الشريف المرتضى في أصول الفقه لدى الإثني عشرية رسائل مختصرة فجاء كتابه «الذريعة» سنة 430هـ حاوياً لأمهات مسائل هذا العلم. يقول المرتضى في مقدمة كتابه: «إني رأيت أن أملي كتاباً متوسطاً في أصول الفقه لا ينتهي بتطويل إلى الإطلال، ولا باختصار إلى الإضلال… وأخص مسائل الخلاف بالاستيفاء فإن مسائل الوفاق يقل الحاجة فيها إلى ذلك».
ومن أبرز مؤلفات المرتضى الأخرى كتاب «الشافي» الذي لخصه الطوسي وسمّاه «تلخيص الشافي»، وهو كتاب في أصول الدين ألفه لنقد كتاب «المغني من الحجاج» للقاضي عبد الجبار المعتزلي الذي كان معاصراً له.
درس المرتضى على المفيد ودرّس عدداً كبيراً من العلماء الإماميين المعروفين أبرزهم الشيخ الطوسي، وكانت مساهمة المرتضى في علم الكلام الإمامي كبيرة مثلما مساهمته في الفقه السياسي. وتظهر أعماله في الكلام والفقه اهتمامه باستخدام المبادئ العقلية للوصول إلى الحقيقة الدينية. وكان كتابه «الذريعة في أصول الشريعة» العمل الكامل الأول من نوعه ففيه ذكر الشريف المرتضى آراء كل العلماء بشأن الأسس النظرية للشريعة، رافضاً مبدأ القياس وشارحاً اعتراضات الإمامية على هذه المبادئ التي يستعملها الفقهاء السنّة في استنباط أحكام الشريعة.
وقد كتب أيضاً أعمالاً عدة في الفقه المقارن والعلمي، وله كتاب «الرسائل الجوابية» على المسائل العلمية المتعلقة بصلاحيات الفقيه في التعامل مع الحكومات الجائرة.
وللمرتضى رأي سياسي في مسألة جواز إقامة صلاة الجمعة في غياب الإمام المنتظر حيث اعتبرها غير جائزة في غيابه لأن الإمام الثاني عشر هو وحده السلطة الشرعية، وذلك بدلاً من إجازة صلاة الفقيه كنائب له. وقد تم الاستناد إلى فتوى المرتضى هذه للبناء على أن الفقيه لا يمكنه شغل الوظيفة السياسية للإمام الغائب من خلال صلاحياته كنائبه العام. وكان من أبرز تلامذة مدرسة بغداد التي أسسها المفيد وتلميذاه المرتضى والطوسي:
1- أبو صلاح تقي الدين الحلبي (ت 447هـ/1055 هـ) وكان فقيهاً بارزاً وعمل وكيلاً للمرتضى ألّف كتاب «الكافي في الفقه».
2- سُلار الديلمي حمزة بن عبد العزيز الطبرستاني (ت 448 أو 463 هـ/ 1056 أو 1070م).
أهمية كتاب الذريعة
يشتمل كتاب «الذريعة في أصول الفقه» على أربعة عشر باباً، كل باب يحتوي على فصول عدة وأبرز مسائل البحث هي: الخطاب، الأمر والنهي، العموم والخصوص، المجمل والمبيّن، النسخ، الإجماع، القياس، الاجتهاد والتقليد، الحظر والإباحة، والاستصحاب.
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن المؤلف حاول الفصل في مباحثه بين ما هو من أصول الفقه وبين ما هو من أصول العقائد، وقد كان أصول الفقه مزيجاً من الطرفين.
وقد اعتمد السيد المرتضى في كتابه منهجاً يقوم فيه بذكر آراء السنّة في مسألة خلافية ويذكر أدلتهم تفصيلاً ثم يحاول مناقشتها ونقدها ثم يبرهن على رأيه في المسألة. وفي المسائل التي كان يوافق فيها على آرائهم كان يؤيد أدلتهم وأحياناً يذكر أدلة أخرى تدعم هذا الرأي.
ويتميّز منهج المرتضى في البحث عن أسلافه من علماء الشيعة وفقهائهم، وخصوصاً أستاذه المفيد وإبن أبي عقيل العماني وإبن الجنيد الذين كانوا رواد الاجتهاد الشيعي، في قيامه بفحص الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت فحصاً علمياً ونفي ما علق بهذه الروايات من الغلو والجبر والتجسيم والتشبيه والى تحديد الفرق بين المذهب الشيعي الإثني عشري والمذاهب الشيعية الأخرى كالزيدية والاسماعيلية والوافقية. كما أدخل الاجتهاد وحق النظر في ما ورد من أحاديث الفقه الإمامي وأسس له أصولاً لفظية وعقلية يعتمد عليها في فهم تلك النصوص، وهي أصول سبق لأهل السنّة أن حرّروها وبحثوها ولم يكن للإمامية فيها نصيب. ولكن العماني وإبن الجنيد، قبل السيد المرتضى، التفتا إلى خطر هذا الفن في معرفة الأحكام الشرعية وتابعهما المرتضى وزاد، فكانت أصوله تتفق كثيراً مع أصول العامة (أهل السنّة) وتختلف معها فيما يمكن أن يتعارض مع أصول المذهب الإمامي، فلم يقبل إجماعاً ولا قياساً في حدود ما ألفت العامة، وقبل القياس في حدود العلة المنصوصة، وله في ذلك رسائل متناثرة وكتب أهمها: كتاب الذخيرة. وألّف في الفقه المقارن فوازن بين مذهبه محتجاً له، وبين المذاهب الأخرى محتجاً عليها وله في ذلك كتب أهمها «الانتصار» و«الناصريات» وفرّق بين الإمامية والمعتزلة والزيدية وأشار إلى مواطن التقائهم وخلافهم.
وكان الإمامية في ذلك العصر كثيري التساؤل والاعتراض على صنيع السيد المرتضى في أصول المذهب ولهذا أكثروا ونوّعوا الأسئلة، وكان يجيب عليهما بما يجلو لهم الشبه ويزيل الشكوك. وكانت طريقته في أصول الفقه متابعة دليل العقل مخالفاً بذلك الأشاعرة والظاهرية من الإمامية أي الأخباريين، وموافقاً للمعتزلة. وقد ذهب إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد في المسائل الفقهية. كما كان يستفيد في عمليه الاستنباط من الأدلة الأصولية لفظية وعقلية وهو بذلك خالف الأخباريين من الشيعة.
وقد مهد الشيخ المفيد، المرجع الوحيد للإمامية آنذاك، لتلميذه المرتضى أن يخلفه في المرجعية فكان يجلسه في مكانه. وهكذا تحوّل مجلس المرتضى إلى مركز علمي وثقافي في بغداد ومقر مرجعية الإثني عشرية السياسية والدينية بعد وفاة المفيد. والجدير بالذكر أن مصنفات المرتضى قد تجاوزت الثمانين كتاباً ورسالة، وأنّه بلغ الثمانين من العمر، كما كانت له مكتبة تضم ثمانين ألف كتاب وكان يملك ثمانين قرية ولذلك لقب بـ«ذو الثمانين» أو «الثمانيني».
دور الشيخ الطوسي ومدرسة الحلّة في تطوّر الاجتهاد
مرحلة الشيخ الطوسي
كان أبرز تلامذة السيد المرتضى هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي(385-460 هـ) الملقب بشيخ الطائفة، وهو مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومرجع الشيعة في عصره. وقد تتلمذ الطوسي على يد الشيخ المفيد. وبعد وفاته سنة 413هـ، حضر الطوسي دروس المرتضى، تلميذ المفيد وخليفته، ولازمه ثم تولى الزعامة الدينية والسياسية بعد وفاة المرتضى(436 هـ).
وأصبح الطوسي علماً للشيعة ومناراً للشريعة وأصبحت داره مركزاً للعلم في بغداد، وبعدها انتقل إلى النجف بسبب المحنة التي تعرّض لها الشيعة وعلماؤهم خلال عهد طغرل بيك، أول ملوك السلاجقة (477هـ) والذي أمر بإحراق كتبه وكرسيّه، فهرب الطوسي إلى النجف وصيّرها مدينة للعلم وجامعة للشيعة الإمامية خرّجت كبار الفقهاء والعلماء والفلاسفة والأدباء والشعراء والمراجع المسلمين إلى يومنا هذا.
ويعود الفضل إلى الطوسي في تأسيس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقه والأصول والاستنباط على الطريقة الجعفرية ولهذا اشتهر بلقب «الشيخ»، أي شيخ الطائفة الشيعية من عصره إلى عصر الشيخ مرتضى الأنصاري(ت 1281هـ)، المرجع الكبير والمجتهد المجدد لدى الإثني عشرية.
وبلغت أهمية الطوسي درجة جعلت نظرياته الفقهية وفتاواه تعتبر لدى الإثني عشرية وعلمائهم أصلاً مسلماً يكتفون بها ويعدون التأليف قبالها وإصدار الفتوى مع وجودها تجاسراً عليه وإهانة له، الأمر الذي عطّل الاجتهاد حتى عصر إبن إدريس الحلّي(534 -598هـ) الذي خالف بعض آراء الطوسي وفتح باب الرّد على نظرياته وسمى أسلافه بالمقلدة بسبب جمودهم وتقليدهم للطوسي وتخلّيهم عن الاجتهاد. ومع ذلك فقد بقوا فترة طويلة على هذه الحال.
وقد تابع الطوسي تطوير قواعد أستاذه المفيد في أصول الفقه وأبرزها في أعماله خصوصاً في كتابيه «النهاية» و «المبسوط»، اللذين كانا خلاصة حياته العملية، إذ يظهر الكتابان قيادة الطوسي للفقه الإمامي وقدرته على استخدام أصول الفقه في اشتقاق أحكام شرعية. وكان كتابه «النهاية» هو المحور في الدرس والبحث لدى الإثني عشرية في الحوزات العلمية إلى أن ألف المحقق الحلّي كتاب «شرائع الإسلام» فاستعاضوا به عن كتاب الطوسي.
وقد ألّف الطوسي كتاباً مستقلاً في الأصول هو «العدّة في أصول الفقه» شرح فيه أصول العقيدة الإمامية ومصادرها التشريعية وأساليب استنباط الأحكام الشرعية من خلال الاستدلال بأولوية سلطة العقل في فهم النص. ويناقش الطوسي في كتابه هذا مفهوم الاجتهاد والمسائل المرتبطة به في فصل منفصل. كما ألف الطوسي كتباً فقهية وروائية وأصولية أخرى أبرزها كتابا «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» في الحديث، وهما من الكتب الأربعة عند الإثني عشرية.
أعمال الطوسي
تعتبر مؤلفات الطوسي المنبع الأول والمصدر العظيم لمعظم مؤلفي القرون الوسطى وهمزة الوصل بين قدامى الأصحاب وبين من تأخر عنه، ولذلك أخذوا منها مادتهم وكوّنوا كتبهم، ومن مميّزات كتب الطوسي أنّها حوت خلاصة كتب الأصحاب القدامى، وأصولهم المعروفة بـ«الأصول الأربعمائة». ومردّ ذلك إلى معاصرته للشيخ المفيد والسيد المرتضى من جهة ولأنه كانت في متناوله مكتبات عظيمة كمكتبة جندي سابور في الكرخ، التي كانت تضم الكتب القديمة الصحيحة التي كانت بخطوط مؤلفيها، ومكتبة أستاذه المرتضى الذي صحبه نحو 28 سنة، وكانت تضم ثمانين ألف كتاب، وهو ما أتاح له تأليف كتابيْه الموسوعين: «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار»، وغيرها من الكتب الأخرى في مختلف العلوم.
فالكتابان هما من الكتب الأربعة وموسوعات الحديث التي عليها مدار الاستنباط عند فهاء الإثني عشرية منذ عصر الطوسي إلى اليوم. فكتاب «الاستبصار» يشتمل على العبادات والعقود والايقاعات والأحكام إلى الحدود والديّات، واقتصر فيه على ما اختلف فيه من الأخبار وطريقة الجمع بينها وحصرها بـ5511 حديثاً. أمّا «التهذيب» فقد اشتمل على 393 باباً وعلى 13590 حديثاً.
مساهمة الطوسي في تطوّر أصول الفقه
لم تكن مساهمة الشيخ الطوسي في الأصول مجرد استمرار للخط وانما كانت تعبر عن تطور جديد كجزء من تطور شامل في التفكير الفقهي والعلمي كله. فكان كتاب «العدة» تعبيراً عن الجانب الأصولي من التطور، بينما كان كتاب «المبسوط» في الفقه تعبيراً عن التطور العظيم في البحث الفقهي على صعيد التطبيق بالشكل الذي يوازي التطور الأصولي على صعيد النظريات.
وقد مثّلت أعمال الشيخ الطوسي فارقاً كيفياً بحيث يعتبر هذا الشيخ حداً فاصلاً بين عصرين من عصور العلم، العصر العلمي التمهيدي والعصر العلمي الكامل، فقد وضع هذا الشيخ الرائد حداً للعصر التمهيدي وبدأ به عصر العلم الذي أصبح الفقه والأصول فيه علماً له دقته وصناعته وذهنيته العلمية الخاصة.
ولتوضيح ذلك التطوّر العظيم الذي أحرزه العلم على يد الشيخ الطوسي، وننقل نصين كتب الشيخ أحدهما في مقدمة كتاب «العدة» وكتب الآخر في مقدمة كتاب «المبسوط».
ففي النص الأول كتب يقول: «سألتم أيّدكم الله إملاء مختصر في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبيل الإيجاز والاختصار على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجيه أصولنا، فإن من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسلك الذي اقتضاه أصولهم ولم يعهد من أصحابانا لأحد في هذا المعنى إلاّ ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله(المفيد) في المختصر الذي له في أصول الفقه ولم يستقصه وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حرّرها، وإن سيدنا الأجل المرتضى – أدام الله علوه – وإن أكثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئاً يرجع إليه ويجعل ظهراً يستند اليه، وقلتم: إن هذا فن من العلم لا بدّ من شدة الاهتمام به، لأن الشريعة كلها مبنية عليه ولا يتم العلم بشيء منها دون إحكام أصولها، ومن لم يحكم أصولها يكون حاكياً ومعتاداً ولا يكون عالماً».
ويعكس هذا النص مدى أهمية العمل الأصولي التأسيسي الذي أنجزه الشيخ الطوسي في كتابه هذا وما حققه من وضع النظريات الأصولية ضمن إطار الإثني عشرية، كما يؤكد أسبقية الشيخ المفيد في التصنيف الأصولي على الصعيد الشيعي.
أما في كتابه الفقهي «المبسوط»، فيقول الطوسي: «إني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستخفون بفقه أصحإبنا الإمامية وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل ويقولون: أنهم أهل حشو ومناقصة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول، لأن جل مذهبنا وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين وهذا جهل منهم بمذهبنا وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه من أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي(ص) إما خصوصاً أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحاً. وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس بل على طريقة توجب علماً يجب العمل عليها ويسوغ المصير إليها من البناء على الأصل وبراءة الذمة وغير ذلك».
ويضيف: «وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع وتشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضاً فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية وذكرت جميع ما رواه أصحإبنا في مصنفاتهم وأصلوه من المسائل وفرقوه في كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه وجمعت بين النظائر ورتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، ولم أتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرها، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حنى لا يستوحشوا من ذلك، وعملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات سلكت فيه طريق الإيجاز والاختصار وعقود الأبواب في ما يتعلق بالعبادات… وهذا الكتاب إذا سهل الله تعالى إتمامه يكون كتاباً لا نظير له في كتب أصحإبنا ولا في كتب المخالفين، لأني إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتاباً واحداً يشتمل على الأصول والفروع مستوفياً مذهبنا، بل كتبهم وان كانت كثيرة فليس يشتمل عليهما كتاب واحد. وأما أصحإبنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليه، بل لهم مختصرات».
ويعتبر هذا النص من النصوص التاريخية التي تتحدث عن المراحل البدائية من تشكّل الفكر الفقهي لدى الإثني عشرية وبدايات تطوره مع الشيخ الطوسي إلى مستوى أعمق. ويبين هذا النص كيف كان علم الفقه يقتصر في الغالب على استعراض المعطيات المباشرة للأحاديث والنصوص، وهي ما سماها الطوسي بأصول المسائل، مما كان يجعل البحث الفقهي أنذاك منكمشاً لا مجال فيه للإبداع والتعمق الواسع النطاق. فكتاب «المبسوط» كان محاولة ناجحة لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضيق المحدود في أصول المسائل إلى نطاق واسع يمارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل والمقارنة بين الأحكام وتطبيق القواعد العامة ويتتبع أحكام مختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات المباشرة للنصوص.
مقاربة الصدر لمساهمة الطوسي
ويذهب آية الله السيد محمد باقر الصدر إلى استخلاص حقيقتين من خلال دراسته لكتابي الطوسي «العدة» و«المبسوط» هما:
«إحداهما أن علم الأصول في الدور العلمي الذي سبق الشيخ الطوسي كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهي الذي كان يقتصر وقتئذ على أصول المسائل والمعطيات المباشرة للنصوص، ولم يكن بإمكان علم الأصول في تلك الفترة أن ينمو نمواً كبيراً، لأن الحاجات المحدودة للبحث الفقهي الذي حصر نفسه في حدود المعطيات المباشرة للنصوص لم تكن تساعد على ذلك فكان من الطبيعي أن ينتظر علم الأصول نمو التفكير واجتيازه تلك المراحل التي كان الشيخ الطوسي يضيق بها ويشكو منها. والحقيقة الأخرى هي أن تطور علم الأصول الذي يمثله الشيخ الطوسي في كتاب العدّة كان يسير في خط موازٍ للتطور العظيم الذي أنجز في تلك الفترة على الصعيد الفقهي. وهذه الموازاة التاريخية بين التطورين تعزز الفكرة التي قلناها سابقاً عن التفاعل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي أي بين بحوث التطبيق الفقهي، فإن الفقيه الذي يشغل في حدود التعبير عن مدلول النص ومعطاه المباشر بنفس عبارته أو بعبارة مرادفة ويعيش قريباً من عصر صدوره من المعصوم، لا يحس بحاجة شديدة إلى قواعد، ولكنه حين يدخل في مرحلة التفريع على النص ودرس التفصيلات وافتراض فروض جديدة لاستخراج حكمها بطريقة ما من النص يجد نفسه بحاجة كبيرة ومتزايدة إلى العناصر والقواعد العامة وتنفتح أمامه آفاق التفكير الأصولي الرحيبة».
إن التطوّر الذي أنجزه الطوسي في الفكر الفقهي كانت له بذور وضعها أستاذاه المفيد والمرتضى وقبلهما إبن أبي عقيل وإبن الجنيد كما ذكرنا سابقاً. لكن هذا الإنجاز الفقهي والأصولي العظيم الذي تحقق مع الطوسي قد توقف عن النمو بعد وفاته لمدة طيلة قرن كامل، وذلك لأسباب عدة أبرزها هي:
1- كان الشيخ الطوسي قد هاجر إلى النجف سنة 448هـ نتيجة الفتن التي ثارت بين الشيعة والسنّة في بغداد حيث كان يحظى بكرسي الكلام في عهد الخليفة القائم بأمر الله، وكان مرجعاً دينياً للشيعة في المدينة بعد وفاة السيد المرتضى(436هـ). وكانت هجرته إلى النجف سبباً لانصرافه إلى البحث العلمي الذي أسفر عن الإنجازات الفقهية والأصولية المذكورة، لكن يلاحظ أنه بهجرته هذه قد انفصل عن معظم تلامذته وحوزته العلمية في بغداد وبدأ ينشىء في النجف حوزة فتية حوله من أولاده والطلاب الآخرين وأبرزهم من أبناء النجف والحلة. وهذا يعني حداثة هذه المدرسة التي أسسها وأكمل دوره التعليمي والقيادي فيها إبنه الحسن بعد وفاته، مما جعلها لا ترقى إلى مستوى التفاعل المبدع مع التطوّر الذي أنجزه الطوسي في الفكر الفقهي لحداثتها. كما لا يبدو أن هذا الإبداع قد تسرب آنذاك إلى الحوزة الأساسية في بغداد كي تتفاعل معه وتواكبه بمواصلة هذا النهج الإبداعي. وكان لا بد أن يشتد عضد الحوزة الفتية في النجف كي يتحقق هذا التفاعل الفكري الخلاق، الأمر الذي دام نحو قرن كامل حيث سادت فترة جمود على مستوى تطور علم أصول الفقه إلى أن تسربت آراء الشيخ الطوسي الخلاقة إلى الحلة.
2- وقد ذهب البعض إلى تفسير ذلك الركود بما حظي به الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته جعله في أنظارهم فوق مستوى النقد وجعل آراءه ونظرياته في الفقه والأصول شيئاً مقدساً لا يمكن أن يناله اعتراض أو نقد أو أن يخضع لأي تمحيص. وأكد الشيخ حسن بن زين الدين إبن الشهيد الثاني نقلاً عن والده أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ الطوسي كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به. وقال الحمصي أحد من عاصروا هذه المرحلة: «لم يبقَ للإمامية مفتٍ على التحقيق بل كلهم حاكٍ».
وبلغ حدّ التقديس للطوسي حديث البعض عن رؤيا للإمام علي بن أبي طالب(ع) شهد فيها بصحة كل ما ذكره الشيخ في كتابه الفقهي «النهاية».( )
3- ويرى البعض أن نموّ الفكر العلمي والأصولي لدى الشيعة لم يكن منفصلاً عن العوامل الخارجية التي كانت تساعد على تنمية الفكر والبحث الأصوليين، ومن بين هذه العوامل عامل نمو البحث الفكري والفقهي السني الذي شكّل حافزاً لعلماء الإثني عشرية وفقهائهم لدراسة هذه البحوث في إطار الردود على الاعتراضات والمسائل التي يثيرها. يقول إبن زهرة في كتابه «الغنية» في معرض شرحه للأغراض المتوخاة من البحث الأصولي: «على أن لنا في الكلام في أصول الفقه غرضاً آخر سوى ما ذكرناه، وهو بيان فساد كثير من مذاهب مخالفينا فيها وكثير من طرقهم إلى تصحيح ما هو صحيح منها وأنه لا يمكنهم تصحيحها وإخراجهم بذلك عن العلم بشيء من فروع الفقه، لأن العلم بالفروع من دون العلم بأصله محال، وهو غرض كبير يدعو إلى العناية بأصول الفقه ويبعث على الاشتغال به».
من هنا فإن التفكير الأصولي السنّي قد بدأ ينضب في القرنين الخامس والسادس للهجرة ويستنفد قدرته على التجديد ويتجه إلى التقليد، حتى أدى ذلك إلى سدّ باب الاجتهاد كلياً، الأمر الذي أفقد التفكير العلمي الشيعي أحد الحوافز المحركة له وساهم في توقف التطور العلمي الأصولي.
يقول الفقيه الإثنا عشري محمد بن إدريس، الذي أدرك نهايات تلك الفترة وكان له دور كبير في مقاومة الجمود العلمي وبعث الحياة من جديد في الفكر الأصولي، في مقدمة كتابه «السرائر»: «إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضييعهم لما يعلمون، رأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة مضيعاً لما استودعته الأيام مقصراً في البحث عما يجب عليه علمه حتى كأنه إبن يومه ومنتج ساعته… ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان وميدانه قد عطل منه الرهان تداركت منه الذماء الباقي وتلافيت نفساً بلغت التراقي».
وهكذا بعد نحو قرن على هذا الجمود دبّت الحياة مجدداً في البحث الفقهي والأصولي الإثني عشري، بينما بقي البحث العلمي السنّي على ركوده، وذلك مرده لأسباب عدة أدت إلى استئناف الفكر العلمي الشيعي نشاطه الفقهي والأصولي دون السنّي، أبرزها أن روح التقليد التي سرت في المدرستين السنية والشيعية في القرن الخامس سادت في المدرسة الإثني عشرية في حينه، لأن الحوزة العلمية في النجف كانت فتية لم تتمكن أن تتفاعل مع مستوى أفكار الطوسي. وكان لا بدّ لها أن تتنتظر فترة من الزمن حتى تستوعب هذه الأفكار وترتفع إلى مستوى التفاعل معها والتأثير فيها.( )
فقهاء ما بعد مرحلة الطوسي
ومن أبرز الفقهاء الذين جاؤوا بعد الطوسي كان سلار الديلمي وحمزة بن عبد العزيز الطبرستاني (ت 448 أو 463 / 1056 أو 1070م). وقد درس سلار على المفيد والمرتضى وصنّف أعمالاً في الكلام والفقه أبرزها كتاب «مراسم الفقه» ويعرف أيضاً بـ«الرسالة». وكان سلار بتأثير من المرتضى بين الفقهاء القدامى الذين لا يرون سلطة شاملة للفقهاء في ممارسة جميع شؤون الشيعة. وهو كان أول فقيه إماميّ يحرِّم صلاة الجمعة في غياب الإمام وإلى السبب نفسه الذي لا يجيز لأحد شغل السلطات الشاملة للإمام التي تتضمن الدعوة إلى صلاة الجمعة وإمامتها، وذلك خلافاً لحكم المفيد والطوسي في هذا الصدد، مما يظهر الاستقلال الفقهي في تطبيقه للمبادئ الفقهية وفي منهج استنباط الأحكام الشرعية.
وكذلك كان هناك القاضي عبد العزيز بن نحرير إبن البراج (ت 481 هـ-1088م) وهو كان فقيهاً شهيراً درس أيضاً في مدرسة بغداد على المفيد والمرتضى والطوسي. وكان ممثلاً للطوسي في سوريا وتولى وظيفة رسمية كقاضي في طرابلس خلال ثلاثين سنة. واستناداً لإبن شهراشوب ولد إبن البراج ونشأ في مصر ثم سافر إلى بغداد حيث درس على الفقهاء. أمّا أبرز كتبه في الفقه فهي «جواهر الفقه»، و«المعجز»، و«الكامل».
وكان هناك عماد الدين محمد بن علي بن محمد إبن حمزة الطوسي الذي توفي في النصف الثاني من القرن السادس الهجري وكان أحد تلامذة إبن الطوسي الشيخ أبو علي، وله كتاب معروف في الفقه اسمه «الوسيلة في الفقه».
وبرز حمزة بن علي الحسيني الحلبي إبن زهرة (ت 588 هـ-1192م) ويعرف أيضاً بـ«إبن المكارم». وكان فقيهاً بارزاً ينتسب إلى عائلة علمية معروفة في حلب. توفي في عمر الـ74 وقد استند إليه إدريس الحلّي في بعض أحكامه الفقهية. له كتاب شامل في الفقه يتضمن آراءه في الأصول وتطبيقاتها في الفروع عنوانه «غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع».
إبن إدريس الحلّي
كانت بداية التجديد العلمي والخروج عن دور التوقف النسبي على يد إبن أحمد إبن إدريس الحلّي المولود نحو عام 534هـ والمتوفى عام (598 هـ)، إذ إليه يعود الفضل في مقاومة الجمود الفقهي وبث الحركة الفكرية من جديد في المعاهد العلمية الشيعية بحيث أخضعت آراء الشيخ الطوسي نفسه للمناقشة والنقد من قبل العلماء.
وكان إبن إدريس زعيماً لمجموعة من فقهاء الإمامية في الحلة، وهي مدينة بين الكوفة وبغداد في العراق، وكانت مركزاً علمياً شيعياً لزمن طويل. وبعد دمار بغداد على أيدي المغول عام ؟؟ أضحت الحلة ملجأ علماء الشيعة وامتداداً لمدرسة بغداد ثم تميّزت لاحقاً كمدرسة قائمة بذاتها. وقد قام فقهاء الحلة بالمساهمة الكبرى الأكثر أهمية في تاريخ الفقه الإمامي بعد مدرسة بغداد.
وإذا كان علماء بغداد قد كتبوا أعمالهم في ظروف سياسية أفضل تحت حماية البويهيين الشيعة، فإن علماء الحلة كانوا يكتبون في ظل ظروف متوترة تحت حكم السلاجقة في القرن السادس هجري (الحادي عشر ميلادي) حيث كانت ثمة حالة عداء بين الشيعة والسنّة آنذاك. وقد انعكس هذا الأمر في آرائهم التي بدت أنها جاءت ضرورة التقيّة وإخفاء العقيدة الحقيقية في بعض المسائل السياسية.
وقد كتب إبن إدريس كتاباً مهماً للغاية في الفقه عنوانه «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى»، وتكمن أهميته في استقلاله العقلي في استنباط الآراء في مسائل مهمة عدة تتعلق بمفهوم «السلطان العادل»، حيث برز اسم إبن إدريس إلى جانب سلار الديلمي في معارضته للسلطة الشاملة للفقيه الإمامي بما فيها الممارسة الدستورية نيابة عن الإمام الغائب في ظل غيبته.
وعرف إبن إدريس في تبحّره في استدلالاته بالقواعد الأصولية وابتناء الفروع على الأصول في كثير من مباحثه العلمية. وقد عبّر كتابه «السرائر» عن بلوغ الفكر العلمي مستوى التفاعل مع أفكار الطوسي ونقدها وتمحيصها. بل إن إبن إدريس قد أبرز في كتابه العناصر الأصولية في البحث الفقهي وعلاقتها به بصورة أوسع مما قام به الطوسي في كتاب «المبسوط». كما أن الاستدلال الفقهي لدى إبن إدريس أوسع من مثيله في «المبسوط» فهو يشتمل في النقاط التي يختلف فيها مع الطوسي على توسع في الاحتجاج وتجميع الشواهد بعد عرضه لوجهة نظر الطوسي وتفنيدها. كما عكس في محاججاته مقاومة الفكر التقليدي السائد لآرائه الجديدة المخالفة لآراء الشيخ الطوسيٍ إذ كان يقوم بجمع حجج المدافعين وتفنيدها، الأمر الذي أثار ردود فعل ومناقشات أعطت دفعاً للحركة العلمية لدى الإمامية آنذاك ومنها مراسلاته مع أبي المكارم بن زهرة الحلبي.
ويعاصر كتاب إبن إدريس تقريباً كتاب «الغنية» لإبن الزهرة الحلبي، والذي قام به في دراسة مستقلة لعلم الأصول. ولذلك نجد ظاهرة مشتركة بين العالمين هو خروجهما عن التقليد المطلق للشيخ الطوسي ومحاولة تفنيد آرائه الفقهية. وهذا يعني أن الفكر العلمي الشيعي كان قد شهد نمواً واتساعاً بكلا جناحيه الأصولي والفقهي.
ومن آراء إبن إدريس التي اشتهر بها عدم حجيّة أخبار الآحاد كما ذهب إلى ذلك قبله المرتضى، إلا إذا كان الخبر متواتراً أو محفوفاً بالقرائن التي تؤكد صدوره عن المعصوم.
وكان علماء الحلة قد قاموا بتطوير منهجية جديدة في استنباط الأحكام. وكتب إبن إدريس في كتابه «السرائر» مقدمة طويلة عن المنهجية تضمّنت شرحاً مفصلاً عن كيفية ومتى يمكن قبول أخبار الآحاد.
المحقق الحلّي
وصلت عملية ايجاد الوسائل العلمية لتأليف الأعمال الفقهية إلى ذروتها في فقه المحقق الأول الحلّي وتلميذه الشهير العلاّمة الحلّي. واستمرّ هذا النمو والاتساع بعد إبن إدريس وبرز مجددون كبار في الأصول والفقه أبرزهم المحقق نجم الدين جعفر بن حسين بن يحيى الحلّي(ت 676هـ-1277م). وهو تلميذ تلامذة إبن إدريس، وهو مؤلف أهم كتاب فقهي لدى الإمامية هو «شرائع الإسلام»، الذي أصبح محوراً للبحث والتعليق والتدريس في الحوزة الدينية إلى يومنا هذا، بدلاً من كتاب «النهاية» الذي كان الشيخ الطوسي قد ألفه قبل كتاب «المبسوط». ويضع كتاب «شرائع الإسلام» نهاية للخط الفقهي للفقهاء القدامى. ويرمز هذا التحول من «النهاية» إلى «الشرائع» إلى تطوّر كبير في مستوى العلم لأن «النهاية» كان كتاباً فقهياً يشتمل على أمهات المسائل الفقهية وأصولها. أما «الشرائع» فهو كتاب واسع يشتمل على التفريع وتخريج الأحكام، وفقاً للمخطط الذي وضعه الطوسي في «المبسوط». وذلك معناه أن حركة البحث والتخريج قد عمت واتسعت حتى أصبحت الحوزة كلها تعيشها.
ونوعية هذا الكتاب هي التي منحته لقب المحقق. كما صنف المحقق الحلّي كتباً في الأصول منها كتاب «نهج الوصول إلى معرفة الأصول»، وكتاب «المعارج». وكان بين تلامذة المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي.
ويذكر إبن فهد الحلّي في تعليقه على كتاب «المختصر النافع» في أصول الفقه كيف ألّف المحقق الحلّي لنصير الدين الطوسي رسالة في كيفية حل مشكلة التحديد الصحيح لاتجاه المصلين في العراق نحو القبلة (الكعبة المشرفة).
وتكمن فرادة المحقق الحلّي في المنهجية الفقهية في أنه أول من قدم تحقيقاً على الشكل الذي اتّخذه فقهاء الإثني عشرية اللاحقون. فقد راجع الأعمال السابقة وطرح أسئلة مهمة لم تكن مدرجة ومنظمة في كتب القدامى، وأورد في كتابه خلاصة كتاب «النهاية» للطوسي المستند على أحاديث الإمامية، والذي يتضمّن أجزاء من كتابي الطوسي الآخرين «المبسوط» و«الخلاف» اللذين يتضمنان آراء لفقهاء سنّة. كما قام بتقديم نقدي لكتاب «السرائر» لإبن إدريس وغيره من الفقهاء الذين سبقوه.
وقد صنّف المحقق أعمالاً عدّة في الفقه والأصول نالت شهرة واسعة ساهمت في تطوّر الفقه الإثني عشري. وتمنح التعليقات على كتابه «الشرائع» الباحث فرصة ممتازة لإدراك تطوّر آراء الفقهاء المتأخرين إذ لم يحظَ عمل فقهي إمامي تعليقات وشروحاً كما حظي به هذا الكتاب بحسب قول أغابزرك الطهراني في كتابه «الذريعة إلى تصانيف الشيعة». وأبرز هذه الشروح إثنان هما: «المسالك» للشهيد الثاني و«الجواهر» للنجفي حيث نوقشت فيهما آراء المحقق بشأن «السلطان العادل» ومسألة أدلة ولاية الفقيه بتفصيل كبير.
وتجب الإشارة إلى أنّ آراء المحقق في ولاية الفقيه والسلطان العادل تعكس أحياناً فترة السلام النسبي بين الشيعة والسنّة خلال حكم الإيلخانيين. وكان من أبرز عوامل تنفيس الاحتقان بين الجماعتين آنذاك هو موقف المغول المعادي للخلافة الإسلامية السنّية التي كانت متمثلة في تلك الفترة بالمماليك في مصر والخلافة العباسية في بغداد.
العلاّمة الحلّي
ومن أولئك النوابغ الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر(648-627هـ)، وهو تلميذ المحقق وإبن أخته، المعروف بالعلاّمة الحلّي، وله كتب عديدة في الأصول أبرزها: «تهذيب الوصول إلى علم الأصول» و«مبادىء الوصول إلى علم الأصول». وكان أبرز فقيه إثني عشري في القرن الثامن هجري (الرابع عشر الميلادي). وتعد مساهمته شبيهة بمساهمة الطوسي في الفقه الإثني عشري في نهاية المرحلة التقليدية القديمة.
درس العلاّمة الحلّي الفقه والأصول على المحقق الحلّي ودرس العلوم العقلية الفلسفية على الخواجة نصير الدين الطوسي. وقد أتاحت له هذه الخلفية العلمية الفقهية والفلسفية تصنيف رسائل عديدة في معظم فروع العلوم الإسلامية.
وعلى غرار الطوسي، أثبت العلاّمة الحلّي عبقريته من خلال إقامته توازناً بين سلطة النص وسلطة العقل في أعماله. فقد نظر إلى الحديث كشكل مهم من التفكير العقلي وخصوصاً لأنه كان معروفاً أن ليست كل الأحاديث المدوّنة في العصور الإسلامية المبكرة مسندة ومتصلة بالمعصومين.
وتعود موسوعة العلاّمة الحلّي الفقهية إلى كتابيه «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» و«تذكرة الفقهاء». ويعرض في «المختلف» بالتفصيل الخلافات بين الفقهاء الشيعة وطرق حل هذه الخلافات أو على الأقل تقليصها من خلال إعادة تفسير النصوص. أما «التذكرة» فهو دراسة مقارنة مفصلة لجميع مدارس الفقه الإسلامي. ويمتاز العلاّمة الحلّي بأنه كان بداية انتهاج فقهاء الإثني عشرية خط «المتأخرين» الذي استمرّ إلى الوقت الحاضر.
فخر المحققين الحلّي
محمد بن الحسن بن يوسف إبن العلاّمة الحلّي الملقب بفخر المحققين (ت 771هـ-1369م)، ويكمن دوره في مواصلة عمل والده في الحلة بعد هجرة الأخير إلى إيران نحو (705هـ-1305م). فقد أكمل بعض كتب والده غير المنجزة في الفقه وكتب تعليقه على كتاب «القواعد» سمّاه «إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد». كما واصل تقليد مدرسة الحلة في تخريج الأعلام الكبار في الفقه الإمامي مثل الشهيد الأول.
الشهيد الأول
هو الشيخ جمال الدين مكي بن شمس الدين الدمشقي (العاملي) الجزيني (ت786هـ-1384م)، ولد الشهيد الأول عام 734هـ في بلدة جزين في جبل عامل وهاجر إلى الحلة لطلب العلم، وحصل وهو في السابعة عشرة من عمره على إجازة أستاذه فخر المحققين بأن يروي عنه، في شعبان 751هـ، وذلك بعد مدّة من الدراسة على فخر المحققين وأساتذة آخرين من تلامذة العلاّمة الحلّي.
وكان الشهيد الأول يتابع في أفكاره العلمية في الفقه والأصول مدرسة الحلة وكانت مدرسته تعود في أصولها وجذورها إلى أستاذه فخر المحققين ووالده العلاّمة الحلّي. وتميّز بانفتاحه الفكري والعلمي على أهل السنّة فكان يخالط علماءهم ويُباحثهم ويستجيزهم في نقل أحاديثهم حيث سافر إلى كثير من مراكزهم العلمية والتقى علماءهم في سوريا والعراق وفلسطين ومصر ومكة والمدينة. ويُعبّر كتابه «اللمعة الدمشقية»، وهو رسالة في الفقه كتبها بناءً على طلب إبن المؤيد كدليل لشيعة طبرستان، عن العلاقة بين الحاكم الشيعي والشهيد الأول التي انعكست في فتاواه الفقهية. كما بقي الكتاب نصاً أساسياً لكل من يريد أن يكون فقهياً إمامياً.
ولعلّ أحد مميّزات الفقه الإمامي الذي وضع في جبل عامل هو غياب الجدال مع المدارس الفقهية الإسلامية الأخرى، إذ كانت رغبة الشهيد الأول ليست تعلّم الفقه السنّي فحسب وإنّما كذلك تعليمه، وهو ما يعكس انفتاحه وتوجّهه نحو الوحدة الإسلامية. ولذلك رفض دعوة إبن المؤيد للإقامة في خراسان واختار الإقامة في دمشق حيث كان الحكم سنّياً والمدارس الإسلامية المتعددة سنّية. وقام الشهيد الأول بتقديم النصح للحكم السنّي في مسائل عدّة. وكانت له رؤية في جواز إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، تظهر بوضوح فهمه لأهمية هذه الصلاة في الحياة السياسية للمسلمين.( )
ومن أبرز آثاره العلمية «اللمعة الدمشقية» التي كتبها في ستّة أيام ولم يحضره من المراجع والكتب الفقهية خلال كتابته سوى كتاب «مختصر النافع» للمحقق الحلّي وكتاب البيان وكتاب «غاية المراد في شرح نكت الاعتقاد».
وهو من بين الفقهاء الذين درسوا الفقه والفلسفة على فخر المحققين وعلماء آخرين كانوا الأكثر علماً وثقافة شمولية في عصره، شملت دراساته علوم التصوف واللغة العربية والبيان. وقد أقام الشهيد الأول في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبغداد والقاهرة والقدس والخليل لدراسة الفقه والحديث السنيين على كبار العلماء السنّة.
له إجازة في الفقه من فخر المحققين ذكرها في كتابه «القواعد» وهو لم يتجاوز بعد السابعة عشرة من عمره، وله أعمال عديدة في الفقه، وآراء مهمة في مسألة ولاية الفقيه والسلطان العادل. كما كانت له صلات بالحكم الشيعي في طبرستان في خراسان (738-783هـ/ 1337-1381م) حيث كان إبن المؤيد وهو الحاكم (منذ 766هـ حتى وفاته 795هـ) (1364-1392م) ونظر إليه الشهيد الأول كسلطان عادل. أُعدِم الشهيد الأول في دمشق عام 786هـ.
ومن أبرز تلامذة الشهيد الأول أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلّي (ت 841هـ ـ 1437م) الذي أجاز له تدريس أعماله، والفاضل المقداد السيوري (ت 826هـ-1422م)، وهو عالم مشهور له مؤلفات عدة أبرزها كتاب «كنز العرفان في فقه القرآن» وهو كتاب مهم وفريد يشرح النصوص الفقهية التشريعية الواردة في القرآن الكريم. وكتب رسالة لأحد تلامذته ويدعى السيد محمد بن الموسوي (ت 870هـ-1495م) استشرف فيها ظهور الشاه اسماعيل الصفوي وطلب إطاعته بقوله: «هذا السلطان سيظهر بالحقيقة والنصر».
وأهم أعماله في الفقه الإمامي هو شرحه لكتاب المحقق الحلّي «المختصر النافع» والذي عنونه «المهذب الباري إلى شرح النافع»، وفي هذا الكتاب يعرض إبن فهد الآراء الخلافية بين الفقهاء ويعلق عليها من خلال إظهار أخطاء بعض الأحكام في مسألة ما، ويذكر الرأي الثابت المسند. ولعل أهم اجتهادات إبن فهد هو استدلاله بشأن موقع الفقيه في المجتمع حيث اعتبر أنّ الفقيه الإمامي هو الإمام الفعلي في عصر الغيبة، أي القول بولاية الفقيه.
المحقق الكركي
من أبرز من ارتبط بإبن فهد المحقّق الكركي المعروف أيضاً بالمحقق الثاني. واسمه علي بن عبد العال (توفي 937هـ أو 941هـ/1530 أو 1534م). اشتهر الكركي بأنّه الفقيه الإمامي الذي شهد ظهور السلطان الشيعي الشاه اسماعيل الصفوي عام 907هـ /1501م، ومن ثم ترسيخ الدولة الإمامية في إيران خلال حكم الشاه طهماسب (930-948هـ/1524- 1576م). وينظر إلى هذه المرحلة من التاريخ الصفوي بأنها مرحلة ترسيخ التشيّع في إيران، حيث توافرت للفقهاء مثل الكركي الحماية وتعزّزت مكانتهم الخاصة لدى الشعب من جهة، وتعمّقت دروسهم ومعارفهم من جهة أخرى.
ويتمثّل دور الكركي في حكمه في مسألة السلطان العادل ودوره في تعزيز سلطة الفقيه، إضافة إلى المسائل السياسية-الاجتماعية الأخرى، وهي شكّلت مستوى لا سابق له من الاجتهاد القائم على (الآراء المبكرة) في الفقه السياسي لدى الإمامية. ويعود اجتهاد الكركي هذا جزئياً إلى دراسته على علماء جبل عامل فهو- على غرار الشهيد الأول والشهيد الثاني-نال معرفة قانونية وإدارية واسعة عبر الدراسة في مراكز التعليم السنّي المختلفة قبل ذهابه إلى العراق ثم الهجرة إلى إيران.
ويتضمّن شرح الكركي لكتاب «القواعد» للعلاّمة الحلّي المعنون «جامع المقاصد في شرح القواعد» آراء تعكس خبرته السياسية الخاصة في إدارة الدولة الإمامية كمجتهد أول معيّن من قبل الشاه طمهسب إلى جانب تعزيز موقع التشيّع خلال حكم الصفويين، إن لجهة الفقه الإمامي وخصوصاً في جانبه السياسي إذ طرحت مسألة ممارسة السلطة ونيابة الإمام في سلطته المطلقة حيث بلغت في هذه المرحلة الذروة في المأسسة النهائية للسلطة الشاملة للفقيه في الفترات الحديثة. فقد انتقل الفقه الإثنا عشري من مرحلة التقيّة التي ترسّخت حتى في عهد السلاطين البويهيين الشيعة إلى إقامة الدولة الصفوية التي خلالها بدا للمرة الأولى أنه من الممكن أن يصبح الفقيه «سلطاناً عادلاً» وهو ما تضمّن بشكل محض في أعمال الفقهاء (القدامى) الذين أفتوا بجواز ممارسة الفقيه الإمامي للسلطة الفعلية.
وتعكس الفتاوى الشرعية للكركي، وغيره من الفقهاء الصفويين بشكل واضح، تأسيساً فقهياً ونظرياً لولاية الفقيه في إطار الدولة الشيعية من خلال صلاحيات الفقيه، كنائب للإمام المعصوم الغائب، وهو ما سنعرضه لاحقاً بالتفصيل في بحثنا عن تطور الفقه السياسي الشيعي من الولاية الخاصة للفقيه في الأمور الحسبية إلى الولاية العامة للفقيه.
الشهيد الثاني
انتقلت آراء وأفكار مدرسة الحلة في الفقه الإمامي من تلامذة العلاّمة الحلّي إلى تلامذة تلامذته إلى أن وصلت إلى الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجباعي العاملي الذي ولد عام 911هـ في بيت علمي في جبل عامل وأعدم في اسطنبول (عام 966هـ- 1588م). ودرس الشهيد الثاني على والده اللغة العربية والفقه وانتقل إلى بلدة ميس الجبل (في جنوب لبنان) ليكمل دراسته فحضر هناك دروس المحقق الكركي من سنة 925هـ إلى 933هـ، ثم انتقل إلى بلدة كرك نوح (قرب زحلة في البقاع) التي كان يقيم بها الشيخ علي الميسي أحد العلماء البارزين في حينه.
يقول إبن العودي عنه: «أخبرني ـ قدّس الله سره-وكان في منزلي بجزين متخفياً من الأعداء ليلة الإثنين 11 صفر 956هـ أنّ ابتداء أمره في الاجتهاد كان سنة 944هـ، وأن ظهور اجتهاده وشهرته كان في سنة 948هـ، فيكون عمره لما اجتهد 33 سنة».
وقد درس الفلسفة في القاهرة على الشيخ علي الجيلاني والشيخ شمس الدين محمد بن مكي وهو ينتمي إلى فلسفة السهروردي الإشراقية. وساهم الشهيد الثاني في تطوّر الفقه الإثني عشري في نواح عدة على غرار الشهيد الأول وواصل إقامة الصلات الإجتماعية الجيدة مع جميع مذاهب أهل السنّة المختلفة، ودراسة أعمالهم الكبيرة وتعليمها بقراءاته المقارنة. كما كتب شرحاً مطولاً لكتاب «اللمعة الدمشقية» للشهيد الأول سماه «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، وهو شرح مزجي استدلالي مع اختصار وإيجاز شامل، ومستوعب لجميع أبواب الفقه. وقد احتلّ الكتاب مكانة مرموقة بين الكتب الفقهية التي يدرسها الطلاب الدينيون في المعاهد العلمية الشيعية إلى اليوم. وللشهيد الثاني مصنفات عدة أبرزها: كتاب «مسالك الإفهام» في شرح كتاب «الشرائع» للمحقق الحلّي.
يذكر المؤرخون أنّ جماعة من خصوم الشهيد الثاني قد وشوا به إلى الدولة العثمانية بتهمة الاجتهاد وتدريس كتب الإمامية وإشاعة التشيّع فتمّ اعتقاله في مكة وأُرسل إلى اسطنبول حيث تمّ إعدامه في سنة 965هـ أو 966هـ (1588م).
تجدر الإشارة إلى أن الاجتهادات الفقهية للعلاّمة الحلّي والمحقق الكركي والشهيدين الأول والثاني قد عبّدت طريق الفقه السياسي الإثني عشري الذي نعرفه في الوقت الراهن.
الشيخ البهائي
محمد بن الحسن بهاء الدين العاملي، المعروف بالشيخ أو العلاّمة البهائي، هو من كبار علماء الدين الذين كانت لهم مساهمة في التأليف في علم الأصول. ولد في بعلبك سنة 953هـ ودرس على أبيه ثم جال معه في بلاد العجم (إيران) حيث درس لدى أعلام كلّ فن حتى أصبح عالماً في كلّ فنون الإسلام ومعظم الفنون الأخرى. له تصانيف في العلوم والفنون المختلفة، أبرزها «زبدة الأصول في أصول الفقه» وله كتاب «الكشكول» في النوادر والأشعار والحكم. توفي سنة 1031هـ.
صاحب المعالم
ترك الشهيد الثاني ولداً أصبح أحد أعلام الشيعة من بعده وكان له دور عظيم في تطور علم الأصول. هو أبو المنصور الحسن بن زين العابدين العاملي المعروف بـ«صاحب المعالم»، أي كتاب «معالم الدين وملاذ المجتهدين». ولد عام 959هـ. وبعدما أكمل دروسه الابتدائية والمقدّمات اللازمة في بلدته جباع، توجّه إلى العراق وأقام في النجف ودرس هناك الفقه والأصول فحضر درس المولى المحقق الأردبيلي زعيم الحوزة آنذاك، كما ساعد أستاذه الأردبيلي في مراجعة مخطوطة كتابه «شرح الاعتقاد». وبعدما أكمل دروسه عاد إلى جباع فاستقر فيها حتى وفاته عام 1011هـ. وتحتل مؤلفاته على غرار والده مكان الصدارة بين مؤلفات الإمامية التي تدرس في الحوزات العلمية. وأبرزها كتاب «المعالم» الذي يعتبر من أشهر تصانيفه، وله شروح كثيرة باللغتين العربية والفارسية.
وقد استمر النمو العلمي في البحث الأصولي في عصره في القرن العاشر هجري وكان هو الممثل الأساسي له، إذ عكس فيه المستوى العالي لهذا العلم في عصره بتعبير يسير وتنظيم جديد، الأمر الذي جعل كتابه ذا شأن في مجال البحوث الأصولية حتى أصبح كتاباً دراسياً وتناوله اللاحقون بالتعليق والنقد والشرح. ويقارن هذا الكتاب من الناحية الزمنية بكتاب «زبدة الأصول» الذي وضعه الشيخ البهائي (ت1031هـ) أحد أبرز أعلام القرن الحادي عشر.
ولكن علم الأصول مُنيَ بعد صاحب المعالم بصدمة كبيرة أوقفت نموه وعرضته لحملة شديدة تمثلت في ظهور الحركة الأخبارية في أوائل القرن الحادي عشر على يد الميرزا محمد أمين الأسترابادي(1201هـ) واستفحال هذه الحركة في أواخر القرن الحادي عشر واستمرارها إلى القرن الثاني عشر هجري. وهو ما سنتعرّض له بالتفصيل في الفصل المقبل.
النص فصل من كتاب “تطور المرجعية الشيعية من الغيبة إلى ولاية الفقيه” الصادر حديثاً عن دار المحجة البيضاء في بيروت.