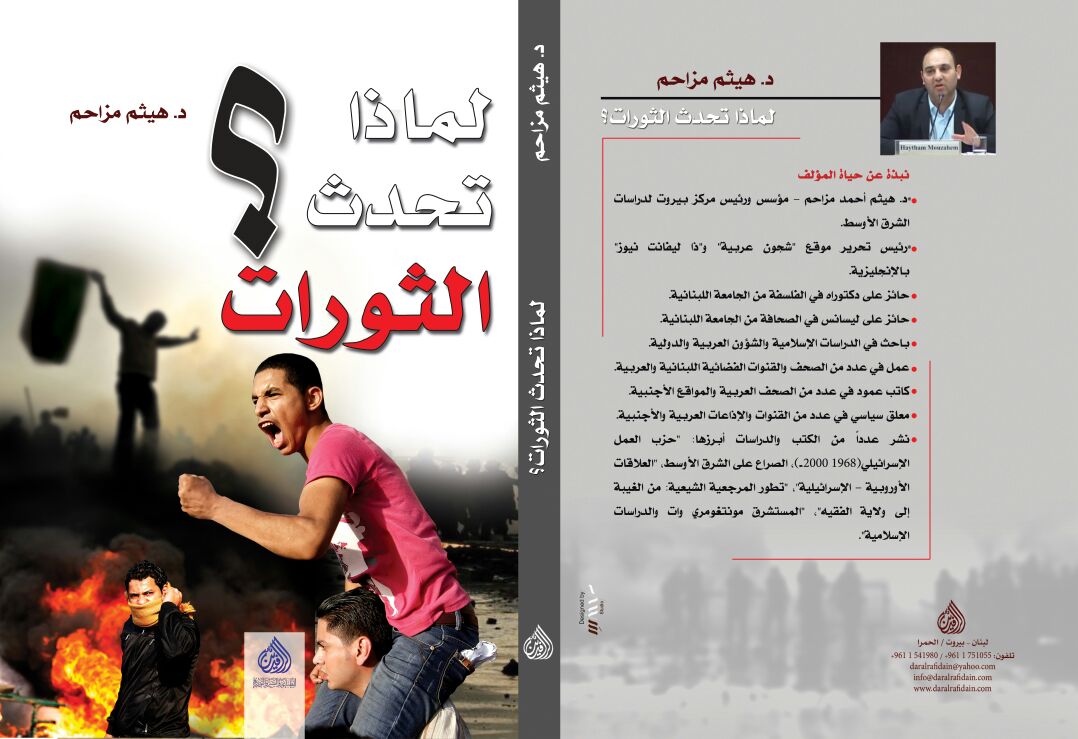المدينة العظمى عند الريحاني

بقلم: د. خنجر حمية – باحث في الفكر والفلسلفة والإسلاميات وأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية–
1- الدولة ــ المدينة كيوتوبيا مثالية:
كانت التصورات المثالية حول الدولة ــ المدينة في الأغلب، ردّة فعل على المظالم التي عرفها البشر في مدى تاريخهم، وعلى المآسي التي عصبت باجتماعهم مذ ولدت حاجاتُهم المتنوعة فكرة التساند عبر العيش معاً في اجتماع موحد… ولقد كان يدفعهم في العموم يأسهم من بلوغ السعادة، التي يرجون، إلى البحث عن صورة اجتماع مثالي في مكان ما كان في الحقيقة عالماً خيالياً، أعني كان مجرد يوتوبيا، يرسمون من خلاله صورة عالم يحلمون به وينشدون العيش فيه.. هكذا عرفت مجتمعات البشر على تنوعها، المدينة ــ المثال، التي راح مصلحون وفلاسفة ومفكرون وسياسيون حالمون، يرسمون ملامحها مقتنعين أن الزمن سوف يجود يوماً بمثلها، وأن طموح البشر إلى السعادة، سوف يمكنهم يوماً من بلوغها والتنعم بالعيش في أكنافها([1])..
لقد كانت تصورات البشر عن المدينة الفاضلة في جزء منها ثورية وتقدمية، رامت في خطوطها الكبرى، وضع حد لشرور العالم، وتحقيق أسمى مراتب العدالة بين البشر، وتحقيق الخير في أسمى صوره… وسوف نشعر الآن بشيء من الغاية عندما نقرأ عن المدن المثالية وأنه كيف تسنى للبشر في مراحل سابقة بلوغ تلك الرؤى التي دونها مفكرون لعالم خالٍ من الشر، يحقق فيه البشر أمانيهم.. ويجدون فيه السعادة التي ينشدون.. لقد دافع زينون مثلاً عن نزعة كونية تستند إلى الأخوة الإنسانية، وعرف أفلاطون شكلاً من أشكال المساواة بين الرجل والمرأة، ونظر توماس مور للعلاقة الجذرية بين الفقر والجريمة وسوف تجد فكرة التكامل الإنساني بوصفها حقيقة عند الرواقيين والكلبيين،.. وغيرها من الأفكار التي كانت مفهومة في حينها بالرغم من أنها لم تجد القبول الذي تستحق.. وقبل أن تتهاوى اليوتوبيات تحت وطأة الروح الموضوعية لعصرنا، كانت الأفكار المثالية فيما يتصل بالدولة ــ المدينة، قد ازدهرت وازدادت ثراءً، حيث يمكن أن تثير فينا الشك في شرعية أو أهمية مزاعمنا حول ما أنجزناه في عصرنا من تقدم اجتماعي أو تطور سياسي.
لكن هذا الجانب الثوري من اليوتوبيا التقليدية، والذي يتم إبرازه على الدوام لبيان عظمة ما قدمه العقل البشري في سياق تصوره للسعادة وللخير، كان يقترن دوماً بأفكار رجعية ظلامية، وبرؤى شمولية سكونية للمجتمع البشري، وللإنسان. كان هؤلاء ثوريين حين دافعوا عن مشاعية السلع عندما كانت الملكية الفردية الخاصة مقدسة، وكانوا ثوريين عندما دافعوا عن حق كل إنسان بالحصول على لقمة العيش عندما كان المتسولون يشنقون في الساحات العامة، وكانوا ثوريين عندما دافعوا عن المساواة بين الرجل والمرأة في عصور كانت تعتبر فيها المرأة أفضل قليلاً من العبيد، وعن كرامة العمل اليدوي الذي كان في فترات من الزمن مخزياً ومهيناً، وعن حق كل طفل في السعادة والتعلم عندما كان ذلك حكراً على أبناء الأغنياء والنبلاء ولأجل ذلك اقترنت اليوتوبيا بالسعادة، ومثَّلت حلم البشر بالهناء والأمن والحرية. لكن مثل هذا الحلم كانت له جوانبه المظلمة، إذا بالرغم مثلاً من التبصرات العميقة لليوتوبيين فيما يتصل بالفضيلة كان ما يزال هناك عبيد في جمهورية أفلاطون وفي يوتوبيا مور، وعرفت إسبرطة جرائم قتل جماعية للعبيد، وإجراءات صارمة وتعصب ديني. ([2])
لقد عرف تاريخنا اتجاهان رئيسيان في الفكر اليوتوبي، الأول يرى السعادة في الرفاهية المادية، وإلغاء فردية الفرد في المجموع، في جسد المجتمع وكيان الدولة، والآخر كان يتطلب درجة معينة من الرفاه المادي، لكنه اعتبر السعادة نتيجة طبيعية للتعبير الحر عن الشخصية، وهو شيء لا ينبغي بحال التفريط به تحت ذريعة أي قانون أخلاقي استبدادي، أو فداء لمجد دولة كليانية شمولية سكونية. ولقد راح كل اتجاه من هذين الاتجاهين بطابق تصوراته مع تصورات خاصة للتقدم ما زالت تعيش إلى أيامنا، لكن الاتجاه الأول بقدر ما كان تقدمياً مثلاً حينما أراد إلغاء عدم المساواة الاقتصادية بقدر ما كان رجعياً حين استبدل بنظام العبودية الاقتصادية القديم، نظاماً آخر أشد قسوة، جعل من الناس عبيداً للدولة أو للأمة ــ بدل أن يكونوا عبيداً لأسيادهم أو لأصحاب العمل التي قامت سلطتها على قوة الأخلاق، كما نرى مثلاً عند أفلاطون، أو على الدين كما نرى في مدينة المسيحيين لأندريا، أو على ملكية وسائل الإنتاج والتوزيع كما هو الحال في أغلب يوتوبيات القرن التاسع عشر.. وتبقى النتيجة واحدة، وهي أن على الإنسان أن يتبع مجموعة من القوانين والقواعد المصطنعة التي منح اليتوتوبيون أنفسهم حق تنظيم الحياة على أساسها، وحق تصنيف البشر إلى طبقات استناداً إليها… وحق إدارة المجتمع من خلالها وفق آلية سكونية ثابتة لا تتغير.
فها هو توماس كامبيلا يتخيل نفسه الميتافيزيقي الكبير في مدينة الشمس، وبَيُكون يجعل من نفسه الأب الروحي لبيت سليمان، والمشرع في جزيرته إيكاريا، وها هو توماس مور يتخيل نفسه عظيماً يرفع رأسه عالياً كحاكم أعلى لمدينته، يختال في مشيته وعلى رأسه تاج من سيقان الذرة، لابساً عباءة راهب فرنسسكاني، حاملاً بيده سنبلة شعير أشبه بصولجان.
ولقد افترض كتاب اليوتوبيا هؤلاء أن قوانين ممالكهم هي قوانين الطبيعة، مع أنها لم تكن سوى قوانين مصطنعة اعتباطية.. وبدل أن يكشف هؤلاء قوانين الطبيعة نفسها على ما هي عليه، اخترعوها، أو عثروا عليها في سجلات الحكمة القديمة.. كما وجدها موروللي مثلاً في قوانين أسبرطة وبدل أن يقيم هؤلاء مدنهم على بشر يعرفونهم أقاموها على تصورات مجردة.. إن البشر اليوتوبيين مخلوقات على نمط واحد، ولهم رغبات متماثلة وردود أفعال متشابهة، وهم مجردون من العواطف والانفعالات.. يتوحدون في الملبس والمأكل وجداول المواعيد، وفي السلوك الأخلاقي والاهتمامات العقلية.. إنهم أبنية صحيحة، لكنهم بلا شخصية، منشآت متجانسة وكاملة، وحشود يتمتعون بالسعادة، لكنهم بلا حرية.
إن اليوتوبيات كيانات مصطنعة، الأمة الموحدة يناظرها بلد موحد، والعشق التسلطي للتجانس يدفع اليوتوبيين إلى أن يطمسوا الأشياء والجبال يتخيلون جزراً كاملة الاستدارة، وأنهاراً مستقيمة الجريان. وكلُ دولة يوتوبية تتمتع بالكمال، لذا فهي لا تقبل الإصلاح ولا التغيير ولا الإضافة.
مثل هذا السحق لشخصية البشر اتخذ في الغالب صفة الشمول، فالمشرع هو الذي يخطط المدن والمنازل والطرقات، وهي أعدت وفق أكثر المبادئ عقلانية وأفضلها معرفة بالتقنية.. لكنها كانت تفتقر في الواقع إلى تجسيد روح أولئك الذين بنوها.
والدولة اليوتوبية أكثر شراسة في قمعها للفن، الذي لا بد أن يكون في خدمة الدولة.. لقد طرد أفلاطون الشعراء من مدينته، فبدت نموذجاً مضللاً لكمال ربما حققه بعض المستبدين في الواقع، لكنها لم تؤد وظيفتها إلا كآلة.. إن الفرق بين المجتمع تقدمي عضوي ومجتمع سكوني شمولي لا يتبدى إلا في الفن، الذي به يتجسد على وجه الدقة مثال الحرية والتطور العقلي، وهو الذي يجعل الحياة بنظرنا شيئاً يستحق أن نحياه.
ليست المشكلة على وجه الدقة في اليوتوبيا، المشكلة إنما هي في تبديها على شكل نسق أو في تحويلها إلى نظام كلي شمولي ثابت يدعي الكمال. وهي حينما تشير إلى الحياة المثالية كحقيقة، كشيء نطمح إليه كنموذج، من غير أن تتحول إلى خطط، أو إلى آلة مجردة من الحياة تطبق على مادة حية، عندها فقط تستطيع بجدارة أن تصبح المثال الواقعي للتقدم.
2- أفلاطون وجمهوريته:
كان لأساطير العصر اليوناني الذهبي، ولتصورات الدول المثالية فيه، الخاصة بالماضي الأسطوري، أو المستقبل البعيد، وللتأملات الفلسفية المثالية حول الحكم، تأثير عميق على التفكير المتصل بالمجتمع وأنظمة الحكم المثالية، وعلى مؤسسي الدول.. من توماس مور حتى ولز([3]).
وبالرغم من العناصر التاريخية التي احتوتها مثل هذه التصورات، والأحداث الواقعية التي حفلت بها، فلقد بقيت مجرد يوتوبيات، ترسم ملامح مجتمع مثالي غاية في التناسق والإحكام… كشفت الوقائع والأحداث صعوبة تحققه في التاريخ، وعجزه عن استيعاب تقلبات الوقائع، وتعقد الحاجات، وتشابك الرغبات والأماني…
كان أفلاطون([4]) أعظم منظري اليونان في السياق، ترك وراءه أعمالاً كثيرة، تتضمن أشكالاً مختلفة من الرؤى اليوتوبية، فطيماوس وكريتياس تصفان مجتمعات أسطورية ودولاً ومدناً مثالية، والجمهورية تضع أسسٍ مدينة للمستقبل، والقوانين تنظر لمجتمع يتجاوزها في الأفضلية والانسجام. ومثله قدم أرسطو نسقاً دستورياً مثالياً لدولة فاضلة، ووصفاً للمؤسسات التي حكمت العديد من المدن اليونانية. وديدروس الصقلي رسم لنا صورة وافية تاريخية لمجتمعات مبكرة ولأساطير من العصر الذهبي، أما زينون فمنحنا تخطيطاً عاماً لجمهورية مثالية ودراسة مستوعبة لنظام الحكم، وعند بلوتارك سنجد وصفاً شديد الدقة للمجتمع القديم في كريت وأسبرطة، لكن سوف تبقى أقرب الأعمال من تعريف الدولة المثالية، وأعظمها تأثيراً في كل المثاليات اللاحقة جمهورية أفلاطون، التي امتزج تأثيرها لزمن بأفكار أرسطو ــ كما سنرى عند الفارابي ــ الإصلاحية والبرجوازية الصغيرة، وبأفكار زينون العالمية والمتحررة.
كانت الفترة التي كتب فيها أفلاطون جمهوريته فترة تدهور في التاريخ اليوناني، فلقد انتهت الحرب البلوبونيزية (431-404 ق.م) بين أثينا وأسبرطة بالهزيمة الساحقة للأولى، نتج عن ذلك ضعف المدن المستقلة التي شاركت في الحرب، وأفسح ذلك في المجال لاستباقها بغزوات خارجية أنهكتها لفترات طويلة. كان أفلاطون حينها في الثالثة والعشرين من عمره، وكان من الطبيعي أن تجذبه في خضم هذه الكوارث لقضايا السياسية والاجتماعية، وأن يعكف في كتاباته على استخلاص العبر التي ولدتها الحرب، وأن يتأمل النتائج التي أفضت عنها. لكن من المثير أن يرسم لنا صورة المدينة المثالثة التي حلم بها على نسق التنظيم التسلطي لإسبرطة، لا على نسق التنظيمات الحرة التي تمتعت بها المدن اليونانية الأخرى في القرون السابقة، أهو إعجاب المهزوم بالمنتصرة؟ لعل.. ولقد وضع في قبال روح الاستقلال والنزعة الفردية التي تميزت بها الحياة اليونانية في زمن الازدهار تصوراً لدولة قوية متجانسة، تقوم على مبادئ شمولية… وهو شيء كان السفسطائيون قبل ذلك قد أدركوا خطره… حين افترضوا أن مواجهة التفكك الذي اعترى حياة اليونان إنما يكون بمزيد من الحرية لا بالتقليل منها، وبالعودة إلى حياة الحرية والمساواة التي عرفها العصر الذهبي، وقضت عليها التنظيمات السياسية وضيق أفق المثل الأعلى الواقعي… وخواؤه الروحي. وهو شيء كذلك كان الكلبيون الذين نظروا إلى تنظيمات الدولة باعتبارها مضادة للنظام الطبيعي للأشياء، والرواقيون الذين رفضوا الخضوع لأي إلزام خارجي، ودعوا إلى إتباع القانون الداخلي الذي يتجلى في الطبيعة، أقول كانوا قد انتبهوا إليه وهم يفكرون في المآلات التي انتهت إليها حياة اليونان بعد الحرب.
كان أفلاطون، من بين هؤلاء جميعاً يمثل رد الفعل المضاد للاتجاهات الرئيسية في الفكر الفلسفي لعصره، إذ آمن بضرورة وجود إلزام أخلاقي خارجي، وبعدم المساواة، وبضرورة وجود سلطة، وقوانين صارمة، وتنظيمات ثابتة، واعتقد بالتفوق الإغريقي.. ولأنه كان يرى أن ما يتصوره موافق لقانون الطبيعية، فقد اعتقد أن الطبيعة أوجدت بعض البشر ليكونوا حكاماً، وبعضهم ليكونوا محكومين، ولأنه كان مؤمناً كذلك بأنه من غير الممكن أن يحكم كل إنسان نفسه، فقد اتجه إلى ضرورة إقامة حكومة قوية، لا تقتصر على قوة السلطة، بل على تفوقها الأخلاقي والفعلي ووحدتها الداخلية، وهو افترض أن اختيار الحكام لا يكون استناداً إلى نسب أو ثروة، بل إلى الخصال التي تؤهلهم للقيام بوظيفتهم، فلا بد أن ينحدروا من سلالة طيبة وأن يكونوا أصحاء، وأن يتمتعوا برجاحة العقل، وأن يتلقوا تربية حسنة، وسوف يسميهم تبعاً لسقراط بالحراس وهم ما إن يتم اختيارهم حتى تخوّل لهم السلطة التي ستكون أوجب للاحترام عندما يؤمن الناس بأنها مقدرة لهم من قبل، وعندما يقتنعون بأنهم إنما ولدوا ليكونوا حكاماً، وأن ذلك إنما هو جزء من نظام إلهي.
ولأن أفلاطون يطمح أن تحقق مدينته انسجاماً تاماً بين أفرادها، فهو اعتقد أن المدينة سوف تحكم على أفضل وجه عندما يتشارك الناس فيها اللذة والألم، لأن الفردية في مثل هذه المشاعر قوة عاملة على التفكيك، وإذا كانت وحدة الشعور، بين المحكومين ضرورية لاستقامة المدينة ووحدتها، فهي ضرورية بطريق أولى بين الحراس، ذلك سيجلهم حراساً حقيقيين، ويحول دون تمزق المدينة، الذي سيحدث إذا ما أخذ كل واحد منهم ما يستطيع أخذه لنفسه، وغرس في المدينة المباهج الفردية وأحزان الأفراد. هكذا تقوم الدولة إذن عند أفلاطون على عاتق طبقة من ذوي المواهب العالية من الرجال والنساء، الذي يتخلون عن الامتيازات، ويقبلون على الزواج والإنجاب بما يتوافق مع مصلحة الدولة، ويحتقرون العواطف والمشاعر والأنانية. وبين هؤلاء من هو أصلح للحكم، فمن تغلب عليه الطبيعة الفلسفية سيصبح حاكماً، ويصبح الأقل منه ذكاءً مساعداً أو جندياً.
ومن الواضح أن أفلاطون لم يعن بالأمور التي تتصل بالإنتاج والتوزيع، ولا بالفلاحين والصناع والتجار الذين لا تستغني عنهم حياة المدينة. وانصب اهتمامه على طريقة اختيار الحراس وتربيتهم، والمنظمات التي تدير شؤونهم، لكي يؤهلوا للقيام بواجبهم في حكم المدينة والدفاع عنها. ولعل السبب هو قناعته بأنه إ ذا ما صلح الحكم، فإن سائر ما في المدينة يمكنه أن يعنى بنفسه على أكمل وجه، ولهذا تعتبر جمهورية أفلاطون وصفاً للطبقة الحاكمة المثالية، أكثر مما هي وصف للدولة المثالية، أو للمجتمع المثالي، لأنها لا تتكلم عن المنتحبين إلا قليلاً.. ويبدو أن أفلاطون ترك هؤلاء لتنظيماتهم القديمة بلا أي تفكير يذكر.. وإذا كان أفلاطون يعهد للفلاسفة بالتشريع للعامة، فإننا لا نكاد نعثر في الجمهورية على شيء يعتد به يمكن أن يهتدي به المنتجون لتدبير شؤون حياتهم. ولقد كان أرسطو محقاً في نقده لأفلاطون حينما اعتبر أنه لم يحدد هيكل دولة لا تتألف من الحراس فحسب، بل من المواطنين، وفي رأي أفلاطون سوف يفضل أن يترك المواطنون شؤون الدولة في أيدي الحراس، وأن يزودوهم بالضروري الأساسي من شؤون الحياة في مقابل العمل الذي يتولونه نيابة عنهم، وهو بذلك لم يعط الحراس أية سلطة اقتصادية، فهم صفر اليدين من الملكية، ويتلقون أجورهم على شكل سلع، والنتيجة أنه سيكون هناك سلطتان، بل دولتان، في دولة واحدة، يتبادلان العداوة والكراهية، وستكون الفائدة الأكبر التي تجنى من صراع كهذا إنما هي للمنتجين، وسيضطر الحراس للحصول على ما يحتاجون إلى استعمال القوة والقمع.. فتفسد المدينة، ويزول انسجامها، وتذهب وحدتها.
وإذ كان الحكام صفراً من أية سلطة اقتصادية، فهم يتمتعون عوضاً عنها بسلطة دينية مقدسة، فهم مخلوقون من ذهب، مفضلون على سائر الناس. ذلك بنظر أفلاطون يضمن قيام الدولة إذا وضعت الطبقات المنتجة تحت سيطرة طبقة تدين بقوتها لهيمنة عسكرية ودينية… ذلك شيء عرفه التاريخ، كان وجود الدولة في العصور القديمة يتضمن تقسيم المجتمع إلى طبقات، ولم تكن قوة الطبقة الحاكمة في العموم ترجع إلى ثروتها بالضرورة، بل إلى أيديولوجيا تكسو هذه الطبقة برداء أعلى تدعمها القوى المسلحة.
لقد كان أفلاطون في بعض نواحي فكره أحد أعظم الثوريين في التاريخ، لكنه كان من نواحي أخرى أكبر رجعي على الإطلاق، وأكبر ممثل للنزعة الشمولية. وبالرغم من أن دولته يحكمها الفلاسفة، فإنها لم تكن تتمتع بأية حرية، وهو منح الفلاسفة الحق في التحجير على العقول والآراء والأفكار، ومنحهم حق تقويم الحياة العقلية برمتها في قبال البدع، وعلى نسق متساوق ثابت من الرؤى والتصورات السكونية.. وافترض أن عليهم أن يكونوا متيقظين لكل ما يفسد تربية النفس والجسم من البدع والضلالات، التي فيها إفساد تام للمجتمع، وقلب لموازين الدولة ونظامها وتفكيك لوحدتها وانسجامها.
إن كل نشاط فردي حسب أفلاطون ينبغي أن يخدم الدولة بإطلاق، وأن يتوقف عن كونه تعبيراً عن الشخصية الفردية. والدولة وحدها هي من يحدد ما هو خير وما هو شر، ما هو جميل وما هو قبيح، وأن يسير الشعراء والفنانون والحرفيون والأدباء وفق معايير أخلاقية موحدة تخدم الخير الذي يوجه المجتمع ويقيم وحدة الدولة.
ولم يكن غريباً أن يبدأ أفلاطون وصف جمهوريته وينهيها بالهجوم على حرية الفنان.. وهو في الحقيقة هجوم على حرية الفكر، لكن غياب حرية الفكر ليس هو الشيء الوحيد المنفر في جمهورية أفلاطون، بل كذلك إيمانه العميق بأن كل إنسان إنما وهب القدرة على القيام بمهمة واحدة فقط مما أدى إلى تقسيم مصطنع للمواطنين إلى منتجين وجنود وحكام. وإذا كان من المؤكد أن بعض الناس قد وهبوا قدرات تفوق قدرات غيرهم، فإن إنساناً واحداً بعينه يمكنه إنجاز أنشطة متعددة بنفس الكفاءة وأن تؤدي اهتماماته إلى إغناء شخصيته، ولا يمكن أن نقتنع كذلك بأن بعض الناس قد ولدوا ليتولوا الحكم وأن بعضهم ولدوا ليكونوا محكومين، وغريب كذلك ثقته التامة بحكم الفلاسفة التي اندفع بارازموس مستهزئاً بها. ويمكن أن يشكك المرء أيضاً بفكرة أفلاطون حول التنظيمات الأسرية التي يتعذر برأيه أن يتوافق مع دولة شمولية، بينما نجد أن علماء الاجتماع أدركوا أن المجتمعات البدائية التي لم تظهر فيها الدولة تخلو من التنظيمات الأسرية، والعكس هو الصحيح لأن نظام الأسرة يدفع إلى الاعتياد على الطاعة فيسهل بعدها طاعة الحكام.
وليس في جمهورية أفلاطون كذلك شيء عن مراقبة الحكام، ولا عن أن السلطة مفسدة ولا يوجد شيء يمنع من أن ينتشي هؤلاء بذبح عبيدهم كما فعل الأسبارطيون.
3- الفارابي على خطى أفلاطون([5]):
بعيداً عن التأويل الأيديولوجي للفلسفة السياسية للفاربي، وللأهداف التي كان يتوخاها من رؤيته الفلسفية حول المدينة، فلقد سار الرجل على خطى أفلاطون، من غير أن يهمل الأفكار التي كانت وصلته من أرسطو مخلوطة بآراء شراحه المتأخرين، ولعله سعى كما هو حاله في غير موضع من نتاجه الفلسفي إلى التوفيق بين الفيلسوفين الإغريقيين الكبيرين توفيقاً لم يكن على أي حال موفقاً، إلا في نتيجته النهائية، وهي توليفته النظرية لمدينة فاضلة ظلت في العموم مثالية، بالرغم مما تحتويه من عناصر واقعية، شأنها شأن غيرها من المدن المثالية التي عرفها تاريخنا الفكري في الماضي والحاضر.
والفارابي يسعد جاهداً ليقدم لنا مدينته باعتبارها مدينة ممكنة، وأنها تقوم على فكرة بسيطة، أخذها الفارابي من أفلاطون، وأورثها لابن خلدون فيما بعد، وهي أن البشر على تنافرهم، محتاجون إلى الاجتماع والتعاون، وأنهم لا يستطيعون بلوغ كمالهم إلا في مجتمع، وهو، تبعاً لأفلاطون يرى أن المدينة الفاضلة كالجسم التام الكامل الذي تتعاون أعضاؤه لتحقيق الحياة والمحافظة عليها، وكما أ، مختلف أعضاء الجسم الواحد مرتبة بعضها مع بعض، وتخضع لرئيس واحد، هو القلب، فكذلك يجب أن يكون الحال في المدينة. وكما أن القلب هو أول ما يتكون من الجسم، ومن ثم تتكون بعده بقية الأعضاء فيديرها القلب، فكذلك الحال في رئيس المدينة، الذي تحققت فيه الإنسانية على أكملها.
قانون الدولة إذن يشبه قانون الطبيعية ويحاكيه.. تتراتب أجزاؤه وتتفاضل، وتترابط فيما بينها وفق قانون واستناداً إلى نظام… وكل عضو في المدينة هو عنصر من عناصرها له وظيفة تتناسب مع وضع الطبيعة في المدينة ومع مكانته في سلم طبقاتها، لكن ذلك لا يجعل المدينة حسب الفارابي مجرد آلة تجري وفق ما تفرضه الطبيعة على الجسم، والرئاسة تكون بشيئين، بالفطرة والطبع، وبالهيئة والملكة الإرادية، والرئيس الأول في جنس لا يمكن أن يرأسه شيء من ذلك الجنس، وهو الإنسان الذي استكمل فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل… وهو له حسب الفارابي اثنتا عشرة صفة، يفطر عليها، وهي، أن يكون تام الأعضاء، جيد الفهم والتصور، جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ويسمعه، ثم أن يكون جيد الفطنة ذكياً، وأن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره، محباً للتعليم والاستفادة، غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح، وأن يكون محباً للصدق وأهله، كبير النفس محباً للكرامة، وأن يكون المال وسائر أعراض الدنيا هينة عنده، محباً للعدل وأهله، وأن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل.
والفارابي يشرح لنا بتفصيل كما هو حال أفلاطون خصال المؤهل للرئاسة، لأنه لا يتصور مدينة فاضلة لا يحمل رئيسها صفات تقربه كثيراً من صورة الفيلسوف، لكنه في الأعم الأغلب حين يرغب في تصوير مدينته الفاضلة يعرفها بالضد، أعني بتفصيل القول في المدينة الجاهلة والفاسقة والمتبدلة والضالة، كما هو الشأن في نسق أفلاطون من غير تغيير.. لكنه كفيلسوف مسلم يحاول إقامتها على رؤية ميتافيزيقية تحاول أن تنسجم قدر الإمكان مع كوزمولوجيا الإسلام، ورؤيته العامة للوجود، وهو شيء كان خصص له الجزء الأول من مدينته الفاضلة بأكمله الذي درس فيه المبدأ الأول وصفاته، وصدور العالم عنه ثم حدد فيه مكانة الإنسان ودوره ووظيفته ومرتبته الوجودية، وصفاته التي فيها عقله وإرادته الحرة التي يحصل بواسطتها السعادة.
فنظرية الفارابي إذن في المدينة تستلهم أفلاطون وآراء أرسطية، لكنها تحاول أن تستجيب نظرياً للتطلعات الفلسفية الصوفية لفيلسوف مسلم، لكن رؤية الفارابي سوف تواجه في الفكر الإسلامي تحدين اثنين جذرين، الأول مثله ابن رشد، والثاني مثله ابن خلدون. والأول سوف يناقش وجهة نظر الفارابي في أسسها النظرية الميتافيزيقية، خاصة نظرية الفيض، وفي إمكانها العملي، والثاني سوف يفترض أن نظام المدينة وقانونها رهين بسنن الاجتماع لا بنظام الفكر، وأن الدول إنما تنهض وتموت استناداً إلى قانون حتمي للعمران البشري. ولأن الجانب الميتافيزيقي من الفارابي لا يعنيني، فسوف أوضح موقف الرجلين من إمكانية المدينة الفاضلة وواقعيتها، عند الأول استناداً إلى استقراء الوقائع، وعند الثاني استناداً إلى رؤيته كمؤرخ للعمران متفكر في السنن التي توجهه هبوطاً وارتفاعاً.
لقد نبه ابن رشد([6]) وهو يعرف أفكار أفلاطون في السياسة، ويقرأ بعمق رؤى الفارابي، إلى أن نظام الحكم الاستبدادي الخالص، أو المدينة المثالية الخالصة التي تقود إلى السعادة، لا توجد هكذا بسيطة إلا على صعيد التحليل، أما في الواقع فهي في الغالب مركبة قال: “وينبغي أن تعلم أن هذه السياسات التي ذكرها أرسطو ليست تُلْفَى بسيطة وإنما تلفى أكثر ذلك مركبة، لأنها إذا تُؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب”.. ثم هو ينظر للتركيب هذا ويستوحي منه نموذجاً علمياً، يعينه على افتراض أن الدول مهما تنازلت وتسافلت وعم فيها الاستبداد والفوضى فهي لا تبلغ مبلغ الاستبداد الكاملة، وتقبل مع ذلك الإصلاح، وهذا حال الدول على الدوام تقع في الوسط بين الفضيلة والتغلب، وبين السعادة والشقاء.. تقترب طوراً من هذا وطوراً من ذاك دون أن تبلغ حديهما.
أما ابن خلدون([7])، فلقد اهتم على وجه الدقة بالبحث عن معيار في الوقائع والحوادث يميز من خلاله بين الصادق والكاذب منها، بين ما تقبله طبائع العمران وبين ما لا تقبله، كما هو في الواقع، لا كما ينبغي أن يكون… وللعمران عنده طبائع في أحواله لا تقبل التغيير ولا التبديل، وأن التغيير إذا حدث في المجتمع وفي السياسة فهو إنما يحصل بفعل قوانين، ونمط تطور لا فكاك منه. ولأجل ذلك لم يكن الرجل رجل إصلاح، لأن الإصلاح في مذهبه غير ممكن، والدول إنما تنهض على قدم، أو تموت، لأن التاريخ يسير وفق مسلسل من الأحداث تتحكم فيها عوامل موضوعية مستقلة عن إرادة البشر ورغباتهم، وفي مقدمتها العصبية، أعني القوة القبلية، التي تحرك التاريخ وتصنع الأحداث، وفق سياق موحد لا يتغير.. العصبية تجري نحو غائية هي الملك، والملك ينتهي إلى الترف والانفراد بالمجد، وهذان ينتهيان به إلى الهرم، فتسقط الدولة تحت ضربات عصبية جديدة مطالبة، وتبدأ بذلك دورة ملك جديدة.. ثم تلاقي هي الأخرى نفس المصير.. ولأن مذهب ابن خلدون تاريخي، يعتبر الوقائع ثم يستخلص القوانين والسنن، فلقد أعرض إعراضاً تاماً عن فكرة المدينة الفاضلة، لكونها بنظره نادرة الوقوع أو بعيدة، ولأن أصحابها إنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير، لا على جهة الوقوع والحدوث.
لكن ظاهر التعارض بين ابن رشد وابن خلدون في الآليات والمبادئ سوف يؤدي بهما إلى نفس النتيجة، وهي أن كل دولة إنما تكون مركبة من فضيلة واستبداد لا محالة، فلا مدينة فاضلة بإطلاق، وهي تتحول من هنا إلى هناك حسب الظروف والوقائع أو حسب الأوضاع والأحوال.. فهزم الدولة عندهما يقوم جوهر العلاقات فيه على مبدأين، الجاه والتملق، الجاه مفيد للمال بالتسلط أو بالخدمة، والتملق مفيد للجاه الذي يولد طبقة من المصطنعين حسب ابن خلدون، تحدث في المجتمع في الأعم اضطراباً في المراتب.. فيتقدم فيه من حقه التأخير… والجاه يرى في المجتمع من أعلى إلى أسفل، ليست على مستوى الأفراد فحسب، بل على مستوى الطبقات ” ثم أن كل طبقة من طبقات أهل العمران لها قدرة على من دونها من الطبقات، وكل واحدة من الطبقات السفلى تستمد بذوي الجاه من أهل الطبقات التي فوقها… ويزداد كسبها تصرفاً فيمن تحت يدها على قدر ما يستفيد منها. فالجاه على ذلك داخل على الناس في جميع أبواب المعاش، ويتسع ويضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه: فإن كان متسعاً كان الكسب الناشئ منه متسعاً، وإن كان ضيقاً قليلاً فمثله. وفاقد الجاه، وإن كان له مال فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه ذاهباً آيباً في تنميته.. فأكثر التجار وأهل الفلاحة إذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنائعهم فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر، ولا تسرع إليهم ثروة، وإنما يرمقون العيش ترميقاً ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة”.
وإذا كان الجاه هو مصدر الثروة في الدولة المركبة، كما هو أغلب الدول، فكيف يحصل الجاه؟. إنه يحصل “بالخضوع والتملق لذوي السلطان والجاه، يبذله من هو فوق لمن هو تحت، فيكــون بذله بيد عالية وعزة، فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع وتملق… وكثير من السوقة يسعى إلى التقرب إلى السلطان ونصحه، يتــزلفون إليــه بوجــوه التملق له وخــدمته، ويســتعينون على ذلك بعظيم مــن الخضــوع والتــملق له ولحاشيــته وأهــل نسـبه، حتى ترسخ أقدامهم معهم، وينتظمون السلطان في جملة السلطان، فيحصل لهم بذلك عظيم من السعادة، ويندرجون في عدد أهل الدولة، ومن هؤلاء المصطنعون الذين لا يعتدّون بقــديم، ولا يذهـبون إلى دالة ولا تــرَفع، وإنما دأُبهم الخضــوع له والتــملق، فيتـسع جـاههم، وتعلو منزلتهم، فتنصرف إليهم الوجوه والخواطر بما يحصل لهم من المكانة عند السلطان “.
ولأن ابن خلدون يرى تسلسلاً حتمياً في العمران ينتهي بالدولة إلى السقوط، فلا مجال عنده للإصلاح إلا على وجه التناوب، بأن يكتب للدولة عمر آخر سالماً من الهرم من يتخير الحاكم أنصاراً من غير أهله وقبيلته ممن حصل لهم الانفراد بالمجد والترف، وجروا الدولة إلى الهرم. لكن العمر هذا الذي تضيفه الدولة إلى عمرها لا يجنبها في النهاية حتمية سقوطها، لأن هرم الدولة بنظره طبيعة من طبائع العمران، وقانون حتمي من قوانينه..
إن هرم الدولة على شكل مزاج، ومزاج الدولة هو العصبية، ويتغير مزاجها حسب الطور الذي هي فيه، طور الظفر والتأسيس، حيث يشارك الحاكم أهل العصبية الحكم، ويكون أسوة قومه ولا ينفرد بشيء دونهم، وتكون الدولة هنا أقرب إلى الفضيلة، ثم يأتي طور الاستبداد والانفراد دونهم بالملك، ثم القناعة وتقليد السابقين، ثم طور الإسراف والتبذير، وهنا تحصل طبيعة الهرم. فالتركيب هنا إذاً متداخل مع أطوار الدولة ولكل طور مزاجه الخاص، كأطوار عمر الإنسان سواء بسواء.. ولا يقبل الانعكاس، فكأن التغيير هنا لا يحدث بعد بإصلاح، بل بتغير جذري للحياة…
أعني بإنشاء شيء جديد تماماً، بأن تتبدل الأحوال جملة فيتبدل الخلق من أصله، ويتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث، وهذا يتحقق بثورة عارمة، وما عدا ذلك فتأجيل لسقوط الدولة الآتي لا محالة.
لكن ابن رشد حين عرض تحول الأنظمة كما هي عند أفلاطون، من الأرستقراطية (حكم الأخيار) والتيموقراطية والديموقراطية والطغيان، نبه إلى أن هذا التعاقب ليس ضرورياً ولا هو حتمي، لأن الأمر يتعلق في الحقيقة بالشؤون الإنسانية، وهي إرادية كلية، لأنها أعمال يأتيها البشر بإرادتهم وتتدخل فيها السنن التربوية والسياسة والتشريع، ومن هنا كان تحول الإنسان من خُلق إلى خلُق، لا يحصل بالحتم ولا بالضرورة، كما هي التحولات الطبيعة، وإنما يكون تابعاً لتحولات السنن مرتبا على مراتبها.. فالمدينة الفاضلة ممكنة إذن لا على وجه الحتم، إنما على وجه المثال الذي يرتجى، بأن نربي أناساً بالصفات التي وصفهم أصحاب المدن بها، وينشؤون عليها، ثم يختارون من ناموساً مشتركاً لا مناص لأمة من هذه الأمم من اختياره، وتكون مع ذلك شريعتهم الخاصة بهم غير مخالفة للشرائع الإنسانية، وتكون الفلسفة قد بلغت على عهدهم غايتها، فإذا اتفق لمثل هؤلاء أن يكونوا أصحاب حكومة، وذلك في زمان لا ينقطع، صار ممكناً أن توجد هذه المدينة الفاضلة.
على أن الطريق إلى المدينة الفاضلة ليست واحدة، كما رسمها أفلاطون ومن بعده الفارابي، فقد يتحقق ذلك في زمن طويل، بأن يتعاقب على المدن وفي أزمان طويلة حكام فضلاء، فلا يزالون يرعون هذه المدن ويؤثرون فيها قليلاً قليلاً حتى تبلغ في نهاية الأمر أن تكون على أفضل تدبير. وتحول المدن غير الفاضلة لكي تكون فاضلة يكون بأمرين، بالأفعال والآراء، ويزيد هذا قليلاً أو كثيراً تبعاً لما تجري به النواميس القائمة من وقت لوقت، وتبعاً لقربها أو بعدها عن المدينة الفاضلة، وقد يكون تحولها كذلك بالأعمال الصالحة أكثر منه بالآراء الحسنة.
4- المدينة العظمى عند الريحاني.
أولاً:مدخل عام
أ- الريحاني المصلح:
أولاً: لم يكن الريحاني فيلسوفاً يكتفي من الرأي بما أيدته قوة الفكر وعمق التأمل وتناسق المنطق، سواء ما اتصل من آرائه بالاجتماع والسياسة، أم بالدين والعلم، أم بالأدب والفن، وسواء ما ارتبط منها بقضايا الحرية والعدالة، أم بالتقدم والتخلف، أم بالتربية والتعليم…
هو داعية مصلح بالمعنى العميق للكلمة، استغرقته الحوادث وشغلت فكره الوقائع المشخَّصة، وملكت عليه تفكيره الأزمات العاصفة وقضايا الحياة ؛على تشعبها وتعقدها واتساعها؛ ما عظم منها وما صغر، وحركت ضميره أوضاع العالم من حوله شرقاً وغرباً، فكان له فيها إلفة الفاحص المتبصر المعتبر، وخبرة الحكيم المجرب العارف، المنخرط في تفاصيلها، المشارك في أحوالها، الواقف على خصائصها وأوصافها… هكذا يكون الداعية المصلح، رجلاً لامع الذكاء، يمكّنه عمق بصيرته من أن يفهم الطبائع، ويستوعب التجارب في أعمق ما تنتهي إليه دلالاتها، ويقف على أسباب الوقائع يحيط بأعماقها الراسخة ومآلاتها البعيدة ونهاياتها القصية، ثم يتأمل سيرورة المجتمع وتوتراته، في صعوده وهبوطه، نجاحه وإخفاقه، سعادته وشقائه، مستوعباً جملة العوامل التي تقود إلى كل ذلك وتؤدي إليه. هكذا كان المصلحون في مدى الزمن في ماضيه وحاضره وهكذا سيكونون([8]).
ثم إنه داعية مصلح كذلك، لأنه لم يكتفِ، فحسب، بأن حدَّد الطريقة المثلى التي بها تبلغ الأمم سعادتها ورقيها، ولا رسم صورة العوامل التي تدفع بها إلى الانهيار، مستخدماً ما أمكنه استخدامه من حجج مقنعة وأدلة واضحة ومنطق متناسق، بل انخرط بنفسه في ميدان العمل، خطيباً منبهاً، ناصحاً واعظاً، محاوراً مناقشاَ مشاركاً متفاعلاً، لا تثنيه عن السعي وراء ما يؤمن به ويتقنع بجدواه ويدرك نفعه، صعوبات مهما عظمت، ولا عقبات مهما تكاثرت، مخلصاً للرسالة التي نهض بها وحمل أعباءها.. لا يهن أمام سلطان قاهر أو عادة راسخة أو تقاليد أو أعراف، لا يحد من اندفاعته الصادقة موقف مشكك هنا أو نظرة مستريبة هناك.
وكونه داعية مصلحاً لا يقلل من وجاهة أطروحته في النظر والفكر، ولا من عمق تأمله وهو يرسم ملامح المجتمع الذي يطمح إليه وصورة الإنسان الذي يؤمن به وطبيعة الحياة التي يرجوها.. لكن أفكاره على عمقها وسداد منطقها لم تكن مجرد تأمل خالص لفكر ذكي وقاد، يستجيب لداعي الخيال ، ويحركه مجرد أمل بسعادة منشودة… ومن يحيط بتراث الريحاني ونتاجه ويقف على عناصره، يدرك بوضوح واقعية فكره ، على شيء من مثالية محببة تحرك العاطفة وتمسك بالوجدان، وتحفز الهمم وتستثير الإرادة.. وتزين الطموح والإنجاز والفعل…
ويمكن لنا بعبارة إيجاز طريقته في التفكير وأسلوبه في النظر، بأنها كانت اختباراً عميقاً لتجارب الناس والأمم، واعتباراً أكيداً من الأحداث، وفحصاً متأنياً متبصراً للوقائع، وقراءة واعية لنتائج الفكر والقرائح ولتأملات العقول والأذهان ولتراث الشعوب والأديان ، مع وعيه التام بما كان يحيط به من تقلبات العالم وتعقيدات أوضاعه وتبدلات أحواله، وفهمه العميق لطبائع الشعوب وعاداتها وتقاليدها وأعرافها ومذاهبها، في لفكر وفي العمل في الاجتماع والسياسة وفي القيم والسلوك([9]).
ومعرفة الريحاني الواسعة بالغرب الحديث، وقد بدا في أوج نهوضه على غير صعيد، مكنته من أن يفهم باستيعاب، يكاد يكون استثنائياً، معاني التقدم وما يجله للأمم من ازدهار ورقي ومدنية، وأن يحيط علماً بالأفق الذي يمكن للوعي، حين يتحرر من القيود والأغلال، أن يفتحه أمامه من مسالك السعادة، وأن يجلبه من أسباب الازدهار والرفاهية والاستقرار… وفوق هذا، ما يمكن للإرادة الحرة المتوقدة والعزم الأكيد المخلص والأمل المتقد بالمستقبل أن تصنعه من إنجازات ومكاسب.
وهو بحكم انتمائه إلى الشرق وروحانيته العميقة وأبعاده المعنوية الاستثنائية وأديانه الحية الإنسانية، كان يعرف مواطن الخلل في كل تقدم مادي، وفي كل مدنية تقوم على التقانة وجشع الثروة والأنانية، وفي كل إنجاز لا يأخذ في الحسبان الجوانب المعنوية للوجود البشري والمقاصد السامية الغنية التي تمنح لوجوده أعمق معانيه وتحقق أرفع مقاصده.
حين عاد الريحاني من بلاد الاغتراب لم تكن بلداننا على خير ما يرام.. مجتمعات تنوء تحت عبء مشكلات وأدواء. مفككة مترهلة، ينخرها الجهل والأمية والتخلف، ويعصف بها الفقر والحاجة، في ظل إمبراطورية متهاوية تكاد تلفظ آخر أنفاسها، وفي سياق أزمات عالمية كانت تشي بصدام لا مرد له ، تدفع شعوبنا ثمن آثاره المدوية ونتائجه المدمرة… وهو وعى بحسه العميق وبخبرته وسعة اطلاعه ووقوفه على مظاهر التقدم في المجتمعات الحديثة وأسباب الازدهار والرقي… عمق المأزق هذا الذي كانت ترفل فيه مجتمعاتنا ، وسعة المشكلات التي تعصف بها، والقوات التاريخي الذي أصابها، لكنه كان يؤمن إيماناً عميقاً بأن الإصلاح ممكن، وبأن إعادة تقويم مسار تاريخنا مقدور إذا ما اجتمعت الهمم والتأمت الإرادات وصدقت العزائم… وأن الأمة إذا ما اجتمعت همم أبنائها على أمرٍ وسعت له سعيها وكابدت في سبيله وكافحت من أجله، يحدوها الأمل بالنجاح والثقة بالمستقبل، فلا صعوبة تعترضها، ولا أفق ينغلق دونها، ولا قوة تضعف فيها عزيتها، ولا موانع تحول بينها وبين مرادها ومقصدها.
تلك كانت عقيدته التي بثها في جماع نصوصه وكتبه ومحاضراته وخطبه ومراسلاته لا تفتأ تتكرر هنا وهناك، تشحذ الهمم وتحفز القوى وتحرك المشاعر وتضيء العقول، وتبث العزيمة في النفوس المستكينة المسترخية المستسلمة إلى الخنوع والضعة والتكاسل… وهي عقيدة شاملة عامة في الإصلاح، ورؤية كاملة تامة في النهوض، ضمنها دعوته الراسخة التي كانت صدى عميقاً لتجربته، والتي تتمثل في أن الأمم ترتقي بالحرية، وتنهض بالتصميم، وتتقدم بالأمل المقرون بالعمل والمكابدة والكفاح، وأن المجتمعات تجد أمانيها حين توجه نظرها إلى المستقبل متكئة على ثقة لا تحد بنفسها وتاريخها، وبالإمكانات والطاقات التي تتوفر عليها وتملكها، وبإيمانها بالعلم يفتح لها أفق العالم، وبتمسكها بقيم العدل والتسامح والكرامة البشرية وأخوة الإنسان، وبنبذها للخرافة ولسلطان الوهم الذي يعطل عقول أبنائها ويقضي على آمالهم ويدمر إيمانهم بالمستقبل. وهي قيم ومبادئ سوف تكون أساسية في رؤية الريحاني للمدينة العظمى وللفضائل التي تقوم عليها وللأركان التي تنهض استناداً إليها وللمبادئ التي توجهها.. مما ستراه عما قليل.
ب- إمكانية النهوض:
ويكاد يقترب الريحاني من ابن رشد في إيمانه بأن المجتمع، مهما بلغ من انحطاط، قابل للإصلاح، وأن المدينة الفاضلة ليست مجرد ترنيمة نظرية لمشروع مجتمع فاضل تدغدغ الخيال وتملأ النفس ببريقها، إنما هي مشروع ينجز… هي شيء يتم تبصره كمثال يولد في الإنسان إرادة للعمل والكفاح، وأنه شيء لا يتأتى لنا العثور عليه في امتلاء معناه وفي اكتماله هكذا كما يتم رسمه بالفكر، إنما هو النموذج المفتوح على مسارات الخلق والتقدم، يدعونا كلما حققنا خطوة في سبيل بلوغه والوصول إليه، إلى مزيد عمل لننجر خطوة أخرى ولنحقق المزيد، وهو النموذج الذي يمحنا ،حين تخفق تجاربنا، الفرصة لكي نعيد الكرة من جديد، والعزم والتصميم على النجاح حين نتعثر في الطريق، لأنه يزودنا بالأمل في أن نعيد النهوض كلما أعاقتنا عن ذلك صروف الزمان… هو النموذج المثال الذي يتحقق بالإرادة والسعي، ويُتمثل حسب الظروف، ويتجسد في عزائم حرة فاعلة تتسامى استناداً إلى مراكمة التجارب، وتحفيز الهمم، مصلحة بالعلم والمعرفة، وبالثقة التامة بالذات، وبالقوة التي توفرها التربية السليمة الواضحة، وبالاستقامة التي تقوم على الفضيلة والخير والتسامح.
يقول الريحاني:
إن من الحقائق التي لا ريب فيها هو أن الإنسان مهما ارتقى في سلم الحياة يظل في مكان يرى منه من تقدمه إلى العلاء، ومهما انحط المرء وتقهقر لا يصل إلى القعر الذي لا يُكشف على أحد دونه.فالسلم والهاوية لا نهاية لهما في حياة الإنسان.. أينما كان المرءُ إذن يرى كثيرين من الناس فوقه، وكثيرين تحته، وكلما ارتقى درجةً في معارج الفوز والفلاح يسمع أصواتاً بعيدة تدعوه إلى ما هو فوقها، وهذه من حقائق الحياة التي فيها لجميع الناس كثيرٌ من التنشيط والتعزية، علينا إذن أن لا نكون عبيداً لمَنْ هم فوقنا، وألا نستعبِد من هم دوننا… علينا ألا نتصاغر أمام الكبار وألا نتكابر أمام الصغار… وكما في الناس كذلك في المدن، فلا يحق لجدة مثلًا أن تصعِّر خدها للقاهرة، ولا القاهرة أن تشمخ بأنفها على جدة… لأن حسنات المدينة العظمى قد تكثر في هذه وتقل في تلك، قد تكبر في المدينة الصغيرة، وتقل في تلك، وقد تكبر في المدينة الصغيرة وتقل في الكبيرة، وكل المدن تقع بين حدين… تتفاوت فيها الفضائل رفعةً وانخفاضاً، وتتمايز بما تتسربل به من أسباب الرفعة ومناحي العظمة.. أما المدن المثالية الفاضلة التي صورها لنا الفلاسفة، ومدن الاستبداد الخالص، التي تخلو من الفضيلة، فهي ليس سوى مدينة أنشأها الخيال، ما هي من مدن هذا الزمان ولا من مدن الماضي…([10]).
وبذلك ينأى الريحاني بنفسه عن أن يكون يوتوبياً خالصاً كما هو حال أفلاطون أو الفارابي.. اللذين آمنا بأن المجتمع المثالي ممكن، وأن الإنسان يبلغ فيه كمال سعادته… ثم يستنكف إلى ما بلغه فلا يطمح إلى شيء بعده، ولا ينعقد عزمه على إنجاز يصبو إليه ويأمل به ويحلم بتحقيقه، فتخمد الإرادات وينطفئ العزم ويضمحل السعي والمكابدة ويموت الأمل… ولا هو كابن خلدون الذي آمن بناموس لا يتغير للعمران تسير الأمم وفقه من غير إرادة تملكها، ولا تغيير ترجوه، ولا أمل بإصلاح إن قضى القانون على أمة من الأمم بالهرم والشيخوخة والزوال.
ويعبر الريحاني عن قناعته هذه بالقول:
ومَنْ يتجاسر في هذه الأيام، من يدري ما في المستقبل لشعوب آسيا الصغرى، فقد تزهو والمدينة العظمى فوق أطلال بابل، قد يشيدها الزمان (يقصد أهل الزمان) على ضريح نينوى، قد ترتفع صُروحُها وأعلامُها وأبراجها وقبابها تحت هذه السماء الجميلة، على هذه الشطوط التاريخية المقدسة، أمام هذه الأمواج التي شاهدت جنازة مجد آسيا… وستشاهد موكب بعثة المدينة العظمى([11]).
ليس المجتمع إذن كالطبيعة يحكمه قانون حتمي كما رأى أفلاطون والفارابي ومن نحا نحوهما، ولا المجتمع كذلك محكوم بناموس للعمران يقضي في المدن بما يقضي به الزمان في الجسد الإنساني، يقوده نحو هرمه الذي لا مرد له.. المجتمع محكوم بسنن، وبإرادة أولئك الذين يعيشون فيه، حين يحسنون صناعة تاريخهم، انسجاماً مع ما يقوم عليه من مبادئ وسنن. وما من مجتمع من مجتمعات البشر إلا وهو قابل للإصلاح… تدفع به أفعال البشر نحو انحطاطه، وهي بنفسها تشكل رافعة نهوضه، إن هي وفرت لذلك أسبابه، وهيئت له ظروفه، واستثمرت في سبيله كل قوة ممكنة وكل معرفة لازمة وكل عمل ناجح سليم، وإن هي أحسنت الاعتبار من الأحداث والوقائع ومن تجارب التاريخ ومآزقه، وصور صعوده وهبوطه.
ثانياً: المدينة العظمى ماهيتها وفضائلها:
أ- ضرورة المدينة وشروط الاجتماع
المدينة ضرورة طبيعية، تعبر عن حاجة البشر إلى الاجتماع من أجل بلوغ الكمال الإنساني والسعادة. كذا يعتقد الريحاني ويؤمن، وهو بذلك يميل إلى الرأي القائل بأن الحياة السياسية في اجتماع وليدة حاجات فطرية طبيعية، تدفع إلى التعاون في سبيل تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح، وتلبية أقصى ما يمكن من الحاجات التي تتطلبها حياة البشر وتستدعيها([12]).
لكن الريحاني لا يغفل البتة عن أن الشعور الفطري بضرورة الاجتماع لا يوفر وحده الأرضية الكافية لتحقق الاجتماع ووجوده، ولا لبقائه واستمراره. ففوق ذلك مسوغات لا بد منها، هي ضرورية ليوجد الاجتماع، وأساسية ليستمر ويبقى… وبعض هذه العناصر مسوغات ضرورية للوجود وبعضها شروط ضرورية للقوة والمنعة ورسوخ الوحدة التي يحققها أصل الاجتماع ويوفرها.
والمسوغات هي وحدة اللغة، ووحدة التاريخ، ووحدة الأرض، والقوة التي توفرها هيبة عسكرية تمكنها من النشوء وتسمع لها باستتباب أمرها، ووحدة المدنية والحضارة اللتين يجعلان الأمة عنصراً مساهماً في الرقي البشري. والشروط التي توفر للمدينة استمرارها وبقاء وحدتها، هي بحسب الريحاني حسُّها الوطني والقومي، وخصالها وفضائلها كالشجاعة والكرم… إلخ.
والحس الوطني والقومي هو الكفيل بتوحيد الأمة واستمرارها. الأمة توجد قبل القومية، لكن القومية التي تتبعها تفعل فعلها وتحقق وظيفتها بأن تحقق للأمة وحدتها([13]).يقول:
“إن مسوغات المدينة العظمى هي التاريخ والأرض والقوة والمدنية والحضارة ، اللتان تشعان على العالم ، والروح القومية التي توحد النفوس، وتقوي فيهم عزيمة الثبات والثقة بالغد والتفاؤل بالمستقبل، وقوة الشعور والإحساس بالوحدة والانسجام والتماسك… وهو شعور يقوم على مبادئ إنسانية راسخة، قوامها الشمم والإباء والصدق والوفاء والكرم والشجاعة والحرية([14]).
ويؤكد الريحاني على مثل هذه المبادئ والأسس التي يقوم عليها كل اجتماع راسخ، وتقود إلى المدينة العظمى التي تكفل السعادة لأبنائها، في معرض حثه أمة المدينة على الثبات في مواجهة الصعاب، وعلى الأمل بالغد في مواجهته الإخفاقات والآلام. وهو يفترض أن أمة المدينة لا بد لها من الثبات في مواقع الصراع لتحافظ على وجودها… وأفضل سلاح تتمسك به ــ بنظره ــ هو سلاح النفس المتفائلة الواثقة والعازمة. وهذه مزايا تكفلها الروح القومية وتوفرها في بعدها الإنساني الشامل، وهي روح عمل الريحاني على تعميمها ونشر مضامينها باعتبارها خشبة الخلاص من ظلمات الماضي، وأدران الحاضر، وجسراً يتم العبور عليه من التشتت إلى الاتحاد، ومن الضعف والانقسام إلى القوة والسلطان .القومية هي جوهر المدينة العظمى([15]).
ب- ماهية المدينة العظمى وفضائلها على الإجمال:
والريحاني يوجز في نص مكثف عميق ماهية المدينة التي ينشدها ويطمح إليها ويكافح من أجلها، فيقول([16]):
المدينةُ العظمى تمتاز عن سائر المدن بنوابغها، بشعرائها وعلمائها وأرباب الفنون والصنائع فيها… المدينة العظمى هي التي يمكنها أن تفاخر سائر المدن لا بكثرة سكانها بل بكثرة الأصَحَّاءِ فيها… المدينة العظمى هي التي يخلو هواؤها من جراثيم الأمراض، وتشرق شمسها على عقولٍ سليمة في أجسام سليمة… المدينة العظمى هي التي تكرم أبطالها ونوابغها لا بإقامة التماثيل والأنصاب فقط، بل بالاقتداء بهم، والعمل بتعاليمهم.. هي التي تقترن البساطة والجمال في أبنيتها وفي أزيائها وفي فنونها، والرحمة والعدل في أحكام قُضاتها، والعلم والدين في تعاليم علمائها، هي التي يحترم المرءُ فيها جسده ورُوحه على السواء. هي التي ينبذ رجالها ونساؤها الشرائعَ التي يسنها الخائنون لمصلحة أفراد… هي التي لا يوجد فيها أَرِقَّاء، ولا تُباح فيها النخاسة. هي التي ينهض فيها الشعب نهضةً واحدة على ظلم الحكام وفساد المسيطرين… ويستغني فيها أهل الأدب والفنون عن أهل المال، والتي تقوم فيها دائرة أوقاف لا لإعاشة رجال الدين، بل لخدمة العلوم والفنون، ولخدمة النوابغ والعلماء… وعبثاً تسن الحكومات الحرة شرائع حرة إن لم تطلق أنفس العلماء وأرباب الفنون من قيود المصلحة ومن هموم الارتزاق ([17])…
ولا معنى للمدينة بلا حرية، ولأجل ذلك “المدينة العظمى مدينة مستقلة حرة، لا تخضع لسلطة أجنبية، ولا تتدخل في شؤونها إرادة غير إرادة أبنائها”، وهي التي يكون فيها كل امرئ سلطانًا بنفسه ومثالاً حياً للحرية والإخاء، والتي يُعتبر فيها الحكام خُداماً للشعب، وتعلم بنيها في مدارسها الاستقلال وعزة النفس مثل سائر العلوم… والتي تُطلق فيها حريةُ القول والعمل ،ويَكثر فيها التنقيبُ والبحث، وتثمر فيها الفنون وتعزز فيها الآداب”([18]).
ولأن المدينة العظمى هي مدينة الفضائل، ومجمع الخير وموطن السعادة، “فهي التي تكون الصداقة فيها أمراً مقدساً والإخلاص محترماً… ويعتاد كل امرئٍ فيها على محاسبة نفسه… فإذا كان ممن لهم شيء من شهرة أو قوة أو نفوذ أو مال؛ سأل نفسه: وما قيمة هذه الأشياء إلا أن أقُيم حقّاً أو أدفع باطلاً”([19]). وما تجنيه المدينة العظمى من شيوع هذه الفضائل فيها هي أن يترسخ فيها التسامح والإخاء وتسلم من الأباطيل والجهل والقداسة المزيفة، وتتحرر من التعصب والكراهية “فيسير فيها الذئب والحمل والنمر والجدي معاً”([20])، ويرتاح فيها الناس من شرور المفترين على الله وأنبيائه، الجالسين على عروش القداسة الكاذبة، القابضين على صولجان الخرافة، المتوجين بتيجان الجهل والتعصب والطغيان… فيسود فيها العلم والحرية والإخاء والوفاء، وتنتصر فيها القوى الروحية والعقلية على القوى المادية، وتشيد فيها الصروح والمعاهد لأرباب الموسيقى والشعر والتصوير”([21]).
والمقتطفات هذه على إيجازها وتركيزها تستوعب رؤية الريحاني كلها حول المدينة العظمى، وتصوره الشامل للمجتمع الذي يصبو إليه ويكافح من أجله.. وتكاد تكون “تجربة” حياته كلها وكتاباته ومحاضراته ورسائله وخطبه، على تفصيلها وتوسعها وتباعد موضوعاتها واختلاف اهتماماتها وميادينها، توضيحاً شاملاً متوسعاً للعناصر الفكرية والمعرفية التي أجملها هذا النص وأشار إليها وأوحى بها ولخص دلالاتها.
ولأن الريحاني كان حريصاً على أن تكون دعوته واقعية، لا مجرد أمل يحرك المشاعر، وحلم يدغدغ العواطف والضمائر… ولأنه كان ينطلق من قناعة راسخة بأن المدينة العظمى أمل يمكن تحقيقه وإنجازه، وغاية يمكن بلوغها والوصول إليها لينعم فيها الإنسان بالسعادة التي يرجوها، ويحصل على الخير الذي يصبو إليه ويأمله.. فهو راح في مدى مساحة حياته يكتب ويدون، ويحاور ويخطب… ويناقش ويبيّن، ويفصل في الشروط والأسباب والميادين والعناصر التي تكفل لهذه المدينة أن تكون، والتي توفر لها الأرضية اللازمة لكي توجد، وتحضر لها المناخ الذي يحتضن إشراقها واستنارة مصابيحها، في مستقبل كان يراه بتفاؤله العميق وإيمانه الراسخ قريباً، مبيناً قناعته في طبيعة المجتمع النموذجي، مفصلاً رؤيته للمدينة المثلى، محدداً فضائلها والخصائص التي ينبغي أن تتوفر عليها والمزايا التي يجب أن تجتمع فيها، وحياة إنسانها، وصفات حكامها، وسياستها التي تقوم عليها، وقيمها وأحلامها، وآدابها وفنونها وعلومها وصناعاتها… إلخ. وسوف أوجز هنا أفكاره فيما يتصل بكل ذلك.
ج- فضائل المدينة العظمى ومزاياها:
– الحرية: يفتتح الريحاني نصه حول المدينة العظمى في الريحانيات، بفقرات عميقة حول الحرية، ذلك أن المدينة العظمى لما كانت وليدة إرادات البشر وصورة عزائمهم ومثال توقد هممهم، فشرطها الحرية… والأخيرة هي “ضالة الإنسان المنشودة، وغايته القصوى في الحياة، وهي قِوام الأنفس والعقول، وغذاء الفنون والعلوم، وأساس كل مظاهر الرقي والعمران”([22]).
ولأن للحرية مثل هذه المثابة في حياة البشر وفي اجتماعهم فهو يقترح: “لو دعيت المدينة العظمى التي ينشدها مدينة الحرية، وأطُلقت على شوارعها أسماءُ رسل الحرية وأبطالها في كل زمان ومكان”([23]). وليس أجدر من المدينة العظمى مدينة تعنى بالحرية وتكفلها لكل من وطأ أرضها شريطة أن لا يمس حق الآخرين في الحرية كذلك، سواء منها حرية الدين، وحرية الصحافة، وحرية الخطابة، وحرية التعليم، وحرية العلم… ذلك بنظر الريحاني هو مهماز تقدمها وسبيل ارتقائها وارتفاع مكانتها… بالحرية، يتعزز وجودها، وتسمو في قوتها، وترتفع في فضائلها وأهدافها، ويكتب لها الوجود والدوام([24]).
ولا يجد الريحاني، وهو المطلع على تراث الغرب الحديث فيما يتصل بطبيعة الحرية وجوهرها، ضرورةً في الانشغال بتوضيح ما تعنيه وتدل عليه، ولا يجد نفسه ملزماً بتفصيل ما يقصد منها من مضامين وأبعاد… فلقد بات مفهوم الحرية في زمنه أحد أكثر المفاهيم الإنسانية وضوحاً وأشدها التصاقاً بجوهر الوجود الإنساني وأقربها إلى ضميره وألصقها بتجربته… تمنحه طبيعته تصوراً شديد الوضوح لماهيتها، ومغزى عميقاً لطبيعتها وما تعنيه. ولأجل ذلك.. فنحن لا نقع عنده إلا على حديث مسهب عميق حول شروط تحققها ووسائل إنجازها والأسباب التي تكفلها، ونظر عميق في آثارها ونتائجها ومجلوباتها النافعة العظيمة فيما يتصل بالاجتماع البشري، وبمقاصد الحياة وأهدافها، وفيما يرتبط بالسعادة.
تقوم الحرية عنده على ثالوث الضمير الحي والإيمان الحي والدستور الحي، وهو ثالوث ترتكز إليه الحرية في كل أبعادها الروحية والأدبية والمدنية([25]).
وهي فضيلة لا تلتقط بالبداهة، ولا تتحقق بالصدفة، ولا تجلبها الأماني والآمال، بل تغرس في النفوس بالتربية والتعليم، وترسخ بالتجربة والممارسة، تغرس في نفوس أبناء المدينة في المنزل ثم ترسخ في مدارسها بالتربية والتهذيب والعلم الصحيح([26]).
وللحرية شروط بها توجد في المدينة وتتحقق، وهي آثارها التي تتبدى من خلالها وتظهر، فلا حرية بدونها مجتمعة… متى تحققت هذه الآثار بانت الحرية وأسفرت عن وجهها، وأفضت إلى الخير الذي تقود إليه والسعادة التي تترتب عليها.. والنفع الذي تولده. والآثار هذه هي:
– ألا يكون في المدينة رق ولا نخاسة.
– أن ينتفي الظلم، فلا حرية مع حاكم ظالم، وسلطان مستبد قاهر، وهيمنة تقاليد بالية وخرافات([27]).
– أن يكون كل فرد سلطاناً على نفسه.
– أن تتحقق حرية القول والفعل والضمير.
– أن يترسخ الحب بدل الكراهية والتعصب.
– أن يكثر وجود الأمهات الواعيات اللائي لا يعلمن أولادهن الخرافة والكذب والمراوغة، أو بعبارة أن تتحقق التربية السليمة على الحقيقة والصدق والأمانة.
_ أن تتحرر المدينة من البطش والتسلط الدينيين، وعسف أصحاب الكهانة([28]).
والحرية عند الريحاني، كما يبدو من آثارها، ليست مجرد مظهر مادي يتبدى في رفاهية عارضة شكلية وإشباع متعسف للحاجات، ولا في المشاركة الشكلية في تجربة السياسي، إنها في الجوهر ذات مغزى روحي ــ معنوي، هي تعني أولاً تحرر الضمير من الأنانية والجشع، وتحرر الإرادة من الخوف والاستلاب، وتحرر العقول من الخرافة والخداع، وتحرر النفوس من الإحساس بالانهزام واليأس. وهذا المضمون العميق للحرية هو الشرط الأساسي لكل حرية أخرى. فلا معنى للتحرر من الاستبداد مثلاً، من دون تحرير العقول والأرواح والإرادات. يقول:
إن الثورة الفرنسية كانت إحدى نتائج الثورة الروحية التي أطلقت ضمير الإنسان من قُيُود الخرافة السوداء، وعقلَه من قيود السلطة الصماء، وقلبه من قيود الطاعة العمياء… إن الحرية الروحية هي رسول الحرية السياسية… أيعد حراً من لا يستطيع أن يبدي رأياً مخالفاً لرأي سيده؟ أيعد حراً من لا يملك نفسه، ومن لا رأي ولا روح له؟ أوَ يحسب حراً من كان وجدانه مقيداً بوجدان مَنْ يتوقف عليه معاشه؟… الحرية الروحية هي أن تكون روحُ كل امرئ بيده وتصرفه، لا محجوزة ولا موقوفة ولا مباعة ولا مرهونة([29]).
والحرية على أهمية ما تشكل من ضرورة لسعادة الإنسان ورقيه، ولفعله وإنجازه، ولتقدمه ونجاحه، فهي ليست بلا حدود… ولا تقاس تجربتها من غير قانون يضبط إيقاعها، ويوفر لها مسالكها النبيلة، ويرسم لها مسارها. بل هي “محدودة بالناموس والتربية”([30]) ، إذ بدون الناموس يستبد الحاكم ويتوغل في الطغيان، وبدون التهذيب والتربية يتسيب الشعب ويمعن في العصيان… فالناموس القويم الحيُّ والتهذيب القويم الحي حصنا الحرية المنيعان”. ولا يقصد الريحاني بالناموس القانون الذي يسير حياة البشر وينظم عيشهم ويقوم عليه التدبير الاعتباري، بل هو عنده ” أحد حدي الحرية، الذي تمثله الحكمة في الدستور، ويمثله الدين في الإيمان، وتمثله الإنسانية في الضمير. فالضميرُ الحيُّ والإيمان الحي والدستور الحي، مجتمعة ، هي الدعائمُ الثلاثة التي تقوم عليها الحرية الروحية والأدبية والدينية”([31]).
ولأن الحرية لها هذه المكانة، فلا قيمة عندها لمدينة يكون همُّها تكريس الخضوع للحاكم مهما كانت مزاياه، ولا الرضوخ والطاعة لمبادئ وتشريعات يطلقها الفلاسفة والحكماء والعلماء ويشرعونها، مهما كانت مجلوباتها فيما يتصل بالسعادة المادية وحسن العيش. فلا فضيلة بلا حرية. والطاعة الشاملة تقضي في العمران بالخمول والكسل، وتغيِّب الإبداع والخلاقية والإنجاز، وتقود المدينة إلى سكون أشبه ما يكون بالموت، والمجتمع إلى أن يصبح مجرد آلة تحركها إرادة الحاكم، طاغية كانت أم عادلاً، فيلسوفاُ كان أم نبياً، توفَّر فيها رغد العيش أم لم يتوفر…
وبذلك تفترق مدينة الريحاني عن مدينة أفلاطون والفارابي مدينتهما سكونيتان آليتان، تجريان على نسق واحد رتيب، لا حياة فيه ولا روح، لا عاطفة ولا شعور، لا مبادرة حرّة ولا إرادة فاعلة، وطموح أفرادها الانقياد والطاعة لمن يعتقد أنه يتوفر على معاني الفضيلة في أبلغ صورها، ولمن تجسدت فيه صور الإنسانية في أسمى دلالاتها. أفراد مجردون من الرغبة والطموح، ومن السعي والمكابدة، ومن المشاركة والفعل، ومن الصنع والتقدير، ومن التأمل والتفكير. وأول كل ذلك، من كل إحساس بالشعور بالذات الذي هو أساس كل عمران ومدنية وتقدم.
وإذا كانت الحرية شرط المدينة، وروحها، فلا تقوم المدينة حسب الريحاني، إلا على احترام حرية الإنسان وقدرته على العمل وخلق المناخ الملائم لاختيار الوظيفة الحياتية التي يرتضيها، في مدينة ديموقراطية تمارس فيها الأمة حقها في حكم نفسها واختيار نظامها… والمشاركة في وظيفة تدبيرها، ذلك أن النظام الديمقراطي ــ بنظره ــ هو الذي يحقق أرفع ما يمكن من مراتب الكمال الإنساني في المدينة العظمى، ويحقق أسمى درجات العدالة الاجتماعية والمساواة([32]).
– العدل والإنصاف:
والمدينة العظمى هي مدينة العدل والإنصاف، وهما من أشرف السجايا البشرية وأعظمها. ومن أثارهما أن يقبل المرء الحق ولو على نفسه، ويتقبل الجزاء راضياً معترفاً بذنبه. والذي يشعر بذنبه ويقبل الجزاء راضياً صابراً لأشرف ممن يشعر بحقه ويُطالب به، وإن من يطلب العدل لنفسه فقط يكشف عن نقص في خُلُقه وأدبه([33]).
ليس العدل إذن أن يطلب المرء الحق لنفسه ولو كان مستحقاً، إنما أن يحب كذلك الخير للناس كما يحبه لنفسه، وأن يطلب الحق حيث يحب أن يكون، وأن يصبو إلى الإنصاف ولو وقع عليه أثره، وأن يتحمل ما يستحقه من الجزاء حين يقتضي العدل ذلك ويستوجبه، برضا ضمير وتسامح ذات وسكينة نفس وتسليم.
ومن ثمرات ذلك في كل اجتماع أن تقوى لحمة التعاضد والتعاون والتساند بين بنيه، وتشتد بين أفراده رابطة المحبة والإخاء، وبهما يقوى الترابط الاجتماعي ويتماسك، فيقود المدينة في مسالك القوة والمنعة والثبات.
ولعلَّ تقرير الريحاني مثل هذا المعنى للآثار المترتبة على العدالة نابع من إيمانه العميق بأن إحساس البشر بالمساواة في مواجهة ما يتطلبه تطبيق العدالة ويقتضيه يولد في نفوسهم الرضا والطمأنينة، ويشعرهم بالكرامة والقيمة، ويبعدهم عن الانجراح الذاتي والإحساس بامتهان الكرامة النائشين من التمييز، وهو شيء يتبدى حجم أهميته في انشغال الفلسفة السياسية المعاصرة على العدالة والإنصاف في سياق مجتمع ديموقراطي متنوع يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، ويستند إلى الأخلاق السياسية للاعتراف، ارتكازاً على قيم الكرامة البشرية والحقوق المتولدة عنها.
والعدل في مساره العملي ــ حسب الريحاني ــ يقتضي توزيع الخير العام على الشعب… وأن تعود إليه منافعه، وأن ينال كل واحد الحق الذي يستحقه منه، وأن تتاح له فرصة الانتفاع من ثماره والاستفادة من مجلوباته، بلا عسف ولا قهر ولا منع ولا تمييز… وأن توفر سبل توزيعه بما يقتضيه الإنصاف… ووفق ما تمليه الحاجة والضرورات…. مرشَّداً عبر تدبير عقلاني لتوزيع الخير، ولتعميم الانتفاع به.
ومثل هذا التدبير العقلاني العادل للثروة يسمح ــ حسب الريحاني ــ بأن ينعم كل مواطن بالطاقات التي يحتويها المجتمع مادية كانت أو معنوية، عينية كانت أو أدبية، وبالمنافع التي يتوفر عليها.. وإذا تم ذلك كفى الخير وفاض، وزاد وارتفع، وتعاظم وأثمر. “ألا ينبغي ــ حسب الريحاني ــ أن يكون الكل على كفاية؟ ؟ كم يموت من الممتولين بالانتفاخ ومن المساكين بالضمور؟ متى تتساوى الأعضاء وتتوازن فتظهر على الجميع علائمُ الجمال ودلائلُ الكمال؟ لا أظن ذاك اليوم يراني ويراك، ولكنني أؤكد أنه آتٍ… وكل آتٍ قريب”([34]).
والتدبير العقلاني لتوزيع الخير الذي يكفل المساواة لا يقصد منه الريحاني المساواة في الحصول على الريوع، بل المساواة في الفرص، بأن يلقى كل فرد في المدينة الفرصة نفسها في التعليم والعلاج والعمل، والحد الأدنى للمعيشة… وأي تمييز بين الأفراد يتطلبه الاجتماع فهو إنما يكون في المآثر والمبرات والخيرات، وفي الأفعال والآداب والأخلاق، لا بالغنى والفقر، ولا بالحرية والعبودية، ولا بالمكانة والمنزلة، ولا بالنسب والشرف، ولا بالدين والطائفة… هذا ما يفرضه احترام الإنسان من مراتب الأخوة([35])، أن يتساووا في الحقوق والواجبات، لا يفرق بينهم في الجنس والأصل، ولا في اللغة والدين، ولا في المعتقد والمنزلة([36]).
وبالمساواة والعدالة يستقيم الاجتماع على قواعده، ويقوم على دعائم لا وهن فيها ولا ضعف، ولا التواء ولا نقص. وتقوم الحرية في أبلغ صورها، وتسود الأخوة، ويشيع الإحسان، “فيعرف كل امرئ مقامه، ويجازى كل امرئ على عمله”([37])، ويندفع كل فرد إلى عمله بإخلاص وإتقان، ويعرف كل منا مقامه، ويجازى كل منا على عمله بعدل وإنصاف([38]).
– أخلاق المدينة العظمى:
ما هي أخلاق المدينة العظمى، ما هي أصولها، وكيف ترتقي؟. ما هي عوامل فسادها؟ وكيف تصلح إذا فسدت في الأمة؟
الخُلُق على الإطلاق ما يظهر في الفكر والنفس من معاني الفضيلة، وهو الطبع والسجية والمروءة والعادة والدين. هكذا يعرِّف الريحاني الخلق على عمومه واتساعه([39]).
وهو يعتقد أن الأخلاق السليمة السامية سياج كل الحقوق وأهم أركان العمران، وهي “نور العدل في الملك، ونور الإيمان في الدين، ونور الصدق في العلوم، ونور الحياة الحقة في أمة المدينة العظمى”([40]).
والأخلاق مادية وروحية، ومصدر المادة فيها لم يزل غامضاً كمصدر الروح سواء بسواء، لكنها في جوهرها قوى كامنة في النفس تؤثر فيها الحوادث والأشياء فتظهر عفواً لغرض أوليٍّ هو ارتياحُ النفس واطمئنانها، من غير أن يطمح صاحبها بادئ ذي بدء إلى معالي المجد أو الغنى أو السيادة([41]).
وأصول الأخلاق السامية خالدة في النفس، تتجلى في استطلاع ما وراء الطبيعة لإصلاح شؤون المدينة ولرفع شأن أبنائها([42])، وهي في نشوئها ونموها وارتقائها، أو في زوالها وانكفائها واحتجابها، خاضعة، مثل مظاهر الكون، لعوامل داخلية وخارجية([43])، ودعامتا الأخلاق في المدينة العظمى هما الحرية والاستقلال([44]).
والريحاني في مذهبه الأخلاقي متأثر بالرواقية التي يقوم مذهبها على بناء الحياة الأخلاقية استناداً إلى فهم عميق للميول الطبيعية واستناداً إليها، ووفاقاً للعقل المنسجم مع نفسه، الذي يتبدى في شكل حياة كذلك متَّسقة مع نفسها ومنسجمة، تبحث عن السبل التي تقود إلى السعادة في حياة الإرادة نفسها وسلطانها الفريد.
ومثل هذا النمط من التفكير في السعادة، القائمة على الحياة الأخلاقية الرواقية، ينسجم غاية الانسجام مع الطريقة التي يتأمل بها الريحاني العالم، حيث يرى أن الأخلاق تنبع من الوجدان ومن صوت الضمير ومن الإنصات إلى نداء الفطرة والطبيعة ومن جوهر العقل الفريد الذي تتمتع به، وأن السعادة في جوهرها نتيجة حتمية لتوقد الإرادة وتألقها وتنميتها وتهذيبها وتوازنها وانسجام عناصرها.
فلا سعادة إذن في المدينة بلا أخلاق، ولا خير يرتجى مع غياب الفضيلة واندثارها، ولا عدالة إن هي تلاشت أو أصابها الضعف والوهن والذبول… بالأخلاق تنهض الأمم، وبالفضيلة تبلغ مجدها، ومن خلالهما تحقق آمالها وما ترجوه.
– العلم والتربية في المدينة العظمى:
لا خير إلا في العلم والتعليم، ولا خلاص من الاستبداد إلا بهما.. ” تعليم مرؤوسي المدينة الحكمة والعدل والفضيلة خير من التنديد بالرئيس ومعارضة أحكامه، لأنه إذا خلع الظالم وظل الشعب جاهلاً، قعد مقعده ظالم آخر… إن تهذيب الشعب وتعليمه حقوقه وواجباته يُضعف الحكم الاستبدادي ويُلاشيه بالتدريج”([45]).هذه ثمرة من ثمرات العلم حسب الريحاني، ونتيجة من نتائج التربية نافعة ومفيدة.
وبالعلم كذلك يقضى على الفساد([46])، لأن العلم هو النور الذي يكشف للأبصار حقيقة الأشياء والوجود، ويُري الإنسان الكون الأكبر ويهديه ذرى الفكر… والقوة المحركة لإنسان المدينة كما هو حال الماء والغذاء والهواء… وبدونه يطغى الجهل ويشيع التخلف ويعم الظلام([47]).
ومن دون العلم كذلك، لا تقدم ولا ازدهار ولا مدنية، فالنافع منه يصلح الأبدان حين يزيل منها الآلام ويخفف عنها الشدائد([48])، ويأخذ بيد الإنسان إلى الخير والتطور، ويرفع عنه كابوس الجهل والتقليد، وينمي العقول بمعارف سليمة صحيحة تساعد في التقدم وتواكب التجدد وتقضي على التخلف والكسل والخنوع([49]). ولأجل ذلك كان العلم عمادَ المدينة العظمى وركيزتها التي لا تقوم إلا بها ولا تنهض إلا استناداً إليها ولا تدوم وتستمر إلا بالتمسك بها([50]) ولا تستنير عقول أبنائها إلا بواسطتها،ولا تنمو مواردها وتزدهر مرافقها إلا بسببها([51]).
ميزة المدينة العظمى إذن نزعتها الشديدة إلى العلم، والطموح إلى المآثر العلمية، والشوق إلى استطلاع ما وراء الأشياء واكتشاف أسرار الطبيعة لتسخير ما فيها من القوى الكامنة، خدمة للرقي ولتقدم العمران… ولا فضل ــ حسب الريحاني ــ لأمة مدينة على أخرى إلا بما أحرزته من خطير الأمور في مضمار الفكر والبحث والعلم، وبما أكسبها نوابغها من مجد في سبيل الإنسانية([52]). وإذا كان للعلم هذه المكانة في المدينة العظمى، فللعلماء فضل التقدم والريادة والسبق، بهم تستنير المدينة وتضيء “وهم المُحبون للبشريية إذ يقدمون أنفسهم للامتحان والتجربة، ويُفدون العلم بأنفسهم، هم الشهداء الذين يستحقون إكليل الغار وهالة القداسة”([53]).
وإذا كان الجاهل بذرة عقيمة تعود بالممات جماداً، فالعالم فكر حي يستثمر بعد الموت حباً مثمراً، موت الجاهل هو المحطة الأخيرة في رحلة الحياة، وموت العالم المحطة الأولى في رحلة الفكر الروحية… هو نبراس الفكر في بواكير استكشافه لحقائق الوجود، وهو دليل العقل في نموه وتوقده وازدهاره. وبالتربية والتهذيب ينمو العلم ويزدهر وتتعزز مكانته. في مدارس المدينة العظمى يسمو ويتطور، وفي معاهدها يربو وتزداد ثماره ويدنو قطافه… في ميادين الحياة كلها الروحية والمادية، وفي مسارات الاجتماع المتنوعة المختلفة([54]).
– الأدب والشعر، في المدينة العظمى:
– مكانة الكاتب:
يقسِّم الريحاني الكاتب ــ بحسب الغاية ــ إلى ثلاثة أصناف، من يكتب ليعيش، ومن يعيش ليكتب، ومن يعيش ويكتب. والأول “لا يكتب شيئاً يذكر فيؤثر، هو كاتب مأجور يحرك يراعه كيفما شاء سيده، هو حوذي الأدب يعلق على عربة علمه تعريفة الحكومة، ويسوق القلم كيفما شاء الراكب وإلى حيث يشاء([55])“.
والثاني:
“تكثر الفائدة في تأليفه وتصغرُ، بقدر ما يعيش الواحد منهم قريباً من الحياة البشرية المتحركة والطبيعية الساكنة، فالذي يعيش في مكتبه بين الكتب والأوراق والمحابر بعيداً عن حركة الحياة ومظاهرها ويصنف كثيراً، لا يعيش حقّاً، وهو يسقط في كثرة تأليفه سقطة الكاتب الأول في مقالاته المأجورة. وبين هذا وذاك، شيءٌ من النسبة والقرابة، فكلاهما يكتب ما يُنسى بعد القراءة الأوُلى، وكلاهما أسيرُ قلم يُمارس الكتابة والتأليف كما يمارس التاجر تجارته والدباغ صناعته والفلاح فلاحته([56])“.
ثم يتساءل: ” فمن من هؤلاء كلهم يتفرغ مثلًا للذَّات العقلية والتأملات الروحية أو الرياضات الجسدية؟. من منهم يَخرج من دائرته الخاصة إلى حقول الحياة ورياضها؟. ومن منهم يخرج إلى الطبيعة ليقرأ في كتابها النفيس الفريد صفحة كل يوم أو صفحتين؟([57])“.
أما الكاتب الثالث: “فهو الذي فيقسم وقته تقسيماً حكيماً فيعطي منه للطبيعة وللحياة وللأدب، ويعيش
حياة العقل والروح والجسد، وهو لا يكتب إلا في ساعة الإلهام والوحي”([58]).
ويقسم الريحاني الكاتب كذلك ــ على أساس الرضا ــ إلى صنفين؛ الأول يكتب ليُرضي الناس، والثاني ليُرضِيَ نفسه. والأول يحتاج إلى معرفة قرائه وما نشئوا عليه من تهذيب وأخلاق، ولا يهمه إن اختلفت مذاهبُهم أو اتفقت، تباينتْ مزاياهم أو اتحدت، تضاربت دوافعهم أو اجتمعت. فهو لا يجاريهم على ما يشاؤون، يخوض عباب البحر جارياً مع الأمواج، سائرًا مع التيار العام.. ومعظمُ ما ينبغي له درسه ينحصر في أحوال أبناء المدنية الاجتماعية وأذواقهم العادية، فيكتب ما يلائم ذلك ويبسم ساخراً، وهو يسوقُ بين التهكم والمجون يراعه. والكاتب الحق ــ حسب الريحاني ــ هو الذي يكتب ليرضي نفسه، وهو يحتاج من المطالعة أوسعها، ومن الدرس أكثره، ومن البحث والتنقيب أدقه، ومن الجراءة الأدبية أَشَدَّهَا.
الأول يتملق ويجامل ويمدح ويثني، والثاني يحافظ على كرامة الأدب ليُعزِّزَ ما عنده من العلم، ويبثه دون مراوغة ومحاباة..([59]) الأول ينقض بأعماله ما اكتسبه من العلم، ويمسي بعد ذلك كالعامة، يقف لا ليفيدهم بل لِيَسْلُكَ مسلكهم ويقتفيَ أَثَرَهُمْ. والثاني يدرس أحوال الأمُّة متأملاً فيفيد إذا كتب، ويصدق إذا انتقد. الأول مسؤولٌ لجيبه فقط والثاني لضميره([60]). وحري ــ حسب الريحاني ــ أن يسمى الثاني الكاتب الحر في المدينة العظمى، وهو العالم الحقيقي الذي ينفع الناس بنتاج علمه وثمار بحثه ودروسه، ويفيد شعب المدينة محافظاً على كرامة العلم، يقول قوله ولو عاكس العامة وخالف أذواق الأفراد، وأهواء ذوي السيادة… هو يكتب للمستقبل لا ليجازى في الحاضر، هوذا إذن كاتب المدينة العظمى([61]).
– الشعر في المدينة العظمى : ولقد اهتم الريحاني بالشعر اهتماماً خاصاً، وكان له فيه نظرات ثاقبة عميقة بثها في ثنايا نصوصه، لكن ما يعنينا هنا ، منها، هو مكانة الشعر عنده، ومنزلة الشاعر في مدينته ، دوره ووظيفته.
صوت الشاعر في المدينة، هو صوت الأمة، والشاعر الحقيقي هو من يجمع بين جمال الشعر وسمو الفلسفة وحب الإنسانية.”والأمة التي تخلو من مثل هذه الشخصية الجامعة لهذه الأنفس السامية ليست سوى ثور أصم أبكم بين الأمم”([62]).والشعر النافع ــ حسب الريحاني ــ هو الذي يحتوي موقفاً شاملاً من الحياة في أفراحها وأحزانها، في جمالها وقبحها، وأن ينبع من الحياة في تدفقها واندفاعها، لا من الأوهام والأخيلة الفارغة الجوفاء، وأن يهتم بالدوافع الإنسانية والمضامين الكونية متجاوزاً الأنانية وحب الذات([63])، وأن يعتني بقضايا المدينة ومشكلاتها وآلامها وأحلامها، طموحاتها ومقاصدها وآمالها، وأن يعبر عن سمو أهدافها وغاياتها، ونبل قيمها وأخلاقها.
فالشاعر الحق إذن، في المدينة العظمى، هو الذي ينسى ألمه الشخصي عندما يسمع في شعره الألم القومي الإنساني، والذي يتألم لألم أمته ويفرح لفرحها ويرتقي بارتقائها ويسعد بنهضتها ويعتز بإنجازاتها ويصدح بفضائلها([64]). وهو الذي يخرجه ألمه الشخصي من المحيط المحدود ومن قيد الأنانية، ويرتفع به إلى أوج المعرفة والإحساس، فيرى ما في الحياة من مواطن الوحي، والكون كله شعراً إلهياً([65])، وهو الذي يرى في الظل كما يرى نور الشمس، فيستعين بعوامل الحياة الخفية ليلطف الحقائق المستترة، أو يظهر ما كمن فيها من معاني ودلالات([66]).
والشعر الحقيقي، الذي تمتاز به المدينة العظمى وتحتفي بوجوده وتحضنه وترعاه، يشمل الحقيقة والخيال معاً، فتجيء ظلال الحياة فيه مثل الغدير تغشّيه الأعشاب، وتجري في مبانيه الإشارات جري الماء العذب تحت أمواج البحر، فتشاهد طيَّ معانيه صورٌ حقيقية جميلة تشعل العقل والمخيلة… والشعر الخالد هو ما تجلى فيه روح العالم المنظور وغير المنظور… وأثره في النفوس عظيم يرفعها إلى شيء من الروحانية والعقلانية، ويدفع نحو الفضيلة ويزينها، فتسمو به النفوس إلى السعادة الحقيقية والكمال([67]).
– الأدب في المدينة العظمى: أما الأدب، فالملتزم منه ــ حسب الريحاني ــ ما جمع بين الأدب والحياة، بين فعل الكتابة الإبداعية وفعل الاستجابة الفكرية لهموم أمة المدينة العظمى، ومشكلات أبنائها، والانخراط في قضايا المجتمع وشؤونه([68]). والأدب عند الريحاني ليس هدفاً مستقلاً، بل وسيلة لغرض أسمى متشعب، مركب ومتداخل، يتراوح بين البعد القومي المحدود والبعد الإنساني الشامل، وكلاهما يطمحان إلى تحرير الإنسان من عبودياته الجوهرية والعرضية([69]).
وللأدب الملتزم عناصر أربعة، فلا يسَف في معانيه إسفافاً، ولا يساير معها أذواق الناس وتجدد حياتهم، ولا يسرف في العواطف المتأججة والخيالات الجامحة، ولا يضيع في متاهات الألفاظ الرنانة فيفقد دوره الإنساني.فلا بد إذن في كل أدب ملتزم في المدينة العظمى من توازن الفكر والشعور، وارتباط الخيال بالحقيقة، والرمز بالمرموز([70])،ولا بد كذلك من أن يتحرر من كل القيود التي تمنعه من الخلق والإبداع، وتحول بينه وبين الفكر الحر والقول الحر والبحث الحر، مجرداً من كل تحزب أو تعصب أو أهواء([71]).
ولمثل هذا الأدب قوة روحية خفية لا تظهر عواملها في المجتمع الإنساني دفعة واحدة، كما تظهر عوامل السياسة، بل رويداً رويداً وبطرائق غامضة لا تكاد تدرك، وإن لكل غرس أدبي ثمرة تنضج في أوانها([72]).
وفي خلاصة القول، الأدب في غاياته النبيلة السامية وسيلة بحث في أمة المدينة، وميدان تفاعل وقاد مع حياة المجتمع، وصورة صادقة من صور حراكه، وتعبير حقيقي عن الآمال والأحلام والطموحات والهواجس والرؤى، تتلاقى فيه شتى النوازع، وينفتح على آفاق الإنسانية الرحبة وميادينها الفسيحة.
– الدين في المدينة العظمى، (فضاء الروح وبث الحب):
الدين حسب الريحاني في شعور خفي يألفه الكائن بين الذات المحدودة والكون غير المحدود، وهو ناموس الحياة وأعمق عاطفة في قلب الإنسان([73])…
وكل ديانة إنما يتحقق فيها الخير بمقدار ما تخدم الغرض السامي لمؤسسيها، وإنما تكون مزيفة باطلة متى ما كانت تخدم الغرض الأناني لكبار كهنتها… لأن الدين الحق المعاملة وخدمة الإنسان([74])، والديانة التي تستطيع أن تجعل المتوحش طيباً أليفاً تخدم غرضها خدمة جليلة([75]).
وأول ما يتمثل في الحياة من حقيقة الدين، إنما يتبدى في حقيقة الحب الذي ينتزع الإنسان من إنانيته ويجعله ينفتح على الغير ويؤاخيه ويقربه من الله، وفي الوعي الروحي بين الإنسان وخالقه([76]).. الذي ينير القلب والضمير فيهديهما في الحياة الدنيا خير طريق إلى خير الأبواب([77]).
ويميز الريحاني بين جوهر الدين وسمو معناه وشمول قيمه وفضائله ووحدة النزوع الروحي الذي يمثله، وبين العقائد المختلفة والمذاهب والآراء التي تولدت في رحابه وعلى هامشه، وأمعن البشر في ترسيخها والتعصب لها والدفاع عنها كحائق مقدسة لا يمسها نقاش ولا تساؤل ولا يشكك فيها.
وهو يرى في الأديان المتنوعة والعقائد المختلفة هذه ما هو أعمق فيها من المظاهر والأشكال.. في كل دين جوهر روحي سامٍ يلتقي مع ما تعبر عنه الأديان الأخرى من حقيقة روحية عميقة وسامية، وما تنطوي عليه وتحتويه من جوهر أصيل.. كل الأديان ــ عنده ــ مختلفة لدين واحد في الأساس، هو جوهر الديانات كلها، وبعدها الروحي الأسمى، وحقيقتها الراسخة الخالدة “وهي حقيقة واحدة لا تتغير مهما كثرت العقائد وتضاربت الآراء… الدين حقيقة تجمع لا عقيدة تفرق”([78]).
وما يتجلى من حقيقة الأديان فيما تمثله من وحدة جوهرها إنما يتجلى في كلياتها ومبادئها وأصولها، لا في فروعها وجزئياتها([79]). هنا يتجسد جوهر الحقيقة الكلية الواحدة للأديان، وعليها ينبغي أن يقوم كل شعور ديني، واستناداً إلهيا يجب أن تنهض التجربة الروحية المعنوية لأبناء المدينة، وبذلك ينتفي التعصب والكراهية اللذان يولدها الفهم المجتزأ الناقص لجوهر الدين وما يعنيه ويقوم عليه من حب وعاطفة وشعور إنساني “إن الدين كل الدين في الاتصال بهذه الروح، والاستنارة من أنوارها.. عندما يدرك الناس ذلك، ويقلعون عن التعبد الظاهري، ويقبلون على التأمل والسلوك… وينبذون العقائد ويتمسكون بالحقيقة، ويتحررون من الخرافات، ويتقربون إلى الله بالفكر والعمل الصالح([80]).
ولأن الدين علاقة وصل، ومبدأ اتحاد، وسمو روحي يولد المحبة ويستجلبها ويحث عليها، فلقد نبذ الريحاني التعصب الديني والطائفي والمذهبي، ودعا إنسان المدينة العظمى دعوة شاملة إلى الأصول الروحية ونبذ قشور العصبية والمتاجرة بروح الدين، وأن يزيل من أعماق هذا التعصب ما علق فيها من حكايات الآباء والأجداد، فقال: “ارفع عن رأسك الإعلانات الطائفية، أمح عن صفحات قلبك ما خَطَّهُ أجدادُك من كلام الغَيْرَة والتعصب”([81]).
ولأن المذاهب مجلبة الفرقة وأس التعصب، فلا وجود ــ حسب الريحاني ــ للمذاهب التي تعلم الأثرة والبغضاء والخرافة والخوف من الله في المدينة العظمى ، الدين في المدينة واحد إلهي ــ إنساني… يُعلم الورع والحب، وكلماته قليلة وأنواره كثيرة، تقرب الإنسان من ربه ومن أخيه الإنسان في كل مكان([82]).
فالدين لازم إذن لأبناء المدينة واجب، بل هو ضرورة اجتماعية لهم، لكن من غير أن يفسر استناداً إلى التعصب والتفرقة والكراهية، وشرط أن تستلهم أبعاده الروحية والإنسانية في خدمة الإنسان وخيره، وفضيلته المعنوية الإلهية في سبيل سعادته ورقيه، ومن أجل ترسيخ أخوة الإنسان وكرامته([83]).
وإذْ اعتبر الريحاني الدين وسيلة تحرر للنفوس البشرية من الحقد والكراهية والبغضاء والتعصب، ومشعلاً ينير دروب الروح ويوقد فيها الشعور بالأخوة والمحبة والإحسان، فلقد اصطدم برجال الدين الذي يستخدمون ــ بحسبه ــ سلطتهم من أجل القهر والرفاه والاستبداد.. ولمآرب شخصية تتصل بالنفوذ والسلطان.. ويفسدون التعاليم الدينية، ويستخرجون من الدين قواعد تمكنهم من الضغط على النفوس والعقول لتكون لهم سلطة عليها ما أنزل الله بها من سلطان([84]). وهؤلاء يتنافى وعظهم مع سلوكهم، ويتفاوت عندهم القول والعمل، ويبشرون بالقناعة ويجمعون المال، وينهون عن الشر ولا يعملون عملاً مجرداً عن الغايات الشخصية، يأمرون بالصوم والتقشف ويسرفون، يبشرون بالمحبة ويتكبرون”([85])وما يطلب من هؤلاء ليكونوا منسجمين مع ما يدَّعون تمثيله من حقيقة الدين وصفائه وسمو فضيلته “أن يستخدموا سلطتهم لتعزيز العدل، وتأييد الحق، ورفع الظلم عن الفقراء والضعفاء.. وبث روح التهذيب والعلم في الأمة…([86])“.
والريحاني ليس له موقف شخصي من الإكليروس، ولا هو يقاومه لأغراض خصوصية، ولا ينتقده لمآرب خاصة ومنافع يبغيها.. وسيكون أول من يعترف له بالفضل متى ما كان رجال الإكليروس من رجاله، وأول من يخضع لسلطانه متى يستخدم ليعزز العدل ويؤيد الحق ويرفع الظلم، ويبث روح التهذيب والعلم في الأمة…([87]).
ولأن موقف الريحاني ليس من رجال الدين بما هم كذلك، ولا من كل من يدعي انتساباً إلى الإكليروس… ولأن موقفه النقدي ليس من الدين نفسه، بل من استخدامه والانتفاع به والارتزاق من خلاله.. فإنه يميز في هذه الطبقة بين متعصبين متسامحين، بين مخلصين ومنتفعين، بين من يقصد خدمة الإنسان والارتقاء به، وبين من يقصد السلطان والنفوذ والرفاه. والمخلصون منهم هم ملح الأرض، وخير الناس قولاً وعملاً في كل ما ينفع الناس”([88]).
ورفض الريحاني لكل تعصب ديني قائم على قناعة راسخة بمبدأ التسامح والاعتراف… وهو كان يطلق عليه لفظ التساهل، ويقصد فنه الانفتاح على ما يمكن أن يقبله العقل.. بمرونة وتواضع ذات وسلامة ضمير([89]).
ولا قيام ــ بحسبه ــ لمجتمع من دونه.. ولا تستقيم مدينة متى ما غاب واحتجب.. ولا تنهض أمة إن لم تجعل التساهل عنوان حياتها، ومبدأ تعاملها، وركيزة عيشها، وفضيلة كل علاقة واتصال([90]).
يقول مخاطباً رجال الدين مشجعاً إياهم على هداية الناس إلى المحبة والتضامن والألفة والمودة في مدينته العظمى معظماً التسامح معتداً به..: “متى نؤلف جمعية للتساهل، ونشيد مدرسة التساهل، ونؤسس جريدة التساهل؟.. لو كان لي ألف كتاب وتكلمت من الآن إلى يوم الدين لما عييت من ترداد هذه اللفظة العذبة السهلة اللطيفة”([91]).
هذه هي حقائق الأديان التي تقوم عليها المدينة العظمى إذن.. هي “كبح النفس ونقاء القلب والإخلاص والبساطة والإحساس وشهادة الروح، والعافية السليمة في الجسم والعقل.. هذه هي الفضائل القديمة الجميلة وهي الحقائق العليا لكتب الوحي”([92]).
– الحب في المدينة العظمى:
وكما لا تقوم المدينة عند الريحاني إلا بالتساهل والأخوة الإنسانية والشفقة والإحسان، فهي كذلك لا تقوم إلا بالحب، وهو نوعان، مادي وإلهي.
والأول: “هوًى ووَلَهٌ يتبعهما تثاؤبٌ وقرف، وهو كدبيب النمل تحت الجلد يسبب الحك ويخلف القروح والأورام”([93]). هو من الحب لكنه مجرد اندفاع عاطفة وتوهج رغبة، واشتعال غريزة.. تتوقد لبرهة عابرة ثم تزول.. وهي لا تترك أثراً يعتد به فيما يتصل بأهداف الإنسانية السامية وبمقاصد الحياة الاجتماعية، وبجوهر ما تصبو إليه وتندفع نحوه.
والثاني: “حب روحي، إلهي ــ بشري”، وهو في ماهيته الأعمق “سر من أسرار الطبيعة، يخلد في الأرواح السامية الخالدة”([94]) ويتجدد في مدى الزمن، ويتجلى في أسمى العواطف وأنبلها، ويتجسد في أرفع الفضائل وأكملها، كحب الأم والإنسان والوطن، والأخير “يجب أن يكون حباً من أعرق الأرومات وأعمقها، يضاهي حب الأم في عمقه وإلهيته، إذ الإنسان ينتمي إلى الأزل.. والحب السامي الروحي، أعلى صفات الإنسان، فينبغي أن يكون مثله، ليدوم عبر العوالم كلها والإشعاعات الضخة كافة”([95]). ليعبر عن نفسه في التضامن الروحي، والإحسان والتواد والعطف والتعاون والإيثار والتضحية في سبيل المثل الرفيعة وخير الإنسان.
يقول: “تعالوا نحلم أحلاماً جميلة ونحب كما نحلم حبّاً جميلاً، وأن الإنسان يستطيع بقوة الفكر على قوى الطبيعية، ويجد فوق قوة الفكرة قوة، هي قوة الحب”([96]).
وأول مراتب الحب عظمة وقداسة هي محبة الإنسان التي هي طريق خلاص البشرية، ترفع الإنسان إلى الذرى في المستوى الإنساني اللائق، إذ يدرك معها البشر ذات الإله التي تشد الإنسان إلى أخيه الإنسان وتربطه به وتقربه إليه”([97]).
ولا تقوم المحبة على إطلاقها عند الريحاني بلا محبة الإنسان، إذ كيف “تقوم محبة الله تعبر محبة الإنسان؟ هل يستحق أن يكون في ظل الأبوية الإلهية من لا يساعد على تعزيز الإخاء الإنساني في الأرض؟”([98]).
والمدينة العظمى تحتفي بالمحبة وتمجد أخوة الإنسان، وتعتبر أبناءها من طينة واحدة… لا تنفصم فيهم عراها مهما اضطربت أحوالهم وتباعدت رغائبهم وتضاربت مشاربهم. “مهما جزل خيرك، ومهما تفاقم شرك، لا أزال أخاك، مهما عليت في مدارج الحياة، ومهما تسفلت لا أزال أخُلص لك، وأؤُمن بك، وأحبك. أَفَلَسْت عالمًا بما فيك، بما يأسرك، وبما يناديك؟”([99]).
وإذ توفرت للمدينة مثل هذه الفضائل، فقد اجتمعت لها قوتها المادية والعقلية والروحية، وهي قوة تظهر في أبناء المدينة بمقادير متفاوتة، ولكنها كامنة بلا حدود في كل نفس بشرية.. وفي كل فرد من أفراد المدينة. الفضائل هذه قوى غير محدودة من ينابيع ثلاثة مادية، عقلية وروحية، تتبدى في مظاهر شتى طوعاً لأحوال يعقلها الإنسان، ولأسرار لا تستطيع إدراكها([100]).
هذه هي أهم فضائل المدينة العظمى ومزاياها التي لها حياتها ووجودها وارتقاؤها وتقدمها وسعادة أبنائها. إذن، من هو إنسان هذا المدينة هذا الذي تكفل به هذه الفضائل سعادته، ومن هي أمة المدينة في أوصافها كذلك وفصائلها وفضائلها.
رابعاً- إنسان المدينة العظمى (شعب المدينة):
وإنسان المدينة العظمى حر في فكره وإرادته وعمله، مهيمن على نفسه، مالك زمام الحوادث التي ترفعه فوق أحكام مجتمعه. ولو لم يكن كذلك لكان اعتقاده بالله باطلاً، ولكانت أخلاق البشر كغرائز الحيوان لا يعمل فيها قانون النشوء الحي وعوامل الارتقاء الثابتة([101]). وجدالإنسان لا ليقاد بالزمام، بل ليهتدي بمصابيح العلم والحرية، ويشق طريقه بنفسه.
ولأن إنسان المدينة العظمى مادة وجودها، وأساس بقائها وتقدمها، فعليه أن يشغل فكره بالحاضر وبالمستقبل، وأن ينزع من ذاته التعصب وأسبابه، “وأن يكون محباً دون أن يعلق في ذيل ردائه جدائل الملة” وأن يحب ربه دون أن يبغض أخاه في الإنسانية([102]). ويوصي الريحاني إنسان المدينة بأن ينهض بالفكر من قيود التقاليد، وأن يحرر نفسه من الأوهام، وأن يرفع المجتمع على الحكومة والحكام، وأن يروض أخلاقه للعمل المفيد([103]).
والإنسان الذي تحتاجه المدينة وتقوم عليه هو الذي يستقل بصنعة شريفة يتقنها ما استطاع، ويمارسها باستقامة وقناعة وثبات. يغنيه ذلك عن السعادة الفاسدة التي يطلبها العامة وجمهور الناس… ذلك أن المجد والشهرة تأتي من الحياة البسيطة التي تزينها القناعة وتكللها التأملات الروحية.. وحكيم المدينة العظمى يرى السعادة في عمله، لا في نتيجته المادية، لأن الحياة عند إنسان المدينة أسمى من أن تُزان بالدرهم والدينار، وهي لا تستقيم إلا حينما تخدم غايتها المثالية الفضلى، بأن يعيش الإنسان في اتفاق تام مع الطبيعة ونواميسها([104]).
وعليه فطلب المعالي الروحية هو أسمى الأهداف عند إنسان المدينة العظمى، وهي التي تأتي بالمجد وتقود إليه وتحقق السعادة الحقيقية وتنجزها. أما المعالي الدنيوية فهي لا تأتي إلا بالمجد الباطل، فعليه أن يتبع العلاء الذي يتفق مع النفس، ويجعله مدركاً لما في الطبيعة من نواميس وسنن. العلاء الذي تهمس في أذنه “أنه جزء مفيد من الكون العظيم مهما كانت منزلته منه ومكانته فيه”.
وإنسان المدينة العظمى كذلك، مقدام، لا يتقهقر ولا يهلع ولا يتكل، يشتعل نور الطموح في صدره، ويحث نفسه على العلم والتطور الدائم والارتقاء المستمر… وبذلك تكون سعادته([105]).
وإنسان المدينة([106])، قوي في نفسه لا في أصحابه ولا في منصبه ولا في ثروته.. قوي في ذلك المصدر الإلهي الخفي الذي يستوطن قلبه، وبه وحده يكبر قصده وتعظم همته.
وإنسان المدينة العظمى خيِّر مقدام محسن، وعليه دائماً أن يتذكر أن الغنى في الاستغناء، وأنه إذا أثرى فلا يفوتنه أن الثراء مثل الفقر يذل صاحبه إذا لم يبذل منه في الخير.
وهو إنسان مجرد من الأحقاد والميول الأنانية، يدين بحب الإنسانية جمعاء، يغفر لمن يسيء، ويحب مبغضيه، صفت نفسه وأشرقت على الحقائق الكونية روحه، فنبذت العصبيات واحتقرت العنصريات، وكرهت التفرقة، وألفت التقارب والتعاون والإخاء، وهو يسعى في الخير فيغيث وينصر، ويحب البائس الشريد، يؤمن بالحرية ويرتع في نعيمها، ولا يأنف أن يشاركه في هذا النعم سواه.
وأبناء المدينة العظمى متفائلون، يعتصمون بحبل التفاؤل الذي هو الإيمان بسنة الله التي تهيمن على الكائنات والمخلوقات جميعاً، وتفرض على الإنسان العمل الدائم المستمر الذي به تستقيم الحياة وتتجدد وترتقي.. والمتفائلون ، من أبناء المدينة العظمى، يرون ما وراء الظاهر من الأشياء، يرون ناموساً سرمدياً، ويداً تمتد دائماً إلى العلياء في سبيل الإنسان، وأملاً طلائعه الأنوار السماوية أو ما وراءها من نور الوجود الأعلى، يعملون بهدوء متواضعين في تجديد قوى الإنسان المعنوية والروحية، ولا ينكرون ما يسوء من أحوال الإنسانية في المدينة العظمى، لكنهم يعتقدون أن مبدأ الحياة السامي، أو ناموس المدينة السرمدي، يبقى حياً فيها وإن كان في الظاهر لا يبدي حراكاً([107]).
خامساً- الحاكم في المدينة العظمى:
والحاكم عند الريحاني ليس هو الرئيس الفيلسوف عند أفلاطون، ولا هو الفيلسوف النبي عند الفارابي، هو رجل الشعب وخادم الشعب([108]) ، ولأنه كذلك فهو الحاكم الذي لا ينتخب ولا يعزل ولا يقاوم ولا يموت، إذ تظل روحه حية وعلاماته في الأمة باقية ببقاء أعماله التي تغرس في قلب شعب حي قوي. هو ظل الأمة الذي يداخل قلبه شيء من نور الله، والذي تقوم فيه تلك الروح العظيمة التي تدفع إلى المحاسبة بالعدل والإنصاف([109]).
ولأن الريحاني يؤمن بالارتقاء والتقدم ناموساً تقوم عليه المجتمعات ويحكم حياة الأمم، فهو يرى أن المدينة التي ترتقي فيها الفضائل وترتفع الملكات وتجتمع لها قوة المادة وقوة الروح، قادرة على أن توفر لنفسها حاكماً استثنائياً فذاً، وهو فذ لا لأنه يتميز بالطبيعة والرتبة، ولا لأنه متقدم في الجوهرة والخلقة، بل لأن فيه من القابليات ما يمكن أن يرتفع به إلى الذرى فتتكامل فيه الفضائل وتسمو الملكات وتعتدل قواه، وقد “يأتي يوم يشاهد فيه أبناء الأرض رجل المستقبل العظيم هذا، وقد ترقت فيه القوى الحيوية كلها، الحيوانية والإنسانية والإلهية إلى أرفع الدرجات. ذلك أن الإنسان مُرَكَّبٌ من هذه القوى، وهي كامنة فيه إلى الأبد”([110]).
والدعوة إلى التكامل هنا ليست تعبيراً عن قناعة بتفاوت طبقي، أو تمايز بين أفراد المدينة بالخلقة والطبيعة والتكوين. ولا تعبيراً عن اعتقاد بالتفوق على الآخرين يرتب تمايزاً في المنزلة والمكانة والرتبة. إن التفوق في الأساس ليس سوى التفوق على الذات، إنها دعوة الإنسان المنهزم المسحوق والمنكسر إلى النهوض والتغلب على معوقات تقدمه، وأسباب نكوسه وتراجعه، والانتصار على ما في ذاته من عوامل الضعة والاستكانة والخنوع.
وإذا كان الأمر كذلك، فعلى رجل المستقبل أن يعتني ، ليتفوق على ذاته، بتربية قواه الجسدية والعقلية والروحية على السواء، وأن يجمع بين الحقيقة والخيال، وجمال الصحة والحكمة والشعر، وأن يشترك عقله وقلبه وروحه في كل فعل من أفعاله، وأن يستثمر رأسماله في ميادين الجسد والروح والعقل كلها، ويروض نفسه على الشدائد كما لو كان ذلك من ضرورات الحياة، ويعتمد على نفسه وقدراته، لا يحابي في الحق أحداً، يعيش لربه ولنفسه وللإنسانية.
ولأن رجل الشعب رجل إصلاح وخدمة، فهو وطني صادق غيور على الأمة ومصالحها، محب للبشر، يشبع الجائع ويحرر شعبه من الظلم،ويساوي بين الغني والفقير ويحطم الاحتكار، يعزز تجارة البلاد ويضع الشرائع للكمالات الروحية وتهذيب النفس وترقية الشعور، لأن الحياة الراقية السامية لا تزهر ولا تثمر إذا لم يكن لها في القلب والضمير دعائم قوية.
ففضائل الحكام إذن لا تطلب لنفسها ولا يربى الحكام عليها لمجرد أن تكون مزايا بها يمتازون عن سائر أبناء المدينة، كما هو الحال مع اليوتيوبيين. إن قيمة الفضائل في الرئيس إنما هي فيما تحققه من خير للأمة التي يقوم الحاكم على تدبيرها، فإن أورثت خيراً فهي خير وإلا فلا قيمة لفضيلة لا تورث سوى التمايز ولا تحقق إلا وجوب الطاعة لمن اجتمعت فيه. ولقد وجد الريحاني ضالته في أمير عربي قال لقومه: “اعلموا أنني حاسدت عليكم حتى صرت عبدًا لكم، أغُدق على سائلكم، وأصفح عن جاهلكم، وأحوط حريمكم، وأدفع غريمكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن فعل فوقي فعلي فهو فوقي، ومن فعل دون فعلي فهو دوني”([111]).
تراتب البشر إذن بالأفعال الخيرة وحسن العمل، لا بالفضائل ولا بالطبقات، ولا بالمكانة ولا بالمنزلة، لا فرق بين حاكم ومحكوم أو لا بين أمير ورعية ولا بين رئيس ومرؤوس.. العمل يرفع وهو يخفض، والإنجاز يرتقي بصاحبه إلى الذرى وينحدر به حتى تزول فيه كل فضيلة.. ولأن الحاكم قدوة في العمل فلا تعنيه الرئاسة إلا بمقدار ما تكون خدمة، ولا تكتسب قيمتها إلا حين يتقدم الحاكم أمته إلى فعل الخير.. والإرشاد إليه، ليكون بذلك قدوة به يقتدون.. وليحسُن الخيرُ في نفوسهم فيبادروا إليه، وليزدان في عيونهم فيندفعوا نحوه.. يأخذ بيد الضعيف ويحيط القوي بحسن تدبيره.
والريحاني يتمثل بقول علي حين دخل عليه ابن عباس وهو يخصف نعله: ” لهي أحب إليَّ من إمرتكم إلا أن أقُيم حقّاً أو أدفع باطلاً”.
سادساً- المدينة العظمى أمل دائم:
ولأن المدينة العظمى أمل يرتجى، ولأن ثقة الريحاني بالعقول النيرة والإرادات الحرة كبيرة، فهو لا يستسلم إلى اليأس، مهما كثرت العوائق والصعاب وتعاظمت الخطوب والآلام. فالمدينة العظمى لا تقوم إلا بالعمل الدؤوب والكفاح المستديم وإن طال الزمن، وبالجد والمثابرة وبالعزم والتصميم.. وهو يؤكد ذلك في الرؤية الجميلة التي يذكرها محاوراً فيها أشعيا النبي فيقول:
أولم تقل في رؤساء أوُرشليم إنهم عصاةٌ وشركاء اللصوص وإنهم يحبون الرشوة ويتبعون الأجور وإن الرب سيقطعهم من إسرائيل؟ فأحنى النبيُّ رأسه ثانيةً، فقلت: وها قد مضى على ذلك يا صاحب النبوة ألُوفٌ من السنين والعالم لم يزل كما كان يوم صببت عليه شآبيب غضبك، فأجاب أشعيا قائلًا: إن ألوف السنين التي مرت على نبوءاتي هي كالدقائق في عين لله، والأجيال بالنسبة إلى الأبدية هي كالساعات بالنسبة إلى الأجيال، فلا يريبك كلامي، ردِّد نبوءتي ولا تخف، بَشِّرْ بالمدينة العظمى في بلادي وبلادك ولا تيأس([112]).
والريحاني يذكر هذا الحلم هنا ليؤكد أن الأمل بالإصلاح لا ينبغي أن يفارق عقولنا وأرواحنا، وأن دعوته لا يجوز أن تخبو مهما تعاظمت الخطوب، وأن مجتمعاً يخلو من طموح السعادة والسعي إليها مجتمع ميت لا حياة فيه ولا روح، وليؤكد كذلك على أن النبوة في جوهرها دعوة إصلاح ومقام فضيلة وانتصار لمعنى الروح، وهي لا يخلو من جوهرها نابغة في الناس ولا مصلح ينشد الخير ويروج الفضيلة.. ولأجل ذلك واجه الأنبياء والمصلحون كل أولئك الذين ادعوا سيادة دينية لإخضاع البشر ومراكمة الثروات، من تجار الأديان والكهنة القابضين على صولجان الخرافة، المتوجين بتيجان الجهل والتعصب والطغيان.. ممن أطفاؤوا بأفعالهم جذوة الروح في مجتمع الإنسان، وزورا بانتهاكهم سمو الأديان طهارة الفضيلة التي دعت إليها وعبرت عنها وكافحت من أجلها وفي سبيلها([113]).ويختم أمله هذا بعبارات جميلة متفائلة فيقول:
والمدينة هذه “سيحبل بها الفجر ويولدها النور، فتترعرع في حجر العلم، وتتغذى من ثدي الأدب والدين، هي آتية وكل آت قريب”([114]).
سابعاً- على سبيل الختام:
هذه هي مدينة الريحاني في أجلى صورها. مدينة للروح وللجسد، للعلم وللدين، للشعر وللأدب، للإبداع وللفن، للحرية وللكرامة، للعدل وللإنصاف، للإحسان ولفعل الخيرات، للمحبة وللأخوة، للتواضع وللإيثار، للعمل وللكفاح… مدينة جغرافية طبيعية لا أمر فيها ولا كلمة لغير أبنائها، دولة خُلقية روحية لا أثر فيها لغير الحق، ولا سيادة لغير العدل، ولا وجود لغير الإخاء والسلام.. حكامها أمراء الحكمة والفلسفة والفنون، وشعارها حكومة للشعب لا الشعب للحكومة([115])، يصنعها الإنسان بإرادته الحرة وعزمه الأكيد، وبإيمانه الراسخ بالمستقبل وثقته بنفسه، والتي تقاس فيها فضائل الحاكم بمقدار ما ينجزه لشعبه من خير ويقودهم إليه.
([1])ماريا لويزا برنيري، كتاب المدينة الفاضلة عبر التاريخ، تج عطيات أبو السعود، سلسلة عالم المعرفة العدد 225، سبتمبر 1996، ص25 وبعدها. وحول المدينة الفاضلة عند فلاسفة القرن الثامن عشر، كارل بيكر، المدينة الفاضلة عند فلاسفة القرن الثامن عشر، ترجمة شفيق غربال، القاهرة: مؤسسة فرانكلين 1952م.
([3])علي سعد الله، نظرية الدولة في الفكر الخلدوني، الأردن: دار مجدلاوي 2003م، ص55-85.
– المدينة الفاضلة عبر التاريخ، م.س، ص25 وبعدها.
و- سعد الله، نظرية الدولة في الفكر الخلدوني، م.س، ص39.
و- أفلاطون، الجمهورية، تج حنا خباز، بيروت: دار القلم 1985.
ومحاولة رجل الدين، تج أديب نصور، بيروت 1959م.
وداود خشبة، أفلاطون، قراءة جديدة، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2012م.
Monique Dixsaut, Platon, Le désir de comprendre, librairie philosophique, j. Vrin, Paris, 2003, ch7.
([5])يراجع حول المدينة عند الفاربي:
– الفارابي، “السياسة المدنية” ضمن: رسائل الفارابي، الهند، 1346هـ.
كذلك آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألبير نصري نادي، بيروت، 1959م.
والفارابي، “تلخيص نواميس أفلاطون” ضمن: أفلاطون في الإسلام، نشره عبد الرحمن بدوي،÷ بيروت: دار الأندلس 1982م.
وفضل مخدِّر، الحاكم عند الفارابي، بيروت: دار الأمير، 2016م.
– وسعد الله علي، نظرية الدولة في الفكر الخلدوني، م.س، ص240-242.
– ومصطفى سيد أحمد صقر، نظرية الدولة عند الفارابي، مصر، المنصورية: مكتبة الجلاء الجديدة، 1989م.
و Muhsin Mahdi Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, the University of Chicago press
([6])حول رؤية ابن رشد للدولة يلاحظ:
– ابن رشد، تلخيص السياسة، تج. حسن مجيد العبيدي، وفاطمة كاظم الذهبي، ط1، بيروت: دار الطليعة 1998م.
– ومحمد عابد الجابري، ابن رشد، سيرة وفكر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
– ماجد فخري، ابن رشد، فيلسوف قرطبة، بيروت: 1960م.
([7])حول ابن خلدون، وفكرة الدولة عنده يلاحظ:
– سعد الله، نظرية الدولة في الفكر الخلدوني، م.س، ص87 وبعدها، وحول علاقته بالفارابي، ص230-307.
– ومحمد عابد الجابري، العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
– أمجد جبرون، مفهوم الدولة الإسلامية، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2014م، ص185-257.
([8]) أمين الريحاني، المؤلفات العربية الكاملة (م.ع.ك.)/مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2016م. القوميات/1 مج/1 م ر14، 151. ويقارن: م.ع.ك. / الريحانيات/2 مج/1 م ر81 ، 161-165
([9]) محمد علي موسى، أمين الريحاني، حياته وآثاره، بيروت: الشرق الجديد، 1861م. ص8.
([10]) م.ع.ك. / الريحانيات/1 مج/ 1 م ر217 – 220.
([11]) م.ع.ك./ الريحانيات/1 مج / 1 م ر 220.
([12]) م.ع.ك. / التطرف والإصلاح /”إصلاح الأمة” / مج/5 م ر 240، 25.
([13]) م.ع.ك. / القوميات /2 مج/1 م ر 50 ،17، 32 ،117.
([14]) م.ع.ك. / الريحانيات/ 2 مج/1 / م ر 196. ويقارن: م.ع.ك. / بذور للزارعين / مج/4 م ر 372. و: / الرسائل العربية / مج/5 م ر 580. وأمين ألبرت الريحاني، فيسلوف الفريكة صاحب المدينة العظمى، دار الجيل، بيروت، 1988ـ ص264.
([15]) فيلسوف الفريكة، م.ن، ص294.
([16]) م.ع.ك. / الريحانيات/ 1 مج/ 1 م ر 220 ، 223 ،225.
([17]) م.ع.ك. / الريحانيات/ 1 مج/ 1 م ر 216 – 217.
([18]) م.ع.ك. / الريحانيات/ 1 مج/ 1 م ر 223.
([19]) م.ع.ك. / الريحانيات/ 1 مج/ 1 م ر223.
([20]) م.ع.ك. /الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 229.
([21]) (م.ع.ك. / الريحانيات/ 1 مج/ 1 م ر 229.
([22]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 217.
([23]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 217.
([24]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 123.
([25]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/1 م ر257. ويقارن: / الريحانيات / 2 مج/1 م ر 278. و: / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 535 ،556. و: / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر251.
([26]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 166-167 ،203. ويقارن: / القوميات / 1 مج/ 1 م ر 46-52 ،56-59 ،130-138.
([27]) م.ع.ك. / شذرات / 1 مج/ 1 م ر 29 ،33 ،46. ويقارن: / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 123 ،124 -126 ،217.
([28]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 180، 199، 246، 250. ويقارن: /القوميات / 1 مج/ 1 م ر74، 81، 116، 125.
([29]) م.ع.ك. / القوميات / 2 مج/ 1 م ر 50-51.
([30]) م.ع.ك. / القوميات / 2 مج/ 1 م ر 51.
([31]) م.ع.ك. / القوميات / 2 مج/ 1 م ر 51.
([32]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر80، 166، 345، 346. و: / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 245، 306، 308، و:
/ القوميات / 2 مج/ 1 م ر 800، 198.
([33]) م.ع.ك. / القوميات / 2 مج/ 1 م ر 44، 46، 100-123.
([34]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 101.
([35]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 80، 81، 229-234. و: / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 100-102، 125
([36]) م.ع.ك. / القوميات / 1 مج /1 م ر 152-158 ،164-168. ويقارن: / القوميات / 2 مج/1 م ر34-36 ،45-49. و155-156.
([37]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر251 ،344. و: /القوميات / 2 مج/ 1 م ر 91 ،123.
([38]) م.ع.ك. / شذرات / مج/ 1 م ر 332-339 ،426.
([39]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر257-229.
([40]) م.ع.ك. / الرحانيات / 1 مج/ 1 م ر 322،371.
([41]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 17. و: / القوميات / 1 مج/ 1 م ر 57-67، 73،95.
([42]) م.ع.ك. / القوميات / 2 مج/ 1 م ر 11، 68، 131، 195.
([43]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 63-68، 166.
([44]) م.ع.ك. / التطرف والإصلاح / مج/ 5 م ر 330 ،40،46.
([45]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 203. و: / القوميات / 1 مج/ 1 م ر 56، 75، 95. و: / القوميات / 2 مج/ 1 م ر 117. و: / التطرف والإصلاح / مج /5 م ر22.
([46]) م.ع.ك. / بذور للزارعين / مج/ 4 م ر 37، 46، 56، 83، 166، 181.
([47]) م.ع.ك. / بذور للزارعين / مج/ 4 م ر 166. و: / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 455-498، 534-543.
([48]) م.ع.ك. / بذور للزارعين / مج/ 4 م ر 181.
([49]) م.ع.ك. / بذور للزارعين / مج/ 4 م ر 83.
([50]) م.ع.ك. / ملوك العرب /1 مج/ 3 م ر 22، 54، 214-222.
([51]) م.ع.ك. / الريحانيات /2 مج/ 1 م ر 51-61، 94-115.
([52]) م.ع.ك. / ملوك العرب /2 مج/ 3 م ر 248-294. ويقارن: / القوميات / 1 مج/ 1 م ر 13-37.
([53]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/ 1 م ر 304-305.
([54]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/ 1 م ر 32-331، 374.
([55]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 6.
([56]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 61.
([57]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 61.
([58]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 61-62.
([59]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/1 م ر61.
([60]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/1 م ر 61.
([61]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/1 م ر 63.
([62]) م.ع.ك. / الرسائل العربية / مج/5 م ر 866 ،761. و: / أنتم الشعراء / مج/4 م ر 36، 57،59.
([63]) م.ع.ك. / أنتم الشعراء / مج/4 م ر 10. و: / أدب وفن / مج/ 4 م ر 26-30.
([64]) م.ع.ك. / أنتم الشعراء / مج/1 م ر 35.
([65]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/1 م ر 80 ،102.
([66]) م.ع.ك. / أنتم الشعراء / مج/4 م ر 35-57.
([67]) م.ع.ك. / أنتم الشعراء / مج/ 4 م ر 57.
([68]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1مج/1 م ر 56-65، 194-199، 330-334. و: / الريحانيات / 2 مج/ 1 م/ 80 132-146، 202-213.
([69]) فيلسوف الفريكة، م.س، ص301.
([70]) م.ع.ك. / أدب وفن / مج/ 4 م ر 380، 60، 124، 144-163. و102.
([71]) م.ع.ك. / الريحانيات /2 مج/1 م ر 213247,.
([72]) م.ع.ك. / الريحانيات /2 مج/1 م ر 357-374.
([73]) م.ع.ك. / أدب وفن / مج/ 4 م ر 4. وكذلك: / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 11، 25-27، 157. و: / نور الأندلس / مج/ 3 م ر 142، 154-155.
([74]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 25.
([75]) أمين الريحاني، كتاب خالد ، ص299-300.
([76]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 57، والريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 5.
([77]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/1 م ر 251-255.
([78]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1 مج/ 1 م ر 121،115،105،98.
([79]) كتاب خالد، م.س، ص300. و: م.ع.ك. / الريحانيات / 1مج/ 1 م ر 270،157.
([80]) م.ع.ك. / الريحانيات / 1مج/ 1 م ر 276. و: / بذور للزارعين / مج/4 م ر 153.
([81]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/ 1 م ر 15-16، 29-31، 229. و: / الريحانيات / 2مج/ 1 م ر 85،197. و: / القوميات /2 مج/1 م ر 66-69، 109-112، و: / القوميات / 2مج/ 1 م ر 32-38، 136،163. و: / التطرف والإصلاح / مج/ 5 م ر 210.
([82]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 201.
([83]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 300، 309.
([84]) م.ع.ك. / الريحانيات / 2 مج/ 1 م ر 154-157، 190.و: / القوميات/2 مج/1 م ر 145-157، 190
([85]) (م.ع.ك.) / المكاري والكاهن / مج/ 2 م ر 15-22. وجدير بأن يقرأ النص بأكمله.
([86]) م.ع.ك. / شذرات من عهد الصبا/“طريق الإصلاح”/ مج/1 م ر 263-265.
([87]) م.ع.ك. / شذرات/“طريق الإصلاح”/ مج/1 م ر 265.
([88]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 14-34.
([89]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 34. ويقارن: الريحانيات /2 مج/ 2 م ر 35 ،102.
([90]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 18-20. ويقارن: الريحانيات /2 مج/1 م ر 14-17.
([91]) م.ع.ك./ الريحانيات /1 مج/1 م ر 53-55. ويقارن: /الريحانيات / 1 مج/1 م ر 212-217.
([93]) م.ع.ك./ الريحانيات /1 مج/1 م ر 170-196، 200،231، و/:الريحانيات /1 مج/1 م ر 109-120، 187، 197.
([94]) م.ع.ك./ الريحانيات /1 مج/1 م ر 284-286، و/:الريحانيات /2 مج/1 م ر 218، 261، 292.
([95]) كتاب خالد، م.س، ص33. و: م.ع.ك/ وصيتي/ مج/ 5
([96]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 107-110، 129، 133، و:/الريحانيات /2 مج/1 م ر 178.
([97]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 17-21.
([98]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 236.
([99]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 235-239.
([100]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 269. ويقارن: / الريحانيات /1 مج/1 م ر 93-95، 165، 196، و:/الريحانيات/ 2 مج/2 م ر 49،78، 159، 161.
([101]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 50، 95، 128. و:/الريحانيات /2 مج/1 م ر 12، 28، 233.
([102]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م/ 200، 253، 264.
([103]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م/ 186، 200.
([104]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 253. و:/ شذرات / مج/1 م ر 23-24، 274-297، 448-454.
([105]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 128، 186. و/ : شذرات / مج/1 م ر 311، 365، 374.
([106]) م.ع.ك. / الريحانيات /2 مج/2 م ر 280، 233. و: /شذرات / مج/2 م ر 20، 6، 18، 19-26.
([107]) م.ع.ك. / الريحانيات /2 مج/1 م ر 208.
([108]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 249.
([109]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 1-12.
([110]) م.ع.ك. / الريحانيات /2 مج/2 م ر 233.
([111]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م ر 224.
([112]) م.ع.ك. / الريحانيات /1 مج/1 م/ 227-228.
([113]) م.ع.ك. / الريحانيات/2 مج/1 م/ 198-205.
([114]) م.ع.ك. / الريحانيات/1 مج/1 م/ 198.