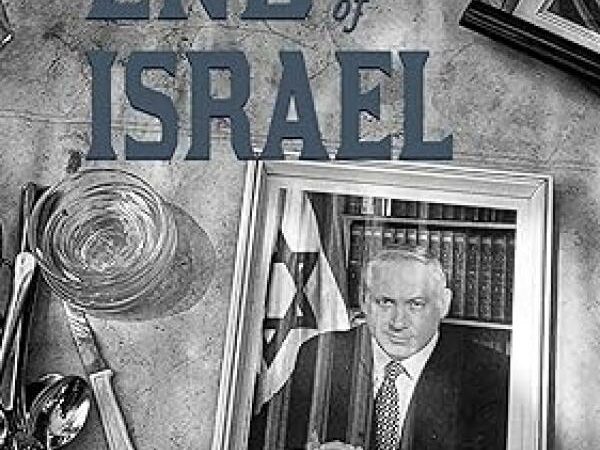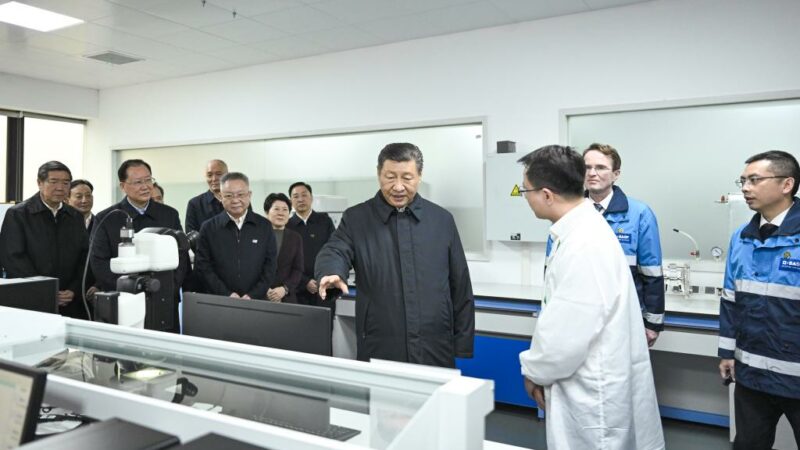القسطنطينية، قصة المدينة التي اشتهاها العالم


مراجعة:- محمد يسري أبو هدور* — فيليب مانسيل هو أستاذ تاريخ بريطاني معاصر، ينصب معظم إهتمامه على دراسة المدن الإسلامية المشرقية وكيفية تطورها في القرون الستة الأخيرة، ومن أهم كتبه كتاب “المشرق: الروعة والكارثة علي ضفاف البحر المتوسط”، ويتناول فيه تاريخ ثلاث مدن إسلامية هي القسطنطينية(إسطنبول) وحلب والإسكندرية.وفي هذا الكتاب المعنون بـ”القسطنطينية: المدينة التي أشتهاها العالم”.
يتناول المؤلف تاريخ مدينة القسطنطينية منذ الفتح العثماني لها في عام 1543م وحتى إلغاء الخلافة العثمانية في عام 1924م. يبدأ المؤلف كتابه بتصدير مهم، ألا وهو (هذا الكتاب قصة لمدينة وعائلة حاكمة، كتبته إيماناً مني بأن العائلات الحاكمة لم تكن أقل أهمية من القومية والمناخ والجغرافيا في تشكيل المدن).يظهر من الجملة السابقة أهمية المذهب الفردي في تفسير التاريخ عند مانسيل، فهو في رحلته الطويلة التي سيتعرض فيها لتاريخ القسطنطينية، سوف يبدي إهتماماً كبيراً بالجهود البشرية للعثمانيين الذين حكموا تلك المدينة العظيمة، بينما سوف يبدي إهتماماً أقل بالعوامل الطبيعية الأخرى، تلك التي وجد فيها الكثير من المؤرخين مفتاحاً رئيساً للدخول لفهم الحركة التطورية التي صاحبت تاريخ القسطنطينية.يعترف الكاتب بأن هناك العديد من الأسماء التي أطلقت على المدينة، ولكنه يؤكد أن إسم القسطنطينية هو الإسم الذي يفضله، وأنه الإسم الذي سيستخدمه على طول صفحات الكتاب.في أول فصول الكتاب، يروي مانسيل قصة الفتح العثماني للمدينة العظمى في عام 1453م، فيوضح المجهودات التي قام بها محمد الفاتح لعمارتها، وكيف استقدم الأتراك واليونانيين إليها بالطرق السلمية في بعض الأحيان وبالطرق الجبرية في أحيان أخرى.ثم يتطرق المؤلف لموقف محمد الفاتح من المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في المدينة، فقد إلتفت السلطان محمد إلى أهمية المركز الديني للقسطنطينية على مستوى العالم المسيحي، فقام بتعيين جورج جناديوس إسكولاريوس كبطريرك لكنيسة القسطنطينية ومنحه العديد من الإمتيازات، وكان جورج واحداً من كبار الرهبان المعروفين بالرفض الشديد لإندماج الكنيسة الأرثوذكسية تحت سيادة الكنيسة الرومانية الغربية في روما، وبتلك الخطوة أصبح البطريرك خادماً للإمبراطورية العثمانية، فقد ساعد السلطان في جباية الضرائب من رعاياه المسيحيين، كما أنه منعهم من مساندة أعدائه من المسيحيين الكاثوليكيين من أمثال البندقية والبابوية(الفاتيكان).
أما بالنسبة لليهود الموجودين في القسطنطينية، فقد سمح لهم العثمانيون بحرية التجارة فسرعان ما إزدهروا كعطارين وحدادين ونجارين، وفي بعض الحالات الإستثنائية كملتزمي ضرائب ومموّلين للقروض وأطباء، بحيث صار تاريخ اليهود في القسطنطينية – بحسب شهادة مانسيل- “إستثناء في التاريخ اليهودي”.وبعد أن يتناول مانسيل التركيبة السكانية المجتمعية التي تواجدت في القسطنطينية في الدولة العثمانية، فإنه يتطرق إلى التركيبة العسكرية العثمانية، فيشرح عملية (الدفشرمة) أي الجمع، والتي بموجبها كان يتم جمع الأطفال من السلاف وختنهم على الطريقة الإسلامية، ثم ادخالهم إلى الإسلام وتربيتهم تربية دينية عسكرية صارمة، وبعده يتم إلحاقهم بفرق الإنكشارية القتالية.ويحاول المؤلف أن يعرض الجوانب المختلفة المتعلقة بعملية “الدفشرمة”، فيبيّن أنه برغم كون معظم الأسر السلافية كانت تصاب بالحزن والآسى لاختطاف أبنائها وضمهم إلى الجيش العثماني، إلا أن الكثير من تلك الأسر كانت تسعد وتبتهج لكون أبنائهم قد يحظون بفرصة مناسبة للإتحاق بالجهاز الإداري العثماني، خصوصاً “وأن العبودية في العالم الإسلامي كانت أقل إذلالاً منها في العالم المسيحي”.ويتعرض المؤلف لعدد من الشخصيات التي بزغ نجمها بعد ضمها إلى الإنكشارية، فيضرب مثلاً ب(محمد صوكولو) الذي ترقى سريعاً في مراتب الجهاز الإداري العثماني، حتى أستطاع أن يصل إلى منصب (الصدر الأعظم).أما عن الثقافة السائدة في ذلك المجتمع الكوزموبوليتاني في القسطنطينية، فيؤكد مانسيل على اتسامها بالتعددية وسماحيتها لتقبل الأخر، ويضرب مثالاً على ذلك، بأن اللغة الفارسية – برغم كونها هي لغة الأعداء الصفويين الحاكمين في إيران – قد إستطاعت أن تجد لنفسها مكاناً مهماً في القصور الملكية وبين أوساط النخبة العثمانية نفسها.كما أن القسطنطينية في أواخر عهد محمد الفاتح، قد أضحت ديبلوماسياً وتجارياً وثقافياً جزءاً من أوروبا، وذلك برغم كل الحروب والصراعات الدائرة ما بين الطرفين.
يتناول المؤلف بعد ذلك مكانة الإسلام في دولة العثمانيين، فيؤكد على وجود روابط وثيقة ما بين الأسرة العثمانية من جهة والدين الإسلامي من جهة أخرى، وقد برزت تلك الروابط في الكثير من المظاهر والتجلّيات، منها البنايات والعمارات المتسمة بالروح الإسلامية الواضحة، فقد حرص محمد الفاتح على بناء مسجد في منطقة القرن الذهبي في المنطقة التي قيل إن بها قبر الصحبي الجليل (أبو أيوب الأنصاري)، وهذا أدى إلى ربط العاصمة الجديدة للعثمانيين عاطفياً بالإسلام، فقد أصبح أبو أيوب راعياً للقسطنطينية، حيث حل محل القديسين الذين كانوا يحمون المدينة إبان عهدها المسيحي السابق، ولذلك قدم الحجيج المسلمون من كل مكان لزيارة مسجد أبي أيوب، وبذلك أضحت القسطنطينية مدينة مقدسة.وإستمر ذلك البعد الديني في سياسة خلفاء محمد الفاتح، فسليم الأول الذي كان أقوى حكام الشرق الأوسط وأوسعهم نفوذاً وأشدهم بطشاً ومقدرة، حرص على بسط سيادته على طرق الحج إلى الحجاز، كما أنه تمكن من السيطرة على مكة والمدينة، وتلقب بواحد من أهم الألقاب المقدسة، ألا وهو (خادم الحرمين الشريفين)، كما تلقب بلقب الخلافة، وبذلك إحتلت القسطنطينية مكانة مقدسة بوصفها عاصمة الخلافة وحاضرة الدولة الإسلامية.وكانت أفخم المراسم السنوية التي يشهدها الناس في القسطنطينية، هي مغادرة قافلة الحج إلى مكة، حيث كانت تلك الرحلة تحمل بُعداً رمزياً دينياً عميقاً وتؤكد على قوة الرابطة ما بين الدولة والدين.
ولكن المؤلف يوضح أن تديّن السلالة العثمانية الحاكمة، لم يخلُ من نظرة براغماتية نفعية في الكثير من الأحيان، ويستشهد على ذلك بنسب السكان المتدينين في القسطنطينية على مدار أعوام الحكم العثماني، فقد كان المسلمون لا يمثلون أكثر من 58% بينما تشكل باقي المجتمع من المسيحيين واليهود. ويفسّر المؤلف سبب عدم وجود حرص قوي من العثمانيين على تعديل تلك النسبة، بكون كل من المسيحيين واليهود كانوا يدفعون ضرائب أعلى بكثير من المسلمين.كما أنه وبرغم أن الشريعة الإسلامية كانت تفرض عدم إقامة كنائس جديدة في الدولة الإسلامية، فإن المغريات المالية التي قدمها اليونانيون للحكومة، كثيراً ما كانت تسمح بإقامة كنائس جديدة، وكان يتم التحايل على نصوص الشريعة، بدعوى أن تلك الكنائس قد بُنيت على أنقاض كنائس قديمة متهالكة.
السلطة العثمانية من الداخل
بعد ذلك يتناول المؤلف السلطة العثمانية من داخلها، فيشرح ويصف ما كان يوجد داخل القصور السلطانية العثمانية، فمراسم تقديم السلطان كانت على وجه من أوجه التعقيد، فكان من المعتاد أن يحضر السلطان مع الوزراء الديوان لمناقشة الأمور المهمة، ولكن بعد ذلك تبدل الوضع، فصار السلطان يستمع إلى ما يدور في الديوان من وراء حجاب أو ساتر.وقد بلغت أبهة القصر السلطاني أوجها في عصر السلطان سليمان القانوني، فقد أُعيدت زخرفة جدران القصر بالذهب والجواهر تمجيداً لإنتصاراته الرائعة على المجريين والصرب المسيحيين.وقد ضمت الخزائن السلطانية أطيافاً من تحف وذخائر قد حُملت من شتى العواصم المفتوحة والخاضعة للعثمانيين، مثل القاهرة وتبريز وبودابست وغيرها من المدن.وكانت زيارات السلطان وأهله لمسجد أيا صوفيا وللبوسفور، فرصة رائعة للشعب لكي يتعرف على أبهة وعظمة وفخامة الأسرة الحاكمة، وكذلك كانت مناسبات ختان الأمراء فرصة لممارسة الألعاب وإظهار عظمة الدولة وقوتها. وكما يقول المؤلف، فقد “كان استعراض العظمة في حفل زفاف بنت السلطان أهم من الزفاف نفسه”، وكانت المدينة تشهد ألعاباً نارية ومشعوذين ومسابقات ومصارعة ومعارك تمثيلية.
وفي فصل بعنوان “تكشيرة الإنكشارية”، يتناول المؤلف تطور العلاقة ما بين السلطنة العثمانية وقوات الإنكشارية، ويرى أن السبب الأول الذي أدى إلى تفاقم خطر قوات الإنكشارية هو “غياب المؤسسات المدنية المستقلة، ذلك أنه في الملكيات المطلقة تكون الموانع ضد تدخل القوات المسلحة في السياسة ضعيفة”.ويحاول مانسيل أن يبيّن الأسباب التي أدت إلى حدوث العديد من الصدامات ما بين السلطان والإنكشارية، فيقول إن أول تلك الأسباب أن مسألة تعيين سلطان جديد، كانت تعني في الحقيقة حصول الجند الإنكشارية على المزيد من الأموال والأعطيات والبقشيش، كما أن غياب أية مؤسسة سياسية وسيطة في المجتمع قد منح الفرصة للإنكشارية كي يصبحوا مقياساً لحالة السخط والغضب السائدة في المجتمع ضد السلطان.
كما أن هناك نقطة مهمة يشير إليها المؤلف، ألا وهي أن هناك تغيّراً نوعياً قد حدث في بناء الجيش الإنكشاري، وذلك عندما تم تعطيل عمليات الدفشرمة وتم إستبدال العنصر البلقاني السلافي، بإدخال العديد من أبناء الجند الإنكشارية والعمال وأبناء الطبقات الدنيا في المجتمع إلى النظام الإنكشاري، كل هذا أدى إلى إضعاف الرابطة ما بين السلطة والجند، حتى أننا نجد أنه وفي عز مجد وعظمة الدولة العثمانية، أن الإنكشاريين يمنعون دخول السلطان سليم الثاني إلى قصره، ويهينون جثة السلطان سليمان القانوني.
ويستعرض المؤلف بعد ذلك الخطوات التي قام بها السلطان العثماني محمود الثاني، لتطوير نظم الدولة العثمانية القتالية، وكيف أنه حاول بناء الجيش وفق الطرق الحربية الأوروبية الحديثة، ولما كان الإنكشاريون غير معتادين على تلك التغيّرات، وكانت طرقهم تعتمد في المقام الأول على الشجاعة والقوة وليس على العلم والتقنية، فقد كان من الطبيعي أنهم حاولوا بكل قوتهم إيقاف تلك التحديثات العسكرية.وأدى ذلك الخلاف ما بين السلطان والإنكشاريين، إلى أن قام الجند باقتحام قصر الباب العالي وحاولوا اقتحام قصر السلطان نفسه، ويستعرض المؤلف أحداث تلك المواجهات الدامية التي جرت في عام 1826ه، وكيف أن قوات المدفعية الموالية للسلطان قد لعبت دوراً حاسماً في ترجيح كفة الدولة عندما دكت ثكنات ومعاقل الإنكشاريين، فقتلت منهم ما يزيد عن الخمسة آلاف مقاتل ووضعت حداً لوجودهم في الدولة العثمانية.
الثورة اليونانية والتحديث
وفي فصل بعنوان “محمود الثاني”، يتعرض مانسيل للثورة اليونانية على العثمانيين، وكيف أن السلطان قد تعامل معها بنفس مقدار العنف الذي تعامل به مع الإنكشاريين. ويصف الكاتب مظاهر التشقق المجتمعي إبان تلك الثورة، وكيف سادت موجة من الكراهية تجاه كل ما هو مسيحي أو يوناني، حتى أنه قد تم شنق البطريرك وبعض من أساقفته لشبهة في تعاطفهم مع تلك الثورة، كما تم قتل العديد من المسيحيين وإلقاء جثثهم في الشوارع.
وقد إستطاع السلطان محمود الثاني أن يستخدم قواته المدرّبة وفق النظم والتكتيكات الأوروبية في محاولة القضاء على الثورة اليونانية، ولكن الثورة استطاعت الوقوف أمام القوة التركية بعد أن لاقت تأييداً كبيراً من الدول الأوروبية العظمى، إنجلترا وفرنسا وروسيا، حيث قامت تلك الدول بتدمير الأسطول البحري العثماني في موقعة نوارين البحرية في عام 1827م. ولكن ذلك لم يمنع السلطان من استكمال خطواته الإصلاحية والتحديثية في الجيش، فمع مرور الوقت زادت أعداد تلك القوات حتى وصل تعدادها زهاء ستة وأربعين ألف جندي وبحار وجندي بحرية وجندي مدفعية متمركزين في القسطنطينية وحولها.وعلى الرغم من التواطؤ الأوروبي ضد العثمانيين، إلا أن كلاً من إنجلترا وفرنسا قد غيرتا من موقفيهما بعد أن قامت روسيا بإعلان الحرب على السلطنة، وألحقت بجيوشها عدد من الهزائم واتجهت ناحية القسطنطينية.
وقد أسفرت تلك الأوضاع الحرجة عن توقيع معاهدة في أدرنة، بموجبها فرضت روسيا سيطرتها على مساحات واسعة من أملاك العثمانيين في أوروبا، بينما تنفس السلطان الصعداء بعد أن ضمن الحفاظ على عرشه.بعدها واصل السلطان ثورته التحديثية، باستبدال العمامة بالطربوش، حيث أضحى الطربوش رمزاً للشكل التحديثي على الطريقة التركية، كما أن جميع المسلمين الخاضعين عملياً أو روحياً للسلطان العثماني من البوسنة إلى جاوة، قد أدخلوه في زيّهم التقليدي.أما على صعيد الصناعة، فقد إشترى السلطان في عام 1828م السفينة الإنجليزية (سويفت)، والتي كانت أول سفينة بخارية تدخل الشواطئ التركية حيث إصطفت الحشود الهائلة لمشاهدتها.وأنشأ السلطان مدرسة للجراحة والطب وكان التدريس فيها باللغة الفرنسية، وبدأت اللغة الفرنسية في الحلول كلغة ثانية للنخبة العثمانية، وسرعان ما أصبحت لغة الأكاديمية العسكرية والمراسلات والسفارات الدبلوماسية فانتشرت على نطاق واسع.
وفي محاولة لتغريب الثقافة العثمانية، قام السلطان باقامة موسم سنوي للأوبرا على المسرح.ويتابع مانسيل قراءة المشهد التحديثي العثماني في عهد السلطان عبد المجيد إبن السلطان محمود، ويتعرض لظروف العلاقة مع محمد علي والي مصر القوي، وكيف تدرجت تلك العلاقة من العداء المباشر الصريح الذي وصل إلى أوجه باستدعاء السلطان العثماني للسفن الحربية الإنجليزية والفرنسية للتصدي لخطر قوات محمد علي الزاحفة صوب القسطنطينية، إلى العلاقات الودية الدبلوماسية التي توّجت بزواج إحدى بنات السلطان من أحد أحفاد محمد علي.ثم يتناول المؤلف واحدة من أهم اللحظات التاريخية في فترة الحكم العثماني، والتي تتمثل في وصول حزب “تركيا الفتاة” إلى الحكم في عام 1908م واقامة انتخابات شعبية، وتقليص نفوذ السلطان التركي بشكل كبير، وكيف تراجعت تلك الشعبية الطاغية لجمعية “الإتحاد والترقي” بعد حدوث الكثير من الإضطرابات الخارجية واقتطاع كل من النمسا وروسيا لأجزاء من السلطنة العثمانية. وقد تم تحميل السلطان عبد المجيد المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، فتم عزله ونفيه إلى سالونيك، وتم تعيين محمد رشاد بديلاً له، وتم استكمال مسيرة الديموقراطية التحديثية حيث بقت جلسات البرلمان تعقد بشكل منتظم حتى عام 1918م.وتواكبت مع تلك الفترة، خطوات تقدمية في ما يتعلق بالمجال التقني، فتم إدخال الهواتف في بعض القصور، كما تم توصيل الكهرباء إلى بعضها، وتأسست نقابات عمالية قادرة على الإنتصاف لحقوق أعضائها.
كما أن مناخ الحريات السياسية السائد في البلاد قد أدى إلى إفراز عدد من الأفكار الحديثة مثل الدعوة إلى القومية التركية، وإلى حرية المرأة ومساوتها بشكل كامل مع الرجل.ووسط كل تلك الإجراءات التقدمية الكبرى التي شهدها المجتمع التركي، تورطت حكومة الإتحاد والترقي بدخول الحرب العالمية الأولى في عام 1914م متحالفة مع الجانب الألماني. ويؤكد مانسيل أن تلك الخطوة قد تمت من دون موافقة السلطان ومن دون رضا الشعب التركي، وأن المتسبب الرئيس فيها هو قائد الحكومة الذي إستغل حادثة مصادرة الحكومة الإنجليزية لمركبين عثمانيين لإعلان الحرب عليها.وفي خلال تلك الحرب، وقعت أحداث مذابح الأرمن، وذلك عندما حاول الأرمن أن يستغلوا دخول العثمانيين إلى الحرب، فثاروا عليهم، فاتخذت حكومة الإتحاد والترقي قراراً بالإبادة الشاملة وهي التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرمن من الرجال والنساء والأطفال.
مصطفى كمال أتاتورك
مصطفى كمالوفي الفصل الأخير من الكتاب، والذي جرت عنونته بعنوان “موت عاصمة”، يتناول مانسيل السنين الأخيرة في عمر القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية العثمانية.ففي أواخر عام 1918م، خضعت القسطنطينية لسيطرة البريطانيين، وتمتع المندوبون الساميون لدول الحلفاء الثلاث (إنجلترا- فرنسا- إيطاليا) بسلطة أكبر من سلطة السلطان العثماني نفسه.ودارت العديد من المناقشات بين الحلفاء وبعضهم البعض، تناولوا فيها المصير المستقبلي للقسطنطينية، فطالب الإنجليزي لويد جورج بأن يتم تدويل المدينة وأن تحكمها سلطة مختارة من دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، بينما طالب اليونانيون بفرض سيطرتهم على المدينة.
وفي الوقت الذي كان السلطان محمد السادس يحاول فيه أن يتعاون بهدوء مع الحلفاء تجنباً لغضبهم، كان الوطنيون من أنصار حزب “تركيا الفتاة” والذين عرفوا في ذلك الوقت بإسم (قرة قول)، يخططون للمقاومة، فقد سهّل هؤلاء نقل واحد من كبار أبطال معركة غاليبولي إلى الأناضول حيث تفرض القوات التركية سيطرتها، واستطاعوا أن يستصدروا أمراً من السلطان بتعيين هذا البطل على رأس القوات، وكان هذا البطل هو مصطفى كمال والذي عرف فيما بعد بأتاتورك.يقول مانسيل: “لقد صنع تاريخ القسطنطينية أفراداً مثل كاترين الثانية ومحمود الثاني وعبد الحميد وأنور وكرزون، وكذلك قوى غير شخصية ممثلة في السلطة العاتية والجغرافيا والقومية والدين، بيد أنه لم يؤثر أحد في المدينة منذ محمد الفاتح نفسه مثلما أثّر فيها مصطفى كمال”.ويبرر المؤلف كلامه، بتناول الخطوات التي قام بها مصطفى كمال وكان لها شأن كبير في تغيير الأوضاع السياسية القائمة، فقد بدأ مصطفى كمال ومنذ وصوله إلى الأناضول في فرض سيادته على المدن المجاورة.
وفي هذا الوقت كان الحلفاء قد إعترفوا بتركية القسطنطينية ورفضوا طلبات تدويلها أو تسليمها لليونان، وربما كان ذلك بفعل حركات الإحتجاج الواسعة من جانب المسلمين في الهند ضد ما أثير من نوايا مستقبلية لإنجلترا ودول الحلفاء بشأن مستقبل عاصمة الخلافة.ومع تزايد قوة مصطفى كمال، دخل معه السلطان في عداء صريح، حيث قام بعزله من موقعه وإستصدر أمراً من شيخ الإسلام بتحريم القتال معه ووجوب مقاتلته، وأصدرت المحكمة ضده حكماً بالإعدام. وكان رد الكماليين على ذلك أن قاموا بتطويق القسطنطينية، فقامت كل من إنجلترا واليونان بالتصدي لهم.
وفي سبتمبر – أيلول 1922م استطاع الكماليون أن يحققوا إنتصاراً كبيراً بعد أن إسترجعوا مدينة أزمير من اليونانيين، وفي تشرين الأول – أكتوبر دخلوا إلى القسطنطينية نفسها، وقام مصطفى كمال بالإعلان عن إلغاء السلطنة العثمانية، وتم نقل السلطان محمد السادس إلى مالطا حيث بقي هناك حتى توفى في عام 1926م. أما في القسطنطينية فقد تم تعيين ولي العهد عبد المجيد كخليفة جديد منزوع السلطات والصلاحيات، وبقى في منصبه حتى عام 1924م، حيث تم عزله ونفيه هو الآخر، وتم الإعلان عن أنقرة كعاصمة جديدة للدولة التركية، وبذلك توقف تاريخ القسطنطينية عند ذلك الحد. فبعد خمسمائة عام من الفتح العثماني للمدينة، تم إلغاء السلطنة والخلافة وهُجرت المدينة التي إعتادت أن تكون أهم مدن العالم وأكثرها صخباً وجدلاً.
عنوان الكتاب: “القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453- 1924م”
-Constantinople: City of the world’s desire, 1453- 1924 –
المؤلف : فيليب مانسيل –
ترجمة: د.مصطفى محمد قاسم -جزءان- 800 صفحة –
الناشر: عالم المعرفة- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت- 2015م