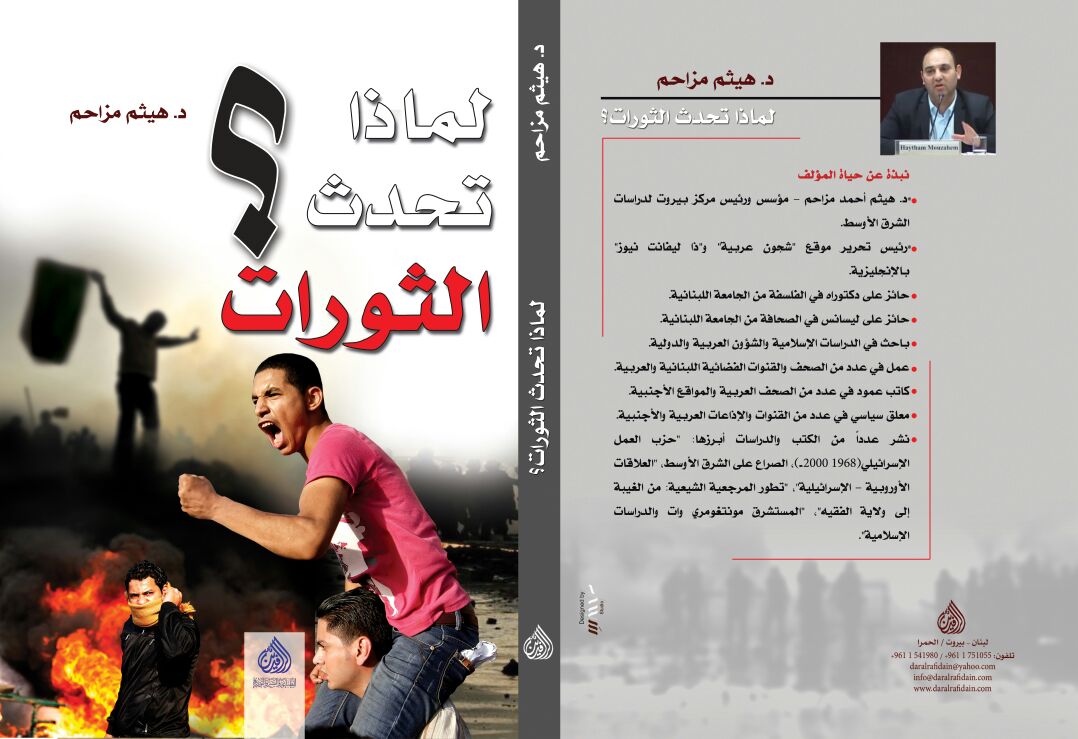الصين … توافقات ما بعد كورونا

بقلم د. شاهر إسماعيل الشاهر* |
ينجم عن الأزمات الدولية عادة رؤى تبحث في إيجاد الحلول للخروج من تلك الأزمات، هذه الرؤى تكون إما على شكل اتفاقيات قانونية، أو حروب مباشرة، أو توافقات دولية. وأزمة كورونا كغيرها من الأزمات الدولية التي خلفت مآسي إنسانية كبيرة، ولفهم ما يترتب على هذه الأزمة من تغيرات في بنية النظام الدولي من وجهة نظر نظرية العلاقات الدولية نرى أنه هناك مدرستان، المدرسة المثالية التي تؤكد على التضامن الدولي كقيمة أساسية في العلاقات الدولية، وأن كورونا ستعيد العالم إلى التنسيق والتعاون بدلاً من الفرقة والتناحر لمواجهة الخطر المشترك الذي يهدد البشرية، والمدرسة الواقعية التي ترى أنه ومن منطلق ” الواقعية السياسية “، ودور القوة في رسم معالم النظام الدولي، فإن عالم ما بعد كورونا لن يشذ عن هذه القاعدة، أي أن القوة والقوة وحدها هي من يحدد شكل النظام الدولي القادم.
وهناك من يرى أن الأزمات الدولية لا تؤثر بالضرورة بشكل سلبي في علاقات القوى العظمى بعضها ببعض، بل قد تؤثر بشكل إيجابي فتؤدي إلى تجميد الخلافات بينها، وربما تساهم في حل بعض القضايا التي يختلفون حولها، لذا اعتقد البعض أن أزمة كورونا ستخفف من حدة الصراع الأميركي الصيني، لكن حدة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بداية الأزمة واتهاماته للصين بددت هذه الفكرة. رغم أنه عاد لاحقاً وتراجع وأشاد بالتجربة الصينية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ما جعل البعض يعتقد أن هذا الخطاب سيسهم في إيجاد هدنة بين الطرفين والبحث عن حل لبعض القضايا الخلافية وهو ما قد يتطور إلى توافقات قادمة وخاصة حول شكل النظام الدولي القادم وقيادته. أي أن ترامب انتقل من الحديث عن “الفيروس الصيني” إلى الحديث عن “الحل الصيني” خاصة بعد تفشي المرض في الولايات المتحدة وازدياد عدد الضحايا الذي أظهر مدى تخلف وعجز النظام الصحي فيها. وكانت الصين قد طرحت فكرة التعاون بديلاً لفكرة الاستغلال، واستراتيجية الفائدة للجميع بدلاً من فوز طرف وخسارة آخر، وبالتالي الانتقال من النظرية الواقعية في العلاقات الدولية إلى النظرية الاعتمادية. وهو دليل واضح على التحول في نمط التفكير الصيني من نيو ليبرالية السوق الى نيو ليبرالية الدولة، وبالتالي الانتقال من رأسمالية تنظمها آليات السوق الى رأسمالية تنظمها الدولة.
خاضت الصين معركة كبيرة لا نبالغ إن اعتبرناها بمثابة حرب عالمية ثالثة، فتقاتل على عدة جبهات: أولها على الصعيد الصحي والبحث عن علاج لمكافحة فيروس كورونا، وثانيها على الصعيد الاقتصادي وما تعرضت له من خسائر كبيرة نتيجة لموقفها الحازم المتمثل بالحفاظ على الإنسان أولاً وقبل كل شيء، ثم يأتي بعد ذلك العمل والإنتاج والاقتصاد.
أما الجبهة الثالثة وهي الأخطر والأكثر شراسة وخبثاً والتي تتمثل في الحملة الإعلامية الكبيرة التي تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة الصين أمام العالم والتي بدأت قبل أزمة الكورونا من خلال التحريض ضد الصين تحت مزاعم اضطهاد المسلمين، ثم أصبحت تسعى الى تشويه الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الصينية لمواجهة المرض، والذي عرى الدول الكبرى وكشف عجزها وأظهر للعالم حقيقة التوحش الرأسمالي وعدم إعطاء أي قيمة للإنسان في المجتمعات التي تتشدق بحقوق الإنسان وتتظاهر بزيف الديمقراطية.
لقد ابتعدت الحكومة الصينية عن لغة الخطابة والكلام والاتهام واتجهت الى العمل والجد لمواجهة المرض، وعملت مع الشعب الصيني يداً واحدة فأعطت العالم درساً يحتذى به في طريقة التعامل مع الأزمات. فأعطت الأولوية للإنسان من خلال إجراءات مشددة وتصرفات لبقة، وبرزت روح التعاون بين أفراد الشعب الصيني فشكلت لجاناً للأحياء وفي الجامعات والأماكن العامة، وأرسلت الطواقم الطبية إلى مدينة ووهان. أما الأجانب من الطلبة والمواطنين فقد طالتهم عناية خاصة وحظيوا باهتمام كبير واطمئنان مستمر على وضعهم الصحي وأعطيوا أرقاماً ساخنة يمكنهم الاتصال بها وقت الضرورة.
كما أثبت الحزب الشيوعي الصيني قدرة كبيرة على الوصول إلى جميع الأحياء والتجمعات السكنية عبر كوادره المنتشرة التي قامت بتأمين الاحتياجات لكل منزل من دون مبالغ إضافية، بل قدمت بعض الهدايا من خضار وفاكهة بشكل مجاني مرة في الأسبوع. وتعاملت الحكومة الصينية مع الأجانب والسكان المحليين سواسية، وأبدت لهم نفس الرعاية والاهتمام وفتح العلاج بالمجان للجميع، بينما شاهدنا بريطانيا تقدم العلاج المجاني فقط للبريطانيين غير المجنسين وأعلنت أن الأولوية لهم في المشافي وفي استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي.
ومع بداية القرن الحالي، شهدت العلاقات الدولية تغيراً ملحوظاً، ويرى الواقعيون الجدد أمثال كينيث والتز وجون ميرشايمر وكريستوفر لاين أن النظام الأحادي القطبية يحمل بذور فنائه لأن الدول ستوازن الولايات المتحدة الأميركية. يقول لاين إن النظام الدولي يشهد تحولاً في توزيع القوة والإمكانيات لصالح الصين، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تواجه مرة أخرى قوة تنافس طموحها في الهيمنة والتظاهر بأيديولوجية عالمية، وتعميم النموذج الأميركي على أنه الأفضل لكل شعوب العالم، مستخدمة مجموعة من الأدوات مثل الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومجلس الأمن، والعملاء في جميع دول العالم لخدمة أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على ثروات البلدان النامية وتحويلها لسوق استهلاكية لمنتجاتها.
وما يحدث في العالم اليوم يثبت لنا أن أدوات التحليل التقليدية لم تعد قادرة على تفسير التغيرات العالمية التي ازدادت تعقيداً، فالربط بين السبب والنتيجة لم يعد مباشراً، أي أننا انتقلنا من “السببية المباشرة” إلى “السببية الدائرية” التي تتضمن متغيرات عديدة يجب أن تراعي امكانية وجود مساحة معقولة من اللايقين على حد قول روبرت كيلتر.
وقادت الولايات المتحدة حملة ضد الصين، لأسباب لا تخفى على أحد، فالصين اليوم هي القوة الاقتصادية الصاعدة بقوة، صاعدة بعيداً عن القوة واغتصاب الحقوق وتدمير الدول، صاعدة من خلال الانتقال بالعلاقات الدولية من النظرية الواقعية بما تحمله من حروب ودمار، إلى الاعتماد المتبادل والتشاركية والمنافع المتبادلة بين الدول والتي تجسدت بمشروع الصين الاستراتيجي (الحزام والطريق) الذي طرحه الرئيس شي جين بينغ في العام 2013. ولفهم الإدراك الأميركي لما يحدث في العالم بعد انتشار فيروس كورونا يمكننا استخدام نموذج “جبل الجليد” في تحليل النزاعات، هذا النموذج يرى أن أي نزاع يأخذ شكل جبل الجليد فيكون له جزءان، جزء ظاهر فوق سطح الماء (المواقف المعلنة والخطاب الرسمي)، وجزء خفي تحت سطح الماء (يتضمن الخلفية والمصالح والاحتياجات الحقيقية في النزاع)، وقد انشغل الرئيس ترامب بالحديث عن العدو الخفي في تغريداته على تويتر.
لقد أدى انتشار فيروس كورونا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الأميركية الصينية، حيث ساد اعتقاد بأنه قد تم نقل الفيروس إلى الصين من خلال مشاركة عدد من الجنود الأميركيين في فعالية رياضية أقيمت في مدينة ووهان في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2019، وهو ما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى طلب توضيح رسمي من الأميركيين. وازداد التوتر بين البلدين عندما تحدث الرئيس ترامب واصفاً الكورونا بـ”الفيروس الصيني”، متجاهلاً أن الولايات المتحدة كانت مصدر فيروس انفلونزا الخنازير (إتش1إن1) في العام 2009 والذي انتشر إلى 214 دولة ومنطقة، وأسفر عن وفاة 18449 شخصاً في تلك السنة. وبدأ ترامب بالتجييش ضد الصين مطالباً بكين بدفع تعويضات مادية للمصابين وهو ما زاد من التوتر في العلاقات الأميركية الصينية المتوترة أصلاً. وسيطر التفكير الانطباعي على ترامب، فسارع الى بناء وجهة نظره من دون الاهتمام باستحضار الحجج الواقعية والمنطقية وهو ما لا يمكن أن ينتج عنه الا “سذاجة تحليلية”.
واستطاعت الصين دحض نظرية جون مير شايمر (الواقعية الهجومية)، التي تحدث بها قبل 22 عاماً والتي تحدث فيها عن استحالة صعود الصين من دون أن تخوض حرباً عسكرية مع القوى الكبرى (الغربية)، فالصين صعدت والحرب لم تقع، بل إن “حرب الكمامات” كانت كفيلة بفضح النظام الرأسمالي وابتعاده المطلق عن الإنسانية.
لقد انتصرت الصين في الحرب العالمية الثالثة من دون إطلاق ولا حتى رصاصة واحدة، ذلك أن الصين بقيت دوماً دولة محبة للسلام وساعية لتحقيقه في أرجاء المعمورة. ذلك أنها أدركت أن العلم والتكنولوجيا هو السلاح الأقوى في معركة البشرية ضد الأمراض. فلا يمكن للبشرية هزيمة كارثة كبيرة أو مرض خطير من دون التطور العلمي والابتكار التكنولوجي. فركزت على أهمية تنسيق البحوث بشأن تعقب مصدر الفيروس وطرق انتقاله وتقييم ما إذا كانت بعض الحيوانات المشتبه فيها عوائل وسيطة. ودعت الحكومة الصينية إلى التخلص من العادة السيئة الخاصة بتناول الحيوانات البرية لتدعيم نمط حياة متحضر وصحي وصديق للبيئة.
لقد تركت “ثقافة الانسجام” بصمات عميقة في الشخصية القومية للشعب الصيني المحب للسلام والوفاق، وطريق الحرير قديماً يشهد على تاريخ الصين في السعي إلى التواصل الودي والتعاون المشترك مع شعوب العالم، فقد كان طريقاً للتجارة، ومجالاً للتفاعلات الثقافية، ورسالة سلام من الشعب الصيني لجميع البلدان الأجنبية، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون والصداقة. ومنذ بداية أزمة كورونا أدركت بكين أن الموت لا يميز بين الأديان أو المذاهب أو الأعراق، أو الجنس أو اللون، وأن الإنسانية كيان واحد لا يمكن أن يكون بخير اذا كان جزء منه ليس بخير. لذا، وبعد الانتصار الكبير الذي حققته الصين في القضاء على الفيروس في ووهان انتقلت لمساعدة جميع دول العالم عبر تزويدها بكل ما توصل إليه الخبراء الصينيون من معلومات عن الفيروس، ليس ذلك فحسب بل انتقلت الى ارسال المساعدات الطبية والطواقم الطبية المدربة الى الدول المنكوبة، وكان ذلك بطريقة مدروسة وبتخطيط كبير حيث تم تكليف كل إقليم في الصين بدعم دولة في حربها ضد الكورونا، فعلى سبيل المثال: تم تكليف مقاطعة شنغهاي Shanghai بمساعدة إيران. ومقاطعة غواندونغ Guangdong لتحارب المرض في العراق. أما مقاطعة سيتشوان Sichuan فتحارب في إيطاليا، ومقاطعة جيانسو Jiangsu تحارب في الباكستان، ومقاطعة جيانشي Jiangxi تحارب في تونس…إلخ.
كما قامت السفارات الصينية في كل دول العالم بتقديم النصح والمشورة وارسال المساعدات الطبية اللازمة، ومن هذه الدول كانت سورية التي قدمت لها الصين الكثير من المساعدات بالإضافة الى الدعم الصيني لسورية في مجلس الأمن عبر المناداة برفع العقوبات عن الحكومة السورية ليتسنى لها مواجهة كورونا.
وكان من البديهي أن يترافق مع انتشار فيروس كورونا عالمياً مع مستوى من الركود الاقتصادي، نظراً لتراجع مستوى الإنتاج، واختلفت التقديرات عن المدى الزمني لهذا الركود. وكان السؤال الأهم هو: من سيستفيد من هذا الركود؟ ومن سيتضرر؟ وكان واضحاً أن الاقتصاديات المتخلفة ستكون الأكثر تضرراً وخاصة الدول الريعية التي تعتمد على تصدير النفط نتيجة لقلة الطلب العالمي عليه وبشكل كبير. وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً في العالم وهناك آلاف الشركات ستعلن إفلاسها قريباً في أوروبا وأميركا. بينما الشركات الصينية عادت للإنتاج بقوة وسرعة كبيرة وهو ما سيساعد الصين على تقليص الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، وستلعب تقنية الجيل الخامس دوراً كبيراً في ذلك.
لقد كانت الصين أولى الدول التي تعافت من الفيروس، وهذا يعود لعدة أسباب، أهمها: الإجراءات الحكومية المشددة والضوابط الاجتماعية الكبيرة، وكذلك لأن الصين أولى البلدان لتي أصيبت بهذا الوباء، والتعاون والتكاتف بين أبناء الشعب الصيني والتزامهم بالتعليمات الحكومية، وبكل تأكيد التطور الطبي الذي تشهده الصين كان له الدور الأكبر. كما لعبت التكنولوحيا الحديثة دوراً كبيراً في التعاطي مع الأزمة، فتم استخدام الهاتف لإيصال الرسائل التوعوية حول طبيعة وكيفية التعاطي مع المرض، وخطورة الخروج من المنزل من دون أخذ الاحتياطات الكافية، واستطاعت الصين عبر تطبيق “we chat” إحصاء الحالات المصابة بالفيروس وعدد الوفيات وكل ما يتعلق بالمرض، فقضت بذلك على الشائعات المغرضة ومنعت تداولها، وجسدت مثالاً حياً لثورة المعرفة التي أطاحت بالنظريات الاقتصادية التقليدية، وغدت العامل الأول في تكوين القيمة المضافة، وتحقيق الفائض الاقتصادي في كثير من دول العالم. وكان التعليم عن بعد، إجراء فوريّاً، وخياراً بديلاً، وضعت لأجله برامج مرنة، كي يكمل الطلبة دراستهم عبر الإنترنت، من دون اجتزاء أيّام من عطلتهم الصيفية، ومن دون أن يكون هناك فاقد تعليمي. والأمر ذاته اتبعته العديد من الشركات التي من الممكن أن تستمر إنتاجيتها من دون تواجد لموظفيها على أرض الواقع. ولا يجوز أن ننسى حرب الصين ضد جيش من الإعلام الخارجي المأجور الذي عمل على خلق الأكاذيب والعمل على الإساءة لطريقة تعاطي الحكومة الصينية مع الأزمة عبر فبركة العديد من الصور والعمل على نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى أنصار النظرية الواقعية في العلاقات الدولية أن المنظمات الدولية ليست سوى مساحة إضافية لإدارة الصراع بين القوى الكبرى، ومن هنا رأينا كيف دخلت منظمة الصحة العالمية في قلب الصراع الصيني الأميركي، وأن مخالفة منظمة الصحة العالمية للبروباغندا الغربية هذه المرة ما هو إلا انعكاس لتغيرات قد تحدث في بنية النظام الدولي في مرحله لاحقة.
لقد مارست الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية حملة ممنهجة ضد الصين متهمة إياها بالوقوف وراء تصنيع الفيروس، ولكن، وعلى الرغم من هذه البروباغندا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حسمت الجدل لصالح الرؤية الصينية التي قالت إن الفيروس من أصل حيواني (طبيعي). هذا الموقف لمنظمة الصحة العالمية خالف وللمرة الأولى البروباغندا الغربية، فمثلاً: عند اكتشاف انفلونزا الخنازير كانت منظمة الصحة العالمية جزءاً من البروباغندا الغربية والتي استطاعت من خلالها العديد من الدول الغربية تحقيق أرباح كبيرة والخروج من فخ الإفلاس الذي فرضته الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لقد اتضح لنا بعد وباء كورونا أن الأوروبيين والغرب عموماً، لم يكونوا في الواقع كصورتهم المرسومة في أذهاننا أو كما كنا نعتقد، واتضح أن أوروبا قارة عجوز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتبين لنا جلياً من هي الدول الفاشلة والنظم الهشة غير القادرة على مواجهة أية أزمة.
وكان المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي قد تنبأ بأن القرن التاسع عشر سيكون قرناً للمملكة المتحدة، والقرن العشرين قرناً للولايات المتحدة الأميركية، أما القرن الحادي والعشرون فسيكون قرناً صينياً، هذا التنبؤ جلب القلق والخوف للكثير من الغربيين، وتسبب جزئياً في نظرية “التهديد الصيني”، والخوف من أن نهضة الصين ستجعلها مهيمنة على غرار سلوك الدول الغربية بعدما أصبحت قوة عظمى. والصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحققت إنجازات لفتت أنظار العالم في السنوات الأخيرة بفضل سياسة الإصلاح والانفتاح وتبني اقتصاد السوق الاشتراكي، وهناك الكثير من التجارب في هذا المجال.
وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية قد نشرت بتاريخ 20 آذار 2020 استطلاعاً لرأي 12 مفكراً عالمياً حول مستقبل النظام الدولي في مرحلة ما بعد كورونا، وتوصلت الخلاصات إلى أن العالم سيتغير جيوسياسياً بشكل تدريجي، وهذه أبرز التغيرات المتوقعة:
1- تعزيز دور الدولة القومية كفاعل دولي، فأزمة كورونا أظهرت أن الدول القومية هي الأقدر على مواجهة هكذا أزمات.
2- تراجع النظام الدولي المعولم في نسخته الغربية وارتباطه أكثر بالعولمة البديلة التي تقودها الصين التي تقوم على نشر قيم وخصائص الثقافة الوطنية الصينية من خلال الاستناد إلى مجموعة مرتكزات، أهمها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فالسيادة من وجهة نظر الصين هي القيمة المعيارية الأعلى.
3- تخلي الولايات المتحدة بشكل نهائي عن القيادة المنفردة للعالم بعد أن ظهر عجزها في تقديم أي شيء للعالم في هذه الأزمة، وبعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية.
4- تفكك النمط المعقد للمبادلات الاقتصادية الدولية نتيجة لما فرضته الأزمة.
5- فشل الاتحاد الاوروبي في بلورة استراتيجية جماعية لمواجهة قضية كورونا، بل على العكس من ذلك، فقد مارست العديد من دول الاتحاد دور القراصنة حين استولت على شحنات طبية متجهة إلى غيرها من الدول.
واليوم، أصبح من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد قادرة على البقاء في مركز الريادة وتحمل نفقات قيادة العالم، وبالتالي لم تعد أميركا هي الدولة الرائدة في العالم، ولعل ما نشاهده من عجز كبير في طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع أزمة كورونا خير دليل على ذلك، والذي توج بإعلان الرئيس ترامب أنه لن يدفع الأموال المترتبة على الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 15٪ من تمويل هذه المنظمة. وسيكون جزء من مستقبل العالم يتمحور حول ما اذا كانت الصين قادرة وراغبة في تحمل نفقات قيادة العالم أم لا؟.
وختاماً: إن بكين تدافع في المقام الأول عن مصالحها، ولا تولي مسألة المعاملة بالمثل إلا النذر اليسير من اهتمامها. والاستراتيجية الصينية لا تسعى في الأساس للانقلاب على النظام الدولي وهدمه، وإنما السيطرة الناعمة عليه بالاعتماد على عامل الزمن والانتظار الإيجابي، وزيادة حجم مشاركتها، والانتشار الواسع على أساس التقبل والشراكة. وقد اتبعت خطة محكمة للتواجد القوي في كل المضائق الاستراتيجية والقنوات الملاحية، عبر إطلاق الرئيس الصيني عام 2013 لمبادرة “الحزام والطريق”، ومن خلالها تعزز الصين مصالحها الاقتصادية مع الدول التي يمر عبرها طريق الحرير من الصين وصولاً إلى أوروبا.
ويعترف المنظرون الأميركيون بأن بلادهم تسير في طريقها إلى التراجع، وهم في ذلك لا يحاولون تحدي السنن الكونية بل التخطيط لهذا التراجع وإدارته بالشكل الذي يصل ببلادهم إلى أن تكون إحدى قوى الصف الثاني بدلاً من أن تنهار، وعلى حد قول المفكر الأميركي روبرت كابلان فإنه ليس هناك شيء أفضل بالنسبة إلى بلاده من تهيئة العالم لاحتمال زوالها، وترتيب آلية مناسبة للتراجع المتناسق كي تطيل من أمد بقائها كأمة قوية، مشيراً إلى أن العولمة التي اخترعتها الولايات المتحدة الأميركية لترسيخ هيمنتها على العالم استغلتها قوى أخرى (على رأسها الصين) كأداة لتقويض النفوذ الأميركي من داخل هذا النظام.
*باحث وأستاذ جامعي سوري – كلية الدراسات الدولية- الصين.