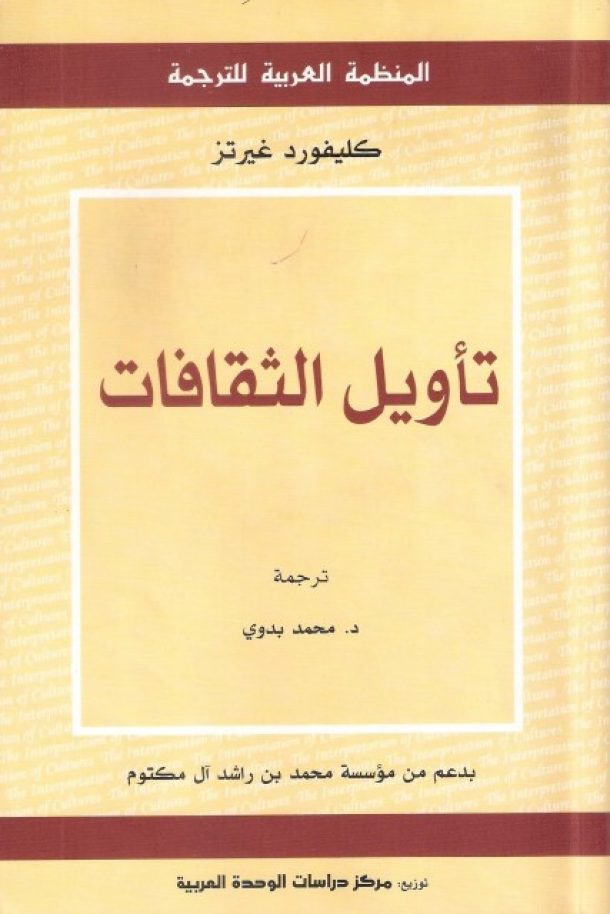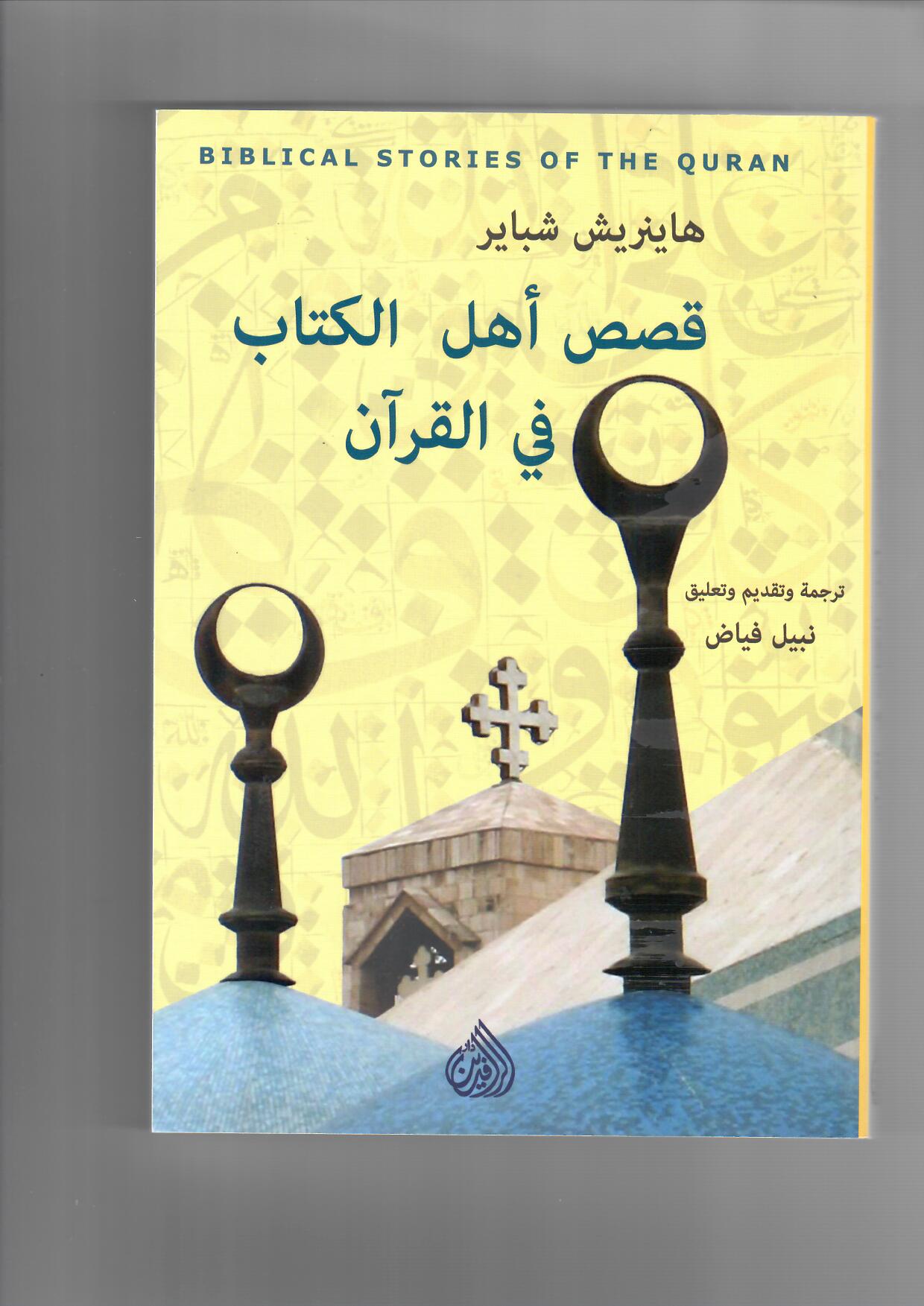قراءة: د. هيثم مزاحم – خاص بمركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط –
اسم الكتاب: تأويل الثقافات –
تأليف: كليفورد غيرتز – ترجمة: د. محمد بدوي –
الناشر: المنظمة العربية للترجمة ــ بيروت ــ طبعة أولى ــ 2009 ــ 880 صفحة.
لعل أقدم التعريفات للثقافة وأشدها رسوخاً وثباتاً كان التعريف الذي قدمه إدوارد بورنث تايلور في بداية كتابه “الثقافة البدائية”(1871)، حيث عرّف الثقافة بأنها “تلك الوحدة الكلية المعقدة التي تشمل المعرفة والإيمان والفن والأخلاق والقانون والعادات، بالإضافة الي أي قدرات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في مجتمع”. وفي كتابه “الأنثروبولوجيا”(1881)، أضاف تايلور أن الثقافة بهذا المفهوم هي شيء لا يمتلكه الإنسان.
يقول كليفورد غيرتز في كتابه “تأويل الثقافات” إن أصل الكلمة الإنجليزية للثقافة Culture يعود إلى اللاتينية Cultura التي تعني التربية. وقد شاع استعمال الكلمة بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر بمعنى تلك القدرة الإنسانية الشاملة على التعلّم ونقل المعارف واستخدامها في الحياة. وأصبح مفهوم الثقافة من المفهومات المركزية التي تعالجها الأنثروبولوجيا في القرن العشرين، وكان هو في ذلك يشمل كل ظواهر حياة الإنسان خارج نطاق الوراثة البيولوجية.
ومع التقدم الحاصل في علم الأنثروبولوجيا قدم علماء آخرون تعريفاتهم الخاصة لمفهوم الثقافة وكانت تلك التعريفات مبنية على المكتشفات الجديدة في الانثروبولوجيا. وتكاثرت تلك التعريفات حتى أن عالمي الانثروبولوجيا الأميركيين أ. ل. كروبر وكلايد كلوكن أثبتا في كتابهما المعنون “الثقافة: مراجعة نقدية للمفهومات والتعريفات” تعريفاً يتراوح بين “السلوك المثقف” إلى “الأفكار في العقل”، إلى “التركيب المنطقي”، إلى “آلية الدفاع النفسية”، وما إلى ذلك. إلا أن التعريف المفضل عنهما وعند الكثير من الدراسين هو أن الثقافة “عملية تجريدية” أي “تجريد مستخلص من السلوك” ولكنها ليست سلوكاً.
وحاول ليزلي وايت أن يقدم حلاً لإشكال أثير حول كيف يمكن لشيء مجرد، أي الثقافة، أن يكون موضوعاً لعلم وبحث، وذلك في مقالته “مفهوم الثقافة (1959) حين أكد أن القضية ليست في ما إذا كانت الثقافة شيئاً حقيقياً أو مجردأً، بل القضية كل القضية هي في السياق الذي يجري فيه التأويل العلمي. فعندما ينظر إلى الأشياء والأحداث في سياق علاقاتها بالإنسان، فهي تؤلف السلوك. وعندما ينظر إليها ليس من خلال علاقاتها بالإنسان، بل علاقتها بعضها ببعض، فهي تصبح ثقافة.
وتكتسب الثقافة حياة واستمرارية خاصتين بها، وهي تتطوّر على نحو ليس بالمستطاع تفسيره بشكل مرض، بحيث يصبح وجوده ، بما يحمل من لغة ومعتقدات وأدوات وأعراف.. إلخ، خارجاً عن نطاق إرادة الفرد بذاته. وهو بذلك يخدم في حماية حياة المرء وتحسين حياته. ثم إن كل مجموعة من الناس، أكانت قبيلة أو أمة، تطور أنظمتها الخاصة من ضمن ما يمكن تسميته بـ”ثقافتها الخاصة” التي تشترك فيها مع مجموعات أخرى ببعض الخصائص وتنفرد فيها بخصائص أخرى. ومن وجهة نظر بنيوية يمكن أن ندعو الثقافة العامة بالـ”Langue” )الخصائص العامة التي تميز التراث بشكل عام(، بينما تكون الثقافة الفردية للمجموعات بمثابة الـParole)الخصائص الخاصة التي تميز كل ثقافة بذاتها (.
تأثير الثقافة
وللثقافة في حياة الانسان الفرد أثر لا يمكن تحديد مداه بدقة ولا يمكن أن ينكر، فالطفل يدخل العالم من دون فكرة مسبقة ومن دون ثقافة. وتتشكل شخصيته وسلوكاته ومواقفه وقيمه ومعتقداته بالثقافة التي تحيط به من كل جانب. إن سيطرة الثقافة على المرء تبلغ من القوة حداً يجعله ينصاع لأوامرها ونواهيها حتى في ما يعاكس نوازعه الفطرية. وهذا ما حدا بالكثير من الباحثين الى النظر في التاثير الذي تمارسه العوامل البيولوجية والثقافية في تشكيل الشخصية الانسانية. ويرى الدارسون في حقول الانروبولوجيا وعلم الاجتماع أن تأثير البيئة الطبيعية على الثقافة كبير جداً لكنها ليست العامل الوحيد المحدد فيها. وقد لاحظوا أن الثقافة معدية بمعنى أن العقائد والعادات والأدوات وحتى الحكايات الشعبية كلها قالة للانتقال من ثقافة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
وبينما نرى الانتشار الثقافي يحدث بين متساويين في القوة السياسية أو العسكرية أو متساويين في مستوى التقدم الثقافي، فإن له اسماً آخر عندما يجري بين طرفين تفصل بينهما هوة واسعة في هذا المجال هو الغزو الثقافي Acculturation. فكما في حالات الاستعمار الحديث ان ثقافة الطرف الاقوى تفرض على الشعوب الاقل تطوراً، كما في بلدان افريقيا واميركا اللاتينية وسواهما. ومع ذلك تتسرب من الشعوب المقهورة عناصر ثقافية تتخلل ثقافة الشعوب القاهرة.
وكانت من أكبر المشاكل التي واجهت علماء الأعراق في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مسألة تفسير التشابه بين في جوانب ثقافية بين شعوب تفصل بينها مسافات بعيدة: وكانت حالة الأهرام وعبادة الشمس في مصر الفرعونية من جهة، وفي أميركا الجنوبية والوسطى من جهة أخرى إحدى الحالات. وكان السؤال الذي يطرح هو هل أن هذه الممارسات نشأت مستقلة في كل من هذه المناطق أن أنها نشأت في مصر وانتقلت من هناك إلى القارة الأميركية؟
وكان الأنثروبولوجيون الكلاسيكيون من أمثال ا. ب. تايلور ولويس ه. مورغان، الذين يقولون بوحدة الجنس البشري وتطوريته، يعبرون عن يقينهم بأن عقل الإنسان مركب بالطريقة ذاتها في كل الأمكنة، ولذلك فإن الإنسان في كل مكان يفكر بالطريقة نفسها ويطور ثقافته في خطوط متشابهة. في المقابل كان المؤمنون بنظرية انتشار الثقافة من أمثال فريتز غرايبنر وإليوت سميث يعلنون بأن الإنسان بطبيعته لا يميل إلى الإبداع، وأن الجوانب الثقافية عندما ينشئها شعب ما، تميل إلى الانتقال إلى الشعوب الأخرى والانتشار.
وتبقى هذه القضية غير محسومة حتى اليوم، والموقف السائد هو الموقف التوفيقي أي دراسة كل حالة على حدة والحكم عليها بحسب الظروف المحيطة وعدم القطع بشكل شمولي في هذه المسألة. ويميل الباحثون اليوم بشأن قضية الأه>رام إلى نظرية الأصل المستقل، فالأهرام الأميركية تختلف عن الأهرام المصرية في جوانب مهمة منها: إن الأهرام المصرية مبنية من الحجارو كلها وقد استعملت مقابر للملوك والعظماء، بينما الأهرام الأميركية مبنية من التراب ومغطاة بشرائج من الحجارة وكانت تستعمل كأماكن للعبادة.
مقاربات في دراسة الثقافة
ينظر إلى التراث تقليدياً على أنه كل متكامل معقد، لكن البحث الأنثروبولوجي يجزئ الثقافة إلى وحدات، إلى ملامح جزئية، بهدف تسهيل الدراسة، فيعتبر “الملمح” الثقافي الوحدة الأساسية في الثقافة. وقد تتخذ المقاربة منهجاً جغرافياً مناطقياً حيث يجمع الباحث الأنثروبولوجي الثقافة أو الملامح الثقافية التي تنتمي إلى منطقة جغرافية معينة تحت سلة واحدة. وذلك ما فعله الأنثروبولوجي الأميركي كلارك ويسلر في كتابيه “الهندي الأميركي” 1917 و”الإنسان والثقافة” 1923 ، حيث قسم ثقافات الهنود الأميركيين، بما كانت في أواخر القرن التساع عشر، إلى مناطق تراثية جغرافية.
وبما أن هذا الكتاب وهو مجموعة دراسات للباحث الأنثروبولوجي الأميركي كليفورد كيرتز هو بحث في الثقافة من وجهة نظر أنثروبولوجية، فينبغي تعريف الأنثروبولوجيا والحديث عن أهم مدراسها وأعلامها باختصار.
الأنثروبولوجيا: عرض تاريخي موجز
الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان هو علم حديث نسبياً انبثق من رحم الفلسفة المتزاوجة مع علم الأحياء بعيد ما سمي بالثورة الداروينية في منتصف القرن البتاسع عشر. وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجوعات الحيوانية، وتقسم الجماعات الإنسانية إلى سلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافة الإنسان ونشاطه. وتركز الأنثروبولوجيا على دراسة المجتمعات البدائية والإنسان البدائي من حيث هو جزء من الطبيعة وتبين صلته بها، وتشرح الأجناس والسلالات المختلفة من حيث خصائصها ومميزاتها ونموها الفكري وتطورها الفيزيائي والاجتماعي والتراثي، بما في ذلك الميثولوجيا، أي علم الأساطير، والفولكلور، أي الفن الشعبي.
وفي تاريخ الأنثروبولوجيا يلاحظ أن أسسها في الغرب بدأت في عصر التنوير حيث جرت محاولات منهجية لدراسة السلوك الإنساني، وهي انطلقت من علم التاريخ الطبيعي مع علماء مثل الفرنسي جورج لوي دو بوفون )1707 ــ 1788(. وكان التركيز في القرون الأربعة الماضية ينصب على دراسة الشعوب البدائية، أي غير الغربية، ولكن ذلك تغير مع الجزء الأخير من القرن العشرين حيث أخذ التركيز يتحول إلى مواضيع غربية مع محاولة تشريح النظام الطبقي والتوزع المناطقي والعرقي ضمن المجتمعات الغربية.
يعتبر إدوارد تايلور 1822 ــ 1917من الرواد السابقين في الأنثروبولوجيا التراثية، التي كانت سائدة في بريطانيا، بل المؤسس لها. وكان لكتابه الأبرز “الثقافة البدائية” 1871 أثر كبير في تطوير النظرية القائلة بالعلاقة الارتقائية من الثقافات البدائية إلى الحديثة. وقدم تايلور في الكتاب تعريفاً للثقافة ما زال مقبولاً وسمتعملاً في حقل الأنثروبولوجيا إلى يومنا هذا: “تلك الوحدة الكلية المعقدة التي تشمل المعرفة والإيمان والفن والأخلاق والقانون والعادات، إضافة إلى أي قدرات وعادات أخرى يكتسبها بوصفه عضواً في مجتمع”.
وقادت مطالعات تايلور ومكتشفاته إلى نوع من التبشير بوحدو الجنس البشري وتطوره من البدائية إلى الحضارة، مع تلميحات متناثرة بتفوق الإنسان الإنجليزي. وكان كتابه الأخير ” الأنثروبولوجيا، مقدمة في دراسة الإنسان والحضارة” 1881، بمثابة ملخص لكل المعلومات التي كانت معروفة في الحقل في أواخر القرن التاسع عشر.
ونجد في بررونيسلاف مالينوفسكي واحداً من أهم وأبرز الأنثروبولوجيين في القرن العشرين، ويعتبره الكثيرون مؤسس الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ويرتبط اسمه بالدراسات الميداينة الواسعة حول شعوب أوقيانيا، حيث درس سكان استراليا الأصليين، ومن ثم قبائل المايلو في غينيا الجديدة عام 1914، وتركزت ملاحظاته على نواح منعددة من حياة السكان منها: الاحتفالات والزراعة والاقتصاد، والجنس والزواج والحياة العائلية، والقانون البدائي والعادات، والسحر والخرافة، الأمر الذي مكنه من تقديم استنتاات تنظيرية ساهمت في تطوير الأنثروبولوجيا الاجتماعية.
وبرز إميل دوركهايم ومدرسته الداعية إلى اعتماد التحليل البنيوي في الأنثروبولوجيا، وإدموند ليتش الذي دعا إلى إعادة النظر في أعمال كلود ليفي ستراوس.
واستمرت المدرسة البريطانية في التركيز على النظم الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من التركيز على المواضيع الرمزية والأدبية التي كانت سائدة في المدرسة الفرنسية.
أما في الولايات المتحدة الأميركية فكانت الدراسات في الأنثروبولوجية متأثرة بوجود تجمعات الهنود الحمر، السكان الأصليين للقارة، حيث كانت تشكل مجالاً مثالياً للعمل الميداني في الأنثروبولوجيا التراثية. أما الذي وضع الأنثروبولوجيا الأميركية على سكة البحث المنهجي، والذي حاز لقب “أبو الأنثروبولوجيا الأميركية”، فهو فرانز بواس 1858 ــ 1942، حيث استعمل المنهجية العلمية للتوصل إلى فهم الحضارات والتراثات الإنسانية. وفي عام 1931 نشر كتابه “عقل الإنسان البدائي” وهو سلسلة من المحاضرات حول التراث والعرق كان يهاجم فيها التمييز ال\ي كان يمارس ضد المهاجرين من التراثات الأخرى. وتكمن الأهمية التاريخية لإنجاز بواس في الأنثروبولوجيا في أنه كان من الأوائل الذين اعتنقوا عملياً الفكرة القائلة بأن أفراد الأعراق البشرية المختلفة يمتلكون القدرة ذاتها على التطور الفكري والحضاري، وبالتالي تساوي الأعراق وعدم دونية عرق ما أو تراثه بالنسبة إلى الأعراق الأخرى.
يعتبر الكثير من المؤرخين أن مؤسس الأنثروبولوجيا في فرنسا هو مارسيل موس ابنت أخت السوسيولوجي الفرنسي الشهير إميل دوركهايم 1858 ــ 1917، وتلميذه. وبينما اهتم دوركهايم وزملاؤه بالمجتمعات المعاصرة، انصب اهتمام موس ومشاركيه على الدراسات الإثنوغرافية والاشتقاق اللغوي في تحليل المجتمعات التي لم تكن “متمايزة” كما هي الحال في الدول الأوروبية. أما كلود ليفي ستراوس (1908 ــ 2000) فقد امتدت آثار نظرته البنيوية في الأنثروبولوجيا لتشمل تخصصات أخرى عدة. وتقوم بنيوية ستراوس على تحليل الأنظمة الثقافية مثل النسب والأساطير، بالنظر إلى العلاقة البنيوية بين عناصرها، وقد امتد أثرها إلى حقول معرفية أخرى مثل الفلسفة ومقارنة الأديان والأدب وغيرها.
في ألمانيا كان العالم الأكثر تأثيراً في الأنثروبولوجيا ماكس فيبر(1864 ــ 1920) وهو كان عامل اجتماع، وقد عرف بنظريته حول الأخلاق البروتستانية وصلتها بالسببية بالجوانب الاقتصادية في الرأسمالية وبإصراره الشديد على الموضوعية العلمية وعلى تحليل الدوافع الكامنة وراء الفعل الإنساني، الأمر الذي كان له بعيد الأثر في النظرية السوسيولوجية. وقد تركزت أعمال فيبر في السنوات الأخيرة من حياه الأكاديمية بمعظمها على دراسة العلاقة بين التدين والجوانب الاقتصادية والعمل في المجتمع.
كليفورد غيرتز ( 1926 ـ 2006)
كليفورد غيرتز، مؤلف الكتاب الذي نقوم بمراجعته، كان واحداً من أبرز علماء الأنثروبولوجيا الأميركيين وأبعدهم تأثيراً خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي. وهو يعتبر مؤسس المدرسة التأويلية في الأنثروبولوجيا ومن أكبر الدعاة لإيلاء الأهمية لدراسة الرموز في الثقافة وللفكرة القائلة بأن هذه الرموز تضفي معنى ونظاماً على حياة الإنسان.
في عام 1951 قام بأبحاث ميدانية في إندونيسيا حيث درس موضوع الدين وكانت نتيجة أبحاثه في جاوة كتاب “الدين في جاوة” عام 1960. ولكنه انتقل إلى المغرب وقام بأبحاث بين 1963 و1971 وكانت من نتيجتها كتابه “ملاحظة الإسلام: التطورات الدينية في المغرب وإندونيسيا”(1968)، وهو مقارنة عميقة في الإسلام، كما يراه المغاربة والإندونيسيون.
في العام 1973 نشر كتابه تأويل الثقافات الذي نراجعه هنا، وظهر في طبعة ثانية منقحة في العام 2000، وكان معبراً عن أفكراه الأساسية في التراث، وكان له أثر مهم في الدراسات الأنثروبولوجية وأثار جدلاً كبيراً حول بعض المفاهيم التي أتى بها غيرتز. وكانت له منهجيته في الدراسات الأنثروبولوجية تقوم على تحليل المعطيات التي كان يسشتقيها من أعماله الميدانية في وسط المجتمعات التي يدرسها. وبهذا، كانت الأنثروبولوجيا التأويلية له هي قراءة النصوص بما هي كذلك. ولذلكن فإن كل عناصر الثقافة التي يجري تحليلها يجب أن تفهم في ضوء هذا التحليل النصّي. وقد توصل إلى استنتاج يقول بأن الكائن البشري هو “حيوان يصنع الرموز والمفاهيم وينشد المعاني”. كما حاول أن يستكشف الرغبة الدفينة لدى البشر “لإيجاد معنى للعالم ولتجربتهم فيه، وإعطاء هذه التجربة شكلاً ونظاماً”.
وقد قدمت كتاباته استبصارات حول مدى الثقافة وحول طبيعة البحث الأنثروبولوجي وحول فهم العلوم الاجتماعية عموماً. وقد رسم في كتاباته حداً فاصلاً بين الثقافة والهيكلية الاجتماعية، متمايزاً بذلك عن الوظيفيين أمثال ليفي ستراوس الذين كانوا يؤمنون بأن الطقوس والعادات والمؤسسات وجوانب الثقافة الأخرى يمكن فهمها على الوجه الأمثل، بالنظر إلى الأهداف التي تخدمها. وكان يحاجج بأن الثقافة تردم الفجوة بين المعطيات البيولوجية لجنسنا البشري والأشياء التي نحتاج إليها لكي نعمل بشكل فاعل في عالم معقد ومتغير يعتمد بعضه على البعض الآخر.
الأنثروبولوجيا التأويلية
يصف غيرتز الموقف الذي أدى به إلى اعتناق “الأنثروبولوجيا التأويلية” منهجاً له في خضم التشويش الذي ساد الأنثروبولوجيا في الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين، حين كانت ممزقة بين الشكوك حول ماضيها الاستعماري واحتمال الوصول إلى المعرفة الموضوعية في العلوم الإنسانية، بقوله: “كانت مساهمتي في هذه الحفلة نظرية “الأنثروبولوجيا التأويلية”، التي كانت امتداداً لاهتمامي بأنظمة المعاني والعقائد والقيم والنظرات إلى العالم وأشكال الشعور وأساليب الفكر التي كانت شعوب معيّنة تبني وجودها من ضمن شروطها”. ونظرته هذه أوضح ما تكون في كتابه “تأويل الثقافات”، وهو كتاب من 880 صفحة، سنحاول تلخيص جوهر نظريته في هذه الصفحات القليلة.
يحاجج غيرتز بأن الثقافة هي التي تضفي المعنى على العالم في أعين أصحابه، فالثقافة تُقرأ كما يُقرأ النص. والثقافة، بما هي نص، تتألف من الرموز، التي هي نواقل للمعنى. وفي مسعاه إلى بناء منهجه التحليلي الخاص، استعار مفهومات من مفكرين آخرين، أبرزها “التوصيف الكثيف” (من اليفلسوف جيلبرت رايل)، و”اللعب العميق”(من جيريمي بنثام). وهكذا مهّد غيرتز، في ابتعاده عن البحث الإمبيريقي ليدخل في عالم كتابي خاص، الطريق إلى اتجاه أدبي الطابع في الكتابات الأنثروبولوجية في الثمانينات من القرن الماضي. وقد استخدم غيرتز أسلوباً في الكتابة لاقى نقداً شديداً لتعقيده البالغ ولفتحه الطريق أمام موضة جديدة في الكتابة الأنثروبولوجية باستعمال عبارات مبهمة غير مفهومة من قبل كتاب آخرين ذوي حظ ضئيل من الموهبة والمقدرة الكتابية. كما كان غيرتز عرضة للنقد من الكثيرين الذن عارضوا نظرياته، وخصوصاً نظرته إلى الدين، حيث رأوا فيها انحيازاً وتشويشاً في رؤيتها لكيفية إشارة اللغة إلى العالم.
ومن أقسى النقود لعمل غيرتز ما كتبه ليونيل تايغر، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة روتجرز الأميركية، حيث كتب عقب وفاة غيرتز في صحية “وول ستريت جورنال” الأميركية في تشرني الأول 2006، يقول: “من غير المحتمل أن يشعر أهل الفكر بالتقدير للأثر الكبير الذي خلفه في عالم الفكر. كان هذا الأثر في العلوم الاجتماعية باعثاً على الأسى في رأيي(ورأي غيري). كان مساهماً كبيراً في ذلك اللا منطق العنيد في تشويشه الذي أصاب العلوم الاجتماعية ولا يزال. حاول من موقعه البارز والمؤثر في المعهد، أن يدمج الأنثروبولوجيا مع العلوم الإنسانية. وكانت النتيجة المؤلمة لذلك في تحويل الكثير مما يقوم ب ه علماء الأنثروبولوجيا ذوو النيات إلى شكل أعرج ومسوّش من المعرفة الأدبية. والأسوأ أنه وسّع الهوة الغريبة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية.. أخذ بالتركيز على الصلات بين الكتابة والسلوك.. كان يركز على الكلمات التي تصف الأفعال بدلاً من التركيز على الأفعال ذاتها..”.
“تأويل الثقافات”
كان لكتاب “تأويل الثقافات وقع كبير في عالم الفكر وفي حقل الأنثروبولوجيا والدراسات التراثية على وجه الخصوص، حتى إن الملحق الأدبي لصحيفة “التايمز” اللندنية وصفه في العام 1995 بأنه واحد من أهم مئة كتاب صدرت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
والكتاب هو مجموعة مقالات كان نشرها غيرتز في الستينات من القرن الماضي، يعترف غيرتز بأنه لا يجد الكثير مما يربط بينها سوى أنها من تأليفه. إلا أنه عاد فوجد ما يجمع بينها أكثر من ذلك في حقيقة أنها كلها تعالج مسائل تتعلق بالثقافة من وجهة نظر “الأنثروبولوجيا الرمزية” التي اتخذها منهجاً له. وليوضح ذلك ويؤسس له نظرياً، كتب ــ بناء على نصيحة محرّر الكتاب ــ مقدمة نظرية شكلت الفصل الأول، بعنوان “التوصيف الكثيف: نحو نظرية تأويلية للثقافة”. ويقدم هذا الفصل الأساس النظري الذي تقوم عليه سائر فصول الكتاب. ويتألف هذا الأساس بمعظمه من مفهوم “التوصيف الكثيف” الذي استعاره من الفيلسوف البريطاني جيلبرت رايل (1900 ــ 1976)، الذي ميّز بين وصف ما يظهر من فعل ما أو سلوك ما(التوصيف الرقيق)، ووصف هذا الفعل أو السلوك في السياق الذي يجري فيه(التوصيف الكثيف)، وهو ما يؤدي إلى فهم أفضل لهذا السلوك.
والمثال الذي يورده غيرتز على ذلك، هو الغمزة، فالتوصيف الرقيق يصف فعل الغمز الظاهر بأنه مجرد تحريك لجفن العين فقط. أما التوصيف الكثيف فيخربنا ما إذا كانت الغمزة مجرد اختلاج لا إرادي للجفن أو إشارة خفية للتواصل بين اثنين أو حركة هازئة من شخص يقلد غامزاً آخر أو … إلخ.
هذا المنهج اعتمده غيرتز في ملاحظاته ومراقباته في عمله الميداني في إندونيسيا والمغرب بشكل أساس. فالنظر في الأبعاغد الممزية للعمل الاجتماعي ــ سواء كان فناً أو ديناً أو عقيدة أو علماً أو قانوناً.. ــ يعني عدم إشاحة النظر عن الإشكالات الوجودية في الحياة لمصلحة أشكال جامدة في العلم، بل هي الغوص في لجة هذه الإشكالات لتفسيرها وتحليلها من الداخل. وبهذا تكون مهمة الأنثروبولوجي التأويلي ليس تقديم إجاباته عن الأسئلة العميقة في الوجود، بل في تقديم الإجابات التي قدمها الآخرون في ثقافات أخرى عن هذه الأسئلة.
أثر مفهوم الثقافة في مفهوم الإنسان
في الفصل الثاني وعنوانه “أثر مفهوم الثقافة في مفهوم الإنسان” يؤكد غيرتز أن على الباحث لكي يصل إلى حقيقة الإنسانية المباشرة أن يغوص في الحقائق ليصل إلى التفاصيل الصغيرة، متجاوزاً التسميات المضللة والتصنيفات الشائعة والتشابهات الفارغة، كي يصل إلى فهم ثابت ليس فقط للطبيعة الأساسية للتراثات المختلفة، بل أيضاً للأفراد داخل هذه التراثات. فالوصول إلى العام يمر خلال التفاصيل والأشياء الملموسة عبر تحليل التطوّر المادي، وتحليل طريقة عمل الجهاز العسبي للإنسان، وتحليل التنظيم الاجتماعي الذي ينخرط فيه الإنسان، وتحليل العملية النفسية التي تحصل داخل عقل الإنسان، وعبر الأنماط الثقافية التي يعيش فيها الإنسان، وتحليل التفاعل بين كل هذه الظواهر.
ويعالج الفصل الثالث موضوع طبيعة العق والتفكير، وعنوانه “نمو الثقافة وتطور العقل”. ويعر غيرتز عن يقين راسخ بأن التفكير عملية خاصة تجري في خفايا النفس الإنسانية، بل هو عملية علنية تجري في الحياة المجتمعية في الأماكن العامة، في الحياة اليومية بتفاصيلها المادية الملموسة. وينطبق خط المناقشة نفسه على الثقافة حيث ينبغي تلمّس طبيعة الثقافة ليس في المناحي المنغلقة في ذلك التراث، أي في السلوك الفردي أو التنظيم الاجتماعي أو التركيبة العصبية للفرد، بل في النظر إلى كل تلك المناحي نظرة شاملة من وجهة العلوم السلوكية كلها.
الدين كنظام ثقافي
“الدين بوصفه نظاماً ثقافياً” هو عنوان الفصل الرابع الذي يعالج هذا الموضوع معالجة أنثروبولوجية، وهي عملية ذات مرحلتين. تتكون المرحلة الأولى من تحليل نظام المعاني المتجسد في الرموز التي تشكل الدين بما هو كذلك. وتتكون المرحلة الثانية من ربط هذه الأنظمة بالتركيبة الاجتماعية وبالعمليات النفسية. ويأخذ غيرتز على الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة ليس مجرد اهتمامها بالمرحلة الثانية بل إهمالها تماماً للمرحلة الأولى. وبذلك تتجاهل الأمور التي تحتاج إلى التوضيح وتنظر إليها النظرة إلى الأشياء المسلم بها التي لا تحتاج إلى عناية خاصة. فهو يقترح عدم إغفال الظروف التفصيلية في الظواهر الاجتماعية، فهو على سبيل المثال، يقترح إلقاء الضوء على ممارسة الأسلاف ودورها في الوراثة السياسية، ودور أعياد تقديم الأضاحي في تحديد الواجبات التي يفرضها النسب، ودور الكهانة في تقوية النظام الاجتماعي.
في الفصل الخامس، يتابع غيرتز معالجة الجوانب الدينية في المجتمع وأثره في الحياة الفردية والمجتمعية. ويعبّر عن قناعته بأن الدين لم يكن قط مجرد يقينات ما ورائية، بل هو، في وجدان أتباعه، متشبع بقواعد سيلوكية أخلاقية، ولم يكن قط مجرد إيمان بحقائق غيبية بل هو مشفوع بالحض على العمل الصالح من ضمن التعاليم الدينية. ويعترف المؤلف بأن تعبيري “روح” الجماعة” و”النظرة إلى العالم” يشيران إلى مفهومين غامضين ينقصهما التحديد الدقيق. ولك الأنثرولولوجيين قد تمكنوا بواسطتهما من تطوير مقاربة لدراسة القيم التي تستطيع توضيح العمليات الأساسية المستعملة في ضبط السلوك. وهذا يكون دور الأنثروبولوجيا في تحليل القيم الأخلاقية ليس في استبدال البحث الفلسفي بل في جعله مرتبطاً بالواقع وذا فائدة له.
ويكمل غيرتز دراسته لجوانب الدين في الفصل السادس تحت عنوان “التعبير الديني والتغيير الاجتماعي: نموذج جاوي”. ويصف طقساً مميّزاً يمارسه أهل جاوة هو “السلامتان”، وهو احتفال يمارسه الأهالي في مناسبات مختلفة: المرض، الموت، الزواج…إلخ. ويتكون هذا الطقس من لقاء يعقد في بيت المحتفل ويحضره الجيران من مختلف الأديان، ويقدم فيه الطعام وتتلى فيه الأناشيد… ويصف غيرتز كيف يسهم هذا الطقس الاحتفالي في تمتين العلاقة بين الجيران من مختلف الأديان. ويمضي في وصف كيف أن التغييرات السياسية والاجتماعية التي أصابت جاوة والانقسامات الحادة التي أفرزتها الخلافات السياسية قد ضربت علاقات الجيرة والمودة وأفشلت المساعي المتمثلة في “السلامتان”.
في الفصل السابع وعنوانه “التحوّل الداخلي في بالي المعاصرة”، يبقى غيرتز في إندونيسيا، ولكنه ينتقل من جاوة إلى جزيرة بالي الصغيرة، ليقدم وصفاً تفصيلياً للمكوّنات الدينية في المجتمع الباليني مع رعض تاريخي موجز لتطوّر الديانية البالينية المنبثقة عن الهندوسية.
الأيديولوجيا نظاماً تراثياً
يتناول غيرتز في الفصل الثامن من كتابه، وعنوانه “الأيديولوجيا نظاماً تراثياً”، الأيديولوجيا ودورها في المجتمعات المعاصرة وفقدانها للحظوة في عالم الفكر، حتى أنها أصبحت بمثابة نقد وتعبير، وذلك لمخالفتها مفهوم الموضوعية المطلوبة في العلم. وأصبح مفهوم الأيديولوجيا مرادفاً للتصلّب في الرأي، الذي غالباً ما يكون على خطأ. والأيديولوجيا ــ في رأي غيرتز ــ تميل إلى التبسيط والتوضيح والتسطيح، ولو أدى ذلك إلى عدم إنصاف الموضوع المبحوث. ويعطي مثالاً عن دور الأيديولوجيا في الدول “الجديدة”، أي التي نالت اتسقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة إندونيسيا حيث بلغ التشويش الأيديولوجي مداه مع امتزاجه في التأثيرات الهندوسية والإسلامية والمسيحية والبوذية.
في الفصل التاسع، وعنوانه “ما بعد الثورة: مصير القومية في الدول الجديدة”، يعيد غيرتز تسليط الضوء على سياسات الدول الجديدة التي نشأت بين عامي 1945 و1965، وخاصة الجيل الثاني من القادة الذين أتوا بعد القادة الملهمين الذين كانوا يتمتعون بكاريزما هائلة، مثل المهاتما غاندي وجواهر آل نهرو وسوكارنو والملك المغربي محمد الخامس ومحمد علي نجاح وأحمد بن بللا وجمال عبد الناصر. ثم يصف صعود الطبقة الوسطى أي رجال الإدارة الذين ورثوا الطبقة الإدارية الاستعمارية. كما يصف المراحل الأربع التي مرت بها الفكرة القومية في هذه الدول، ليشرح التضاد القائم بين ما سمّاه الذاتية الأساسية (المتعلقة بالخصائص الموروثة للعرق أو الجنس والدين واللغة) وبين المعاصرة(السعي إلى اللحاق بركاب العالم المعاصر في النواحي السياسة والإدارية)، وخصوصاً في إندونيسيا والمغرب. ويخلص غيرتز إلى القول بأن الروح القومية، كما الدين، كانت سبباً في الكثير من المآسي التي تعرض لها الجنس البشري.
ويتابع المؤلف كليفورد غيرتز بحثه هذا في الفصل العاشر، تحت عنوان “الثورة التكاملية: المشاعر الفطرية والسياسية المدنية في الدول الجديدة”. وهو يستخدم عبارة “الغرائزية” للإشارة إلى كل الامشاعر الفطرية التي تشكّل الهوية الذاتية لطائفة ما ضمن مجتمع أوسع وتميّزها في مقابل الطوائف الأخرى: مثل اللغة في الهند، والروح المناطقية في إندونيسيا، والتقاليد في المغرب، والمذهبية في العراق، واللغة والعرق في سيريلانكا، والقبلية في كردستان، والعرق والقومية في أفريقيا..، إلخ.
ويخلص الكاتب إلى أن جميع التجمعات السكانية في “الدول الجديدة” تعيش حالة تمزّق وتوتر بين شعورين أو تيارين كبيرين، هما الرغبة في المحافظة على مكوّنات الهوية الذاتية من جهة، والرغبة في بناء دولة حديثة والانخراط الفاعل في المجتمع الدولي وسياساته من جهة أخرى. وهو يرى أن “الثورة التكاملية” تتجسد في دمج هذين الشعورين، بحيث لا يتحقق أحدهما على حساب الآخر. وينتقل المؤلف إلى بحث الوضع بشيء من التفصيل في عدد من هذه الدول الجديدة في ضوء هذا التقسيم ومدى تحقق التكامل فيها. ومن هذه الدول: إندونيسيا ومالايا وبورما والهند ولبنان والمغرب ونيجيريا. لكنه يعمل على تحديث معلوماته بإضافة بعض المستجدات التي حصلت على صعيد التكامل في كل دولة من هذه الدول، منذ وقت الطبعة الأولى عام 1973 إلى وقت نشر الطبعة الثانية عام 2000.
وتجدر الملاحظة هنا أن توصيف غيرتز لواقع هذه الدول، وخصوصاً الإسلامية والعربية منها، دقيق ويعبّر عن واقعها في هذا القرن الحادي والعشرين، مع أن الكتاب يعود إلى العام 1973 وبعض المقالات تعود إلى الستينات. فأزمة الهوية تهيمن على المجتمعات العربية والإسلامية الهندوسية، والصراعات العرقية والطائفية تمزق هذه الدول، خصوصاً في لبنان والعراق والهند وإندونيسيا وسيريلانكا ونيجيريا. لكن لا يمكن إغفال دور المستعمر الغربي في خلق هذه الانقسامات، تاريخياً وفي الوقت الراهن، سواء في الهند وإندونيسيا وتقسيمهما، أو في احتلال العراق وإخراج مارد الطائفية من قمقمه وإذكاء الصراعات المذهبية والعرقية فيه.
سياسة المعنى
يعالج الفصل الحادي عشر وعنوانه “سياسة المعنى” حالة إندونيسيا فيعود غيرتز إلى كتاب “التراث والسياسة في إندونيسيا” الذي اشترك في تأليفه مع عدة مؤلفين، بعد وقوع المجازر الأهلية التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف في العام 1964. ويلاحظ تركيز المؤلف بشكل كامل على العوامل المحلية للأزمات التي تعاني منها الدول الجديدة وغض النظر بالكامل عن العوامل الخارجية، التي اصطلح على تسميتها بـ”لعبة الأمم”، ودور الدول الكبرى في تأجيج الصراعات الداخلية فيها.
وفي الفصل الثاني عشر يواصل غيرتز تحليل أوضاع الدول الجديدة بعنوان “السياسة في الماضي، السياسة في الحاضر: بعض الملاحظات حول استعمال الأنثروبولوجيا في فهم الدول الجديدة”. ويشرح المؤلف كيف أن العلوم المختلفة من علوم الاجتماع والنفس والسياسة والتاريخ والاقتصاد والأنثروبولوجيا تضافرت جهودها لدراسة المعطيات المنبثقة من تجارب الدول الجديدة المتشكلة والمتعثرة. ويقدم مثالاً هو النموذج الباليني في بالي الإندونيسية حيث يعرض للتراث الباليني منذ القرن التاسع عشر، وكيف كانتع الحياة البالينية بمجملها تدور حول الاحتفالات الطقوسية الدينية.
يكرّس غيرتز الفصل الثالث عشر ، وعنوانه “البدائي الذكي: حول عمل كلود ليفي ستراوس”، للحديث عن حياة هذا الأنثروبولوجي الفرنسي الشهير ومنجزاته والذي كان له الأثر العظيم في ترسيخ هذا العلم في القرن العشرين. ويتركز الفصل على كتاب ستراوس “مدارات حزينة” الذي كان أشبه بسيرة ذاتية تقص بأسلوب شاعري رحلات ليفي ستراوس في أدغال أميركا اللاتينية بحثاً عن “الإنسان البدائي” في حالته الفطرية، في محاولة لفهم جوهر النفس الإنسانية قبل أن تغطيه غشاوات الحضارة. ويروي خيبة أمل ستراوس عندما وجد أنه لم يعد هناك وجود للإنسان البدائي، بصورته الرومانسية التي تستثير علم الأنثروبولوجيا، حيث إن وجود المجتمعات البدائية قد أصبح ملوّثاً بقذارات الحضارة الأوروبية. وحتى عندما وجد مجتمعاً بدائياً في صورته الفطرية، لم يتمكن من النفاذ إلى قرارته بسبب الحواجز اللغوية والتراثية الكثيفة.
لكن غيرتز كان يرى بصيص أمل بالنفاذ إلى جوهر الحياة الإنسانية، إن لم يكن من طريق العمل الميداني مع القبائل البدائية، فمن طريق دراسة آثارها وتجميعها وتنظيفها من قذارات الحضارة، لتكوين الصورة المطلوبة.
في الفصل الرابع عشر، وعنوانه “الشخص والزمن والسلوك في بالي”، يعالج المؤلف الجوانب الثقافية في بالي التي تكوّن وتحدد مفهوم “الشخص” والجوانب المتعلقة بإدراك الزمن وجريانه. وهو يبدأ ببسط القول في تقسيم الأشخاص بحسب العلاقات الزمنية التي تربطهم بعضهم ببعض. فهناك السلف، والمعاصرون الذين يعيشون معه في الزمن نفسه، والمصاحبون، الذين تربطهم به علاقات مصلحة وعمل، والخلف. وينطلق غيرتز من ذلك كي يبيّن الأنظمة البالينية لتعريف الأشخاص ويعدد ستة تصنيفات تستخدم في بالي لمخاطبة الشخص أو الإشارة إليه وهي: الأسماء الشخصية، أسماء ترتيب الولادة في العائلة، مصطلحات النسب والقرابة، والكنية، واستعمال اسم الإبن في الإشارة إلى الأب، ألقاب المكانة الاجتماعية(الطبقية)، الألقاب العامة.
أما الفصل الخامس عشر والأخيرن وعنوانه “العب العميق: ملاحظات حول صراع الديكة في بالي”، فهو في الأصل مقالة كتبها ونشرها المؤلف غيرتز سابقاً واستجرّت نقداً ونقاشاً طويلين من المختصين في حقل الأنثروبولوجيا. وقد عدّت تمريناً عملياً في منهجية “التوصيف الكثيف” التي تعتمد تسليط الضوء على السياق في شرح الفعل الإنساني ولا تكتفي بسرد الوقائع. ويبدأ الفصل برواية خاضها غيرتز مع زوجته في بداية إقامتة في قرية في بالي حيث كان بتجاهلهما الأهالي كلياً. واستمرّ ذلك التجاهل حتى حصول حادث تعرّض فيه الزوجان مع الأهالي لمداهمة من الشرطة لقمع مباراة صراع الديوك، التي كانت محظورة قانوناً. وقد أضحى غيرتز بع ذلك مقبولاً ومرحباً به في المجتمع الباليني، بعدما وجد القرويون أن المصيبة جمعتهم.
كما يروي غيرتز تفاصيل لعبة صراع الديوك وأهميتها بالنسبة إلى المجتمع والأساطير التي تدور حولها وعمليات المراهنة على الديوك. ويستعير المؤلف عبارة “اللعب العميق” للفيلسوف البريطاني جيريمي بنثام للإشارة إلى الحالة التفسية والواقعية التي تسيطر على الباليني عندما ينغمس في المراهنة بشكل عميق مستغرق لأسباب لا شعورية إلى حد بعيد. فالباليني بحسب غيرتز، لا يراهن لأجل المال ولا لأجل الجاه، بل لإثبات وجوده على نحو يدرك هو كنهه تماماً.