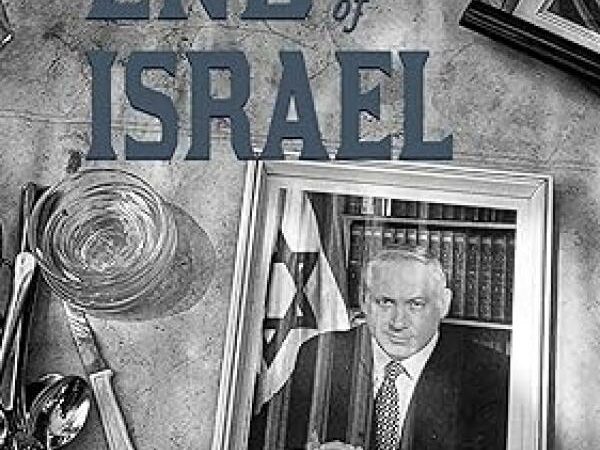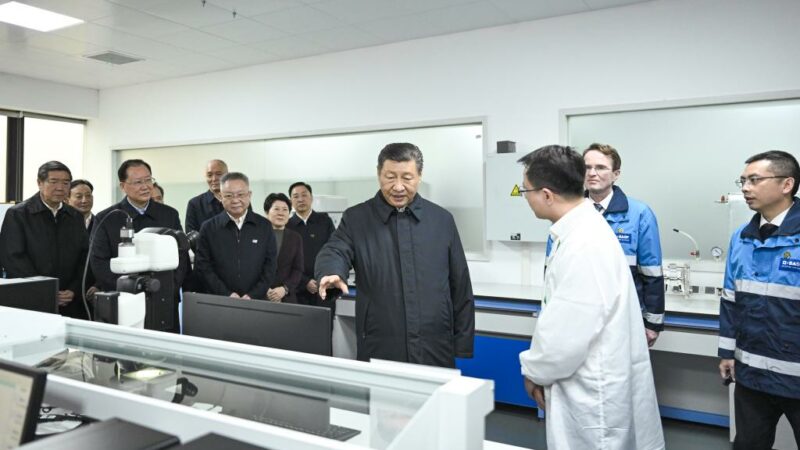محيي الدين بن عربي من عنف الأسماء إلى نفس الرحمن

تقديم لكتاب: “لماذا نكفّر: ابن عربي من عنف الأسماء إلى نفس الرحمن”. تأليف: د. علي الديري. الكتاب تحت الطبع. يصدر عن مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد، ودار التنوير في بيروت
بقلم: عبدالجبار الرفاعي — فرغتُ من مطالعةِ مخطوطةِ كتاب “لماذا نكفّر: ابن عربي من عنف الأسماء إلى نفس الرحمن” للصديق د. علي الديري، وكتابُه هذا كأعماله السابقة يشدّ القارئ إليه بقوة ويفرض عليه أن يمضي معه حتى الختام، وألا يغادره إلى غيره إلا بعد أن يفرغ منه.
درستُ كتابَ “فصوص الحكم” في الحوزة، وطالعتُ كلَّ ما وقع بيدي من كتاباتٍ تشرح أفكارَ الشيخ محيي الدين بن عربي وأحوالَه ومكاشفاتِه وإشراقاتِه الروحية، ولكلّ شارحٍ من الشرّاح أسلوبُه وطريقةُ فهمه لنصوص الشيخ الأكبر، فمنهم من تماهى معه حدّ محاكاته بكلّ شيء، ومنهم من حاول أن يقدّم تأويلاتِه لما كتب في أفق رؤيته لله والإنسان والعالم، ومنهم من تورّط في سكب مقولاته في قوالب غُلاة المتصوّفة، ومنهم من سكبها في قوالب غُلاة الشيعة، ومنهم من وقع أسيرَ الأبعاد الجمالية في عباراته، ومنهم من فُتن بالأبعاد الرمزية لإشاراته، لكني قلّما طالعتُ كتابًا حاول أن يلخّص لنا الرؤيةَ التوحيديةَ للشيخ الأكبر بلغةٍ مقتصِدةٍ واضحةٍ تقترب من السهل الممتنِع، وتنتظم في سياقها المفاهيمُ المحوريةُ وما يتفرّع عنها بشكل منطقي. ولا تقود القارئ إلى منعرجات تفكير محيي الدين أو المناطق المبهمة فيه، وتقلل من الإحالة على رمزياته وإشاراته، وتبرع في اكتشاف ما بدّده وشتّته ابنُ عربي عمدًا مما يؤشرُ لكلّيات عقيدته، كما ينبه هو لذلك. إذ تعمّدَ ابنُ عربي الإبهامَ والغموضَ أحيانًا، لذلك حرص في بعض كتبه أن يتحدّث عن “عقيدة الخلاصة” في مواضع متفرّقة من كتاب واحد، فنجده يصرّح بذلك في الفتوحات المكية قائلًا: “وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على التعيين لما فيها من الغموض، ولكن جئت بها مبدّدة في أبواب هذا الكتاب، مستوفاة مبينة، ولكنها كما ذكرنا متفرقة”. وهذا الضربُ من الكتابة المقتصِدة تتطلب فطنةً كفطنة الديري، وهي لا توهَب إلا لمن لم يتوقف عند العقل فقط، بل توغل في عوالم الروح أيضًا، فصار قادرًا على تذوّقِ مكاشفاتِ الشيخ محيي الدين والسياحةِ في معاني بحره العميق.
كتابُ الديري هذا يضعك مباشرةً في قلب عوالم معنى الحياة الروحية للشيخ الأكبر، بلا مقدماتٍ واستطراداتٍ وفائضٍ لفظي ومقتبساتٍ يترهل بها الكتابُ، ويضيع فيها القارئ في متاهات الكلمات.
اللافتُ في ما كتبه الديري عن المتصوّفة وبخاصة محيي الدين أنه تلخيصٌ واضح للرؤية التوحيدية للشيخ الأكبر، لأنه حاول أن يختصر علينا مسافاتٍ طويلةً نستنزف فيها سنواتٍ ثمينةً من شبابنا في دراسةِ فصوصِ الشيخِ الأكبر ومطالعة أعمالِه، فأنا أحدُ الذين خسروا مثلَ هذه السنوات، عندما كنتُ تلميذًا مولعًا بدراسةِ فصوصِ الحكم وفهمِهِ على متخصّصين في حوزة قم. وحتى اليوم أمضى بعضُ معلمي فصوص الحكم أكثرَ من اثنتي عشرة سنة في تدريس هذا الكتاب لتلامذته ومازال لم يفرغ منه، وهو كتابٌ لا يتجاوز نصُّه الأصلي، مجرّدًا من التعليقات والشروح، المائةَ وخمسين صفحة. وعلى الرغم من أن الديري لم يكن يومًا ما تلميذًا في الحوزة، ولم أعرف عنه أنه تلمذ على مثل شيوخها المتخصصين بابن عربي، لكن في كلّ مرة يفاجئني بفهمِه الذكي لابن عربي، وخبرتِه المتميزة في آثارِ المتصوّفة وأحوالِهم.
من قبل فوجئتُ بأطروحته للدكتوراه التي أرسل لي مخطوطتَها وطلب مني قراءتَها، مثلما فاجأني بعمله هذا اليوم، وأظن أن مفاجأتي تحيل إلى ما ترسّب في وعيي الباطن من حكايات نُلقّنها في مجالس المذاكرة في الحوزة، توحي لنا بأن ما ندرسه لا يمكن أن يفهمه أحدٌ بلا تلمذة مماثلة لتلمذتنا، بل إني سمعتُ قبل ربع قرن من صديق، كان تلميذًا يدرس “فصوص الحكم” في الحوزة عند أحد المدرسين، حُكمًا سلبيًّا على شرح د. أبو العُلا عفيفي للفصوص، إذ قال في سياق حديثه عن هذا الشرح: “إن أبا العُلا عفيفي لم يفهم الكتاب”. ومن الطريف أني قبل ذلك بسنوات كنتُ أعرف بالتفصيل سيرةَ أبي العُلا عفيفي الفكرية وتكوينَه الأكاديمي الرصين، فقد تعلّمَ على أحد أبرز الخبراء في العالم بمحيي الدين، وهو أستاذه المعروف رينولد نيكلسون “1868 – 1945م”، الذي كتبَ أطروحتَه للدكتوراه تحت إشرافه في جامعة كامبريدج بعنوان: “فلسفة ابن عربي الصوفية” وناقشها سنة 1930م. وذلك ما أهّلَ عفيفي لأن يكون أبًا لجيل لامع من الأكاديميين العرب المتخصصين بالتصوّف وبابن عربي خاصة. كما قرأتُ شرحَ الدكتور عفيفي فرأيتُ كيف تمكّن أن يقدّم تفسيرًا علميًّا واضحًا لفصوص الحكم، يجعله في متناول كلّ دارس لديه إلمامٌ بألفباء التصوّف الفلسفي.
لذلك تألمتُ من الحكم السلبي لتلميذ الفصوص صديقي على شرح عفيفي، وإن كان مثلُ هذا الحكم ليس غريبًا عليَّ في بيئةٍ عشتُ فيها أكثرَ من أربعين عامًا تلميذًا وأستاذًا، وأعرفُ نرجسيةَ الفهم التي تتوالد في لاوعينا، نحن الذين نغوص في الكتب القديمة، ونمضي العمرَ في فضاء متونها وهوامشها، حتى نصلَ إلى حالةٍ لا نكاد نرى فيها أسلوبًا للتعليم متفوّقًا على أسلوبنا، أو نظن بأن منهجًا للفهم متفوّقٌ على منهجنا، ولا نعتقد بوجود فهمٍ موازٍ لفهمنا لهذه المتون التي ندرسها، فضلًا عن أن يكون متجاوزًا له.
لم يترك لنا الخبراءُ بابن عربي مدخلًا ميسرًا لدراستِه والتعرّفِ على رؤيته لله والإنسان والعالم، وهذا الكتابُ، على صغر حجمه، يوفر على المهتمّ بابن عربي الكثيرَ من الزمن والجهد اللذين يتطلبهما التعرّفُ على خلاصة لرؤيته المحورية، من خلال غوصِ المؤلف في أعماله العميقة، وملاحقةِ تفسيراتها وما كُتب عنه وعنها. هذا الكتابُ يمكن أن يكون مدخلًا أوليًّا لدراسةِ الرؤية التوحيدية للشيخ محيي الدين واكتشاف معالمها في آثاره المتنوعة، إذ استطاع الدكتور الديري أن يدلّنا على خارطةِ هذه الرؤية لدى الشيخ الأكبر، والتي يمكن أن تكون مُلهمة لحياتنا الدينية اليوم، ذلك أن الحياة الدينية وما يتشكّل في سياقها من قيم روحية وأخلاقية تولد وتتكّون في رحم الكيفية التي تحضر فيها صورةُ الله في الضمير.
الديري يدرك المحنةَ التي يعيشها المسلمُ اليوم، وكيف صار العنفُ والقتلُ لغةً يتداولها كثيرٌ من أبناء الإسلام الذين سقطوا في شراك الرؤية السلفية للتوحيد، وسجنت سلوكَهم الفتاوى المشتقّة من تلك الرؤية، فضاع في ضجيج تلك الرؤية صوتُ السلام والحق والعدل والإحسان والرحمة في القرآن. وكأن الإسلامَ لا يعرف أن يتحدّث لغةً أخرى غير العنف والقتل والموت. حرص الكاتبُ أن يدلّنا على الكنز المنسيّ للغة أخرى للإسلام يجهلها أكثرُ الشباب المسلم. لغة يمكن أن تؤسّس لتديّن يعرف أن يتكلّم لغةَ السلام والحق والعدل والاحسان والتراحم، ويعرف أن يتذوّق تجلياتِ الجمال الإلهي في الوجود. وما أشدّ حاجتنا لهذه اللغة بعد أن تفشّى في لغتنا الدينية كثيرٌ من الكلمات المسمومة.
وجدتُ هذا الكتابَ يحاولُ أن يعيد قراءةَ نصوص الشيخ محيي الدين في سياق مختلف، وكأننا معًا نفكر بطريقة متقاربة، فأنا أيضًا منذ ثلاثين عامًا ضقتُ بـ “تحجير” اللاهوت الصراطي للرحمة الإلهية، لذلك عملتُ على إعادة قراءة بعض نصوص التصوّف الفلسفي، وفي مقدمتها أعمال ابن عربي، من أجل بناء رؤيةٍ للتوحيد لا تكرّر رؤيةَ المتكلمين، ولأول مرة أنشر نموذجًا لتفكيري هذا قبل سنة، على الرغم من أن بذورَ الفكرة توالدتْ في ذهني قبل أكثر من ربع قرن، وتطورتْ ونضجتْ قبل سنوات حتى ارتسمت في ذهني ملامحُ صورتها الكاملة، لكن الإعلانَ عنها تأخّر إلى العام الماضي عندما نشرتُ صورةً أوليةً لها في مقالة، ثم شرحتُها بتفصيلٍ أكثر وتنويعاتٍ أشمل في كتابي الجديد: “الدين والاغتراب الميتافيزيقي”، الذي صدر أخيرًا ببيروت.
فقد تناولتُ في أحد فصوله كيف تخفق الرؤيةُ التوحيديةُ للمتكلمين في رسم ملامح الصورة القرآنية لله، وكيف تمكّن محيي الدين بنُ عربي وبعضُ أعلام التصوّف الفلسفي من بناء رؤيةٍ توحيديةٍ تضيء الملامحَ التي يرسمها القرآنُ لصورةِ الله، ويتطلب اكتشافها قراءة تغور في طبقات المعنى المكتنز فيه. كذلك تحدّثتُ في فصل آخر عن الرحمة الإلهية بوصفها مفتاحًا دلاليًّا لفهم المنطق الذاتي للقرآن، بوصف الرحمة تهيمنُ على مضمونه وتتحكمُ بتوجيه بوصلة دلالاته. وكيف كان الشيخ الأكبر وفيًّا للقرآن في بناء صورة الله، فصاغ رؤيتَه التوحيديةَ في قراءة أخرى لآياته، قراءة تخرج على القراءة الحرفية للآيات، وتبرع في عبور القشرة اللفظية للكلمات التي لم يغادرها أكثرُ المفسّرين إلى خزائن القرآن وجواهره. ولا يمتلك مفاتيحَ خزائن القرآن إلّا من يمتلكُ موهبةً استثنائية وبصيرةً روحية كموهبة وبصيرة الشيخ الأكبر. وذلك ما ألمح إليه الشيخُ بقوله: “فجميع ما نتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه”.
قرأتُ كتابَ الديري بشغف، وأمتعتني قراءتُه، ولا أشكّ في أني تعلمتُ منه مثلما تعلمتُ قبله من كتابات مماثلة، فالأثرُ الجميلُ الذي أطالعه أعيش معه أحيانًا وكأني أتذوّق مائدةً شهيةً بعد جوع شديد. أكثرُ الكتابات التي أتذوّقها هي ما تكون مرآةً أرى فيها ملامحَ من صورتي، وأستمع فيها إلى نغم من صوتي، وأقرأ فيها شيئًا من مفاهيمي، وتعكس آفاقَ رؤيتي للعالم. لقد كنتُ مع هذا الكتاب كأني ومؤلفَه نعزف معًا لحنًا على قيثارة واحدة، لحنًا جميلًا لا نسمع فيه إلّا نداءَ الأرواح.
إن المنجز الأهم للشيخ الأكبر وكل أعلام التصوف الفلسفي تمثل في انتاج رؤية للتوحيد تحدد للدين وظيفته كحاجة وجودية لن تستغني عنها هوية الكائن البشري بوصفه موجودًا، ولن يكون هذا الكائن قادرًا على اشباعها إلّا عبر الصلة الوجودية بالحق، هذه الصلة التي تظهر بأنماط متنوعة تتنوع بتنوع الأديان. ولم يفكّر ابنُ عربي أو غيره من متصوفة الإسلام في وضع الدولة تحت وصاية الدين كما فعلت جماعاتُ الإسلام السياسي، أو وضع الدين تحت وصاية الدولة كما فعل فقهاء السلطان. كما شدد الشيخُ محيي الدين بن عربي على أن الطاقةَ الروحية للدين تكمنُ في فاعليتهوأثره الكبير بتفجيرِ قدراتٍ كامنةٍ لروح الكائن البشري، وبعثِ وترسيخِ إرادته،بشكلٍ لا يتأتى للعقل وحده فعلُ كلّ ذلك، ويحقق الدينُ ذلك لما يتلفّع به من سحرٍ ميتافيزيقي. ويعود الفضل إليه في الكشف عن تنويعات هذا السحر الميتافيزيقي للدين، وبيان الحياة الروحية والقيم الأخلاقية في القرآن الكريم، وانقاذ المعرفة الدينية من تقنينات المتكلمين والفقهاءالصارمة، وما تنتجه تلك التقنيناتمن سلطة معرفية وتسلطيبدّد الطاقة المعنويةللدين ويطفئ جذوتَه الخلاقة.
لم ينشغل محيي الدين بنُ عربي ببناء نظرية للثورة انطلاقًا من العقيدة، كما فعل لاهوتُ التحرير في الكنيسة، ومن قلده واقتفى أثره في عالم الإسلام، المولع بتحويل الإسلام إلى أيديولوجيا للنضال والمقاومة المسلحة، وانما أعادَ الشيخُ الأكبر الدينَ إلى مجاله الروحي والأخلاقي، واهتم ببناء رؤيةٍ توحيدية لا تستنسخ الرؤيةَ التوحيديةَ للمتكلمين بفرقهم المختلفة. لم تُكره هذه الرؤيةُ المختلفَ في المعتقد على اعتناق دينها، ولم تفرض عليه نمطَ اعتقادها. وقدمت فهمًا عميقًا للتنوع في الاعتقاد بوصفه تنوعًا لصورِ الله في مختلف الأديان، وانعكاسًا لتجليات أسمائه وصفاته المتنوعة في العالم.
من مدونة علم الكلام والفقه تمكنت جماعاتُ الإسلام السياسي اشتقاق فهمٍ للدين يختزلُ كلَّ أهدافه في إنتاجِ دولة دينية، وفقًا لقراءة “كلامية فقهية”، وتفسيرٍ سياسي لنصوصه، لكن لم تسمح مدونةُ التصوّف الفلسفي والرؤيةُ للعالم التي رسمها ابنُ عربي ومن ترسّم نهجَه بذلك، لأنها اهتمت بالكشف عن الأبعادِ الغيبيةِ المتنوعة للدين، وتمحور بحثُها حول ايقاظ سحره الميتافيزيقي. لذلك لم تعثر الأدبياتُ التي أنتجتْها جماعاتُ الإسلام السياسي على رافدٍ يغذّي مراميها في هذه المدونة، فخاصمتْها وتعاطتْ معها بتجاهلٍ وفهمٍ مبتذل ساذج، وحثّتْ أتباعَها على الابتعاد عنها، إلّا أنها عثرتْ في مدونة علم الكلام والفقه على ما تنشده من أحلام تأسيس دولة دينية “كلامية فقهية”،تنفي المختلفَ في الدين، ولا تسمح بحرية الضمير الديني، وتسوّغ إعلانَ التفوق على أصحاب المعتقدات الأخرى، وتشرّع للتعاملِ معهم “أحكامَ أهل الذمة” التي هي على الضد من حق كل مواطن في الاعتقاد، وتفرض على مواطنيها من غير المسلمين التزاماتٍ وواجباتٍ تختص بهم، لا تُفرض على غيرهم من المواطنين المسلمين، ورأت من حقها أن تعلن الحربَ على آخرين وتسوّغ قتلَهم، إن كانوا من غير ذوي الذمة.
وأودّ تذكيرَ الصديق علي الديري وكلَّ من يهتمّ بالكشف عن القيم الروحية والأخلاقية والجمالية المُلهِمة في ميراث المتصوّفة إلى أني نبهتُ أكثرَ من مرة إلى أن تراثَ التصوّف سيفٌ ذو حدين، وذلك يفرض على الباحثِ أن يتنبه للثغراتِ في كتب المتصوّفة والوهنِ الذي يتغلغل في طياتها، وأن يتعاطى بيقظة مع آثارهم، فهي اجتهاداتٌ بشريةٌ وليست نصوصًا مقدّسة. وليعلم أن شيوخَ التصوّف بشرٌ تورّطَ مريدوهم في تقديسِ آرائهم وتوثينِ سلوكهم وتحويلِ شخصياتهم إلى أصنام. وتمادى المريدُ في سجن نفسه بعبوديةٍ طوعيةٍ لشيخه، وتعالتْ تعاليمُ الشيخ في وجدان الأتباع فصارت سجنًا لهم، بنحو صار المريدُ يرضخُ لها حدّ محو شخصيته ونسيان ذاته، وانتهت إلى تكبيلِهم وشلِّ حركتهم.
على الباحث في نصوص التصوّف أن ينتبه إلى أن تراثَ المتصوّفة لا يمكن استئنافُه كما هو في عالمنا اليوم، لأنه كأيّ تراث آخر صنعه البشرُ ينتمي للأفق التاريخي الذي وُلد فيه، وهو مرآةٌ للعصر الذي تكوّن فيه، إذ ترتسمُ في هذا التراث أحوالُ ذلك العصر ومختلفُ ملابساته. وهو تراثٌ يتضمن كثيرًا من المقولاتِ المناهِضة للعقل، والمفاهيمِ التي تعطّلُ إرادةَ الإنسان وتشلّ فاعليتَه، وتسلبه حريةَ العودة إلى عقله واستعمال تفكيره النقدي. وأن بعضَ أنماط التربية الروحية التي يعتمدها التصوّفُ العملي تسرف في ترويضِ الجسد، وتتنكّرُ للطبيعة البشرية، باعتمادِ أشكالٍ من الارتياض الذي يكون الجسدُ فيها ضحيةَ الجوعِ والسهرِ والبكاءِ والعزلةِ والصمتِ، فهذه الأساليب من أهمّ أركان تربية السالك لدى أغلبهم. ومثلُ هذا الارتياض العنيف طالما فرضَ على المتصوّف الانسحابَ من المجتمع والانطواءَ على الذات، وقد يفضي أيضًا إلى أمراض نفسية وحتى أخلاقية. لذلك ينبغي أن نتعاطى مع مفاهيم التصوّف بيقظة، وأن نحذر من تقليدِ أحدٍ من أعلام التصوّف في سلوكه أو نتقمص حياتَه الخاصة، وألا نقع في أسرِ أفكارِه مهما كان.
ومع كلِّ ذلك نقرأ في مؤلفات التصوّف الفلسفي ما لا نقرأه في غيرها من تراثنا، فهذه المؤلفات لا تفتقر إلى رؤًى يمكن أن تصير منطلقاتٍ لما يتطلبه عصرُنا من فهمٍ للدين ينبثق من رسمِ صورةٍ بديلةٍ لله، يضيئها السلامُ والحق والعدلُ والإحسانُ والرحمةُ والمحبةُ والجمالُ. ولا أظن أننا، خارج إشراقات صورة الله هذه، نستطيع أن ننتج تديّنًا يداوي جروحَ أرواح شبابنا الذين اختنقوا في تديّن متوحش، ويحمي مجتمعاتنا من القتل العبثي، وينقذ أوطاننا من الانهيار.
*عبدالجبار الرفاعي مفكر وكاتب عراقي، متخصص في الفلسفة الإسلامية. مدير مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد، يرأس تحرير مجلة قضايا إسلامية معاصرة منذ إصدارها عا 1997 وحتى الآن. له العديد من الإصدارات في الفكر الإسلامي والفلسفة.
المصدر: موقع مركز أفكار