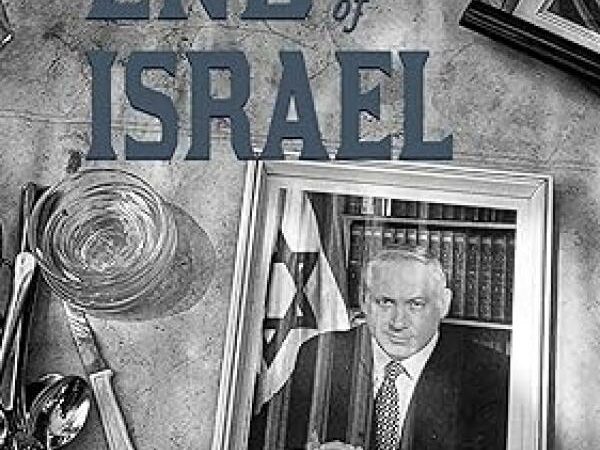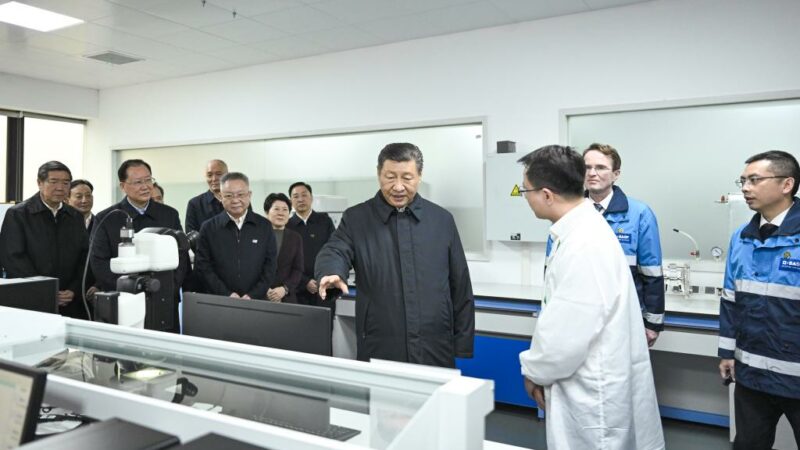“على خطى الصين يسير العالم”

خاص “شؤون آسيوية” _ مراجعة: رشا النقري |
عنوان الكتاب بالإنكليزية: As china goes, so goes the world
تأليف: كارل غيرت
ترجمة: طارق عليان
أبو ظبي: هيئة (أبو ظبي) للثقافة والفنون، مشروع “كلمة”، 2011.
نظراً لطبيعة الصين المعقدة والمليئة بالفوارق التاريخية الدقيقة يمكن أن يكون انتقاء كتاب يحاول شرح جزء يسير من خصوصيتها أمراً ليس بالسهل حتى بالنسبة لعشاق الصين. ولأنها دولة جديرة بالاهتمام في هذا العالم قدم لنا المؤلف كارل غيرث كتابه بعنوان “على خطى الصين يسير العالم” يحكي فيه قصة صعود المستهلك الصيني خلال فترة مهمة من تاريخ الصين وكيف حفزت هذه الدولة الآسيوية التي تضم أكثر من 1.4 مليار شخص اندفاعاً جديداً نحو الاستهلاكية وماذا سيعني ذلك للصين والعالم.
الصين من الشيوعية الى الاستهلاكية
كان للمؤلف بعض المقارنات المثيرة للاهتمام بين الأيام السابقة للإصلاح الاقتصادي والوضع الحالي الجديد والمُحسّن.
والأمر الاكثر دهشة سرعة انتشار أنماط الحياة الاستهلاكية في عموم الصين منذ انطلاق الإصلاحات السوقية وتحوّل الصين من مجتمع مدخّر ينتقد الاستهلاك الى أكبر مستهلك لكل شيء في العالم.
الشيء الذي انعكس على الاستهلاكية التي أصبحت تبني عادات المستهلك أكثر من أنها مجرد شراء المزيد من السلع مثل العيش في منازل كبيرة وظهور عيدان الطعام أُحادية الاستعمال وصالونات التجميل وناطحات السحاب ومراكز التسوق العالمية وامتلاك السيارات الخاصة ذات العلامات التجارية المشهورة.
فتحت الصين حدودها متجاوزة العزلة مع انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 وطورت الاستهلاك وتوسعت بالتصنيع الهائل الذي عززه الاعتماد على الصادرات والانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي.
وبحلول عام 2005 ارتفعت مبيعات الذهب وصارت الصين أكبر سوق للحلّي في العالم بعد الولايات المتحدة وأوروبا بمبيعات تبلغ 10 مليارات دولار. وعند تخفيف قيود الاستيراد للحلّي اشترى المستهلكون أكثر من 250 طناً من الذهب.
وأولى العالم اهتمامه بالاستهلاك الصيني في غضون الأزمة الاقتصادية العالمية لعام2008 وزادت نداءات الزعماء السياسيين وقادة الدول حول العالم الموجهة للصين لزيادة الاستهلاك على أمل إنقاذ الاقتصاد العالمي عبر الطلب الصيني على السلع عالية التقنية الأميركية والأوروبية.
وفي المقابل استجابت القيادة الصينية لنداءات تشجيع الاستهلاك المحلي وأنماط الحياة الحديثة وسعت لتلبية رغبات المستهلكين بوسائل متعددة، منها تسهيل الاقتراض وتعلّم شراء المزيد وتشجيع السياحة والسفر وتشجيع الإنفاق على العطلات وتغيير ثقافة الادخار الموروثة من العصر الماوي.
كل ذلك كان في ظل إحساسها المتنامي بالخطر ورغبة منها في تفادي الركود الذي عانت منه الاقتصادات الآسيوية الأخرى التي تقودها الصادرات مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وعليه، رأى المؤلف أن مستقبل الصين ومستقبل العالم سيتشكل بفعل اندفاع الصين نحو الاستهلاكية. فأينما تسير الصين، يسير العالم.
تبني ثقافة السيارات في الصين
تحدث كارل عن نشوء الاستهلاكية الصينية وبصمتها الواسعة في كل مكان تقريباً إثر عهد ماو الشيوعي، وأول ما تمثلت هذه الاستهلاكية في ثقافة صنع السيارات التي تفوقت فيها الصين على من سبقها بعقود، وصعد سوق السيارات الصينية الى العالمية وصار جزءاً مهماً من الاقتصاد الصيني.
صاحب هذه الطفرة حاجة حتمية لاستيراد كميات هائلة من النفط وفقدان البلاد لاستقلالها الطاقويّ، وارتفع الطلب العالمي على الطاقة ليشهد استهلاكها تنامياً بمعدل يزيد عن 4 أضعاف المعدل العالمي، عدا عن الاختناق المروري والتلوث وكثرة الحوادث والحاجة الى خطوط نقل جديدة وغيرها من التبعيات السلبية.
ولا يمكن لأحد أن يجادل بأن الصين لم تفهم هذه العيوب، لكن المزايا المتصورة كانت أكثر جاذبية. فطورت صناعة السيارات المحلية وشجعت على استهلاك المنتجات الوطنية لتخفيف الواردات وخلق سوق تنافسية دولية وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا من صانعي السيارات المحلية ونجحت كواحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم.
ولم تقتصر الصين على الاستهلاك المحلي وإنما عملت على تشجيع صادراتها واستهلاكها دولياً لتصدر أول مرة 170 ألف سيارة في عام 2005 وتصبح في عام 2009 كأكبر سوق للسيارات في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة بمبيعات تزيد عن 12 مليون سيارة سنوياً.
وأثبتت الدولة الصينية براعة لافتة، بدراسة أنماط المستهلك في صناعة السيارات وتشجيع استهلاكها، كما هو مخطط له، حتى أصبحت هذه الصناعة جزءاً مهماً من الاقتصاد الصيني يوفر فرص عمل لملايين الناس ويجلب إيرادات ضريبية كبيرة في بكين وشنغهاي، وزيادة في الصادرات الصينية والفوائض التجارية. كل هذه النتائج منطقية سعت إليها الصين عندما آلت على نفسها إقامة سوق سيارات محلية وخلقت الإنتاج والطلب المحلي.
وصار الصينيون أكثر دراية بالسيارات ومكانتها الاجتماعية، وتفضيلاتهم سرعان ما تقرر الخيارات المتاحة في السيارات حول العالم.
وعليه، يؤكد المؤلف أن انتشار ثقافة السيارات ووصولها الى الصين ومنها الى بقية دول العالم، حجة أساسية يسوقها هذا الكتاب وهي أن المستهلكين الصينيين أصبحوا طلائع الاستهلاكية العالمية.
ارستقراطية الصين الجديدة
من ناحية يمكننا أن نعجب بإنجازات الصين الهائلة في انتشالها الملايين من هوة الفقر في زمن قياسي وتغيراتها الاجتماعية الواسعة. وفي الوقت نفسه تخلق الصين واحداً من أشد المجتمعات تفاوتاً في التاريخ. حيث نما توق الصینیین الى السلع الاستهلاكية سريعاً وظهرت طبقة جديدة هم الأثرياء الجدد (الأرستقراطية الجديدة) رافقها طلب متزايد على منتجات الرفاهية.
وھذا ما أثار قلق الحزب الشيوعي الصيني الذي يحاول بناء مجتمع متناغم وابتكار استراتيجيات جديدة لنشر الثروة.
واحتل الصينيون الأثرياء صدارة مجتمع جديد واقتصاد يقوم على السيارات والسياحة ورحلات التزلج وممارسة الغولف، رياضة الاستجمام التي تُعبر عن أرفع المنازل شأناً في الصين، حتى بات الوعي بالعلامات التجارية المترفة وتفضيلاتها أمرين موجودين في كل مكان من فورات التسوق في مولات بكين وشنغهاي وركوب سيارات BMW وارتداء ساعات رولكس وتناول أطعمة الكونياك. تقول الإحصائيات إن 64% من أغلى أصناف الكونياك في العالم تُباع في آسيا والأغلبية العظمى تُباع في الصين.
وصار أثرياء الصين الجدد محط تركيز كثير من البرامج التلفزيونية والمجلات فمن يمتلك 6 ملايين دولار يحتل مركز في مجلة فوربس Forbes” لأغنياء الصين. وبعد أن زاد أعداد المليونيرات أصبح من يملك 150 مليون دولار على الأقل يدخل المنافسة.
وغطت مجلة “هورون ريبوت” Hurun Report حياة أكثر من600 مليونير صيني للتعرف على علاماتهم التجارية المفضلة.
ولم تكن هذه الجوانب الوحيدة لأنماط الأثرياء الحياتية التي أعيد إدخالها في عهد الإصلاح حيث عاودت المحظيات الظهور مجدداً كرمز للمنزلة الاجتماعية في الصين وأصبح لهم سوق واسع الانتشار.
ومن زاوية معينة، يبدو أن الأثرياء الجدد يشعرون بالقلق وعدم الأمان وغالباً ما يتعرضون للخطف والابتزاز. فالرأي الشعبي يتهمهم بالثراء على حساب الكثيرين وعادةً ما يوصفون بأنهم فاسدون. والجدير بالذكر أن الصينيين بوجه عام يبغضون الأثرياء ليس لبذخهم ولا لإسرافهم في الاستهلاك، بل لأنهم جمعوا ثرواتهم من مصادر غير مشروعة.
وليست الثقافة الصينية عنهم ببعيدة فهي مليئة بالتعابير المستلهمة من كونفوشيوس كقوله: “لا يمكن للمرء أن يصبح ثرياً من دون أن يكون ظالماً. كما أنه لا يوجد شيء اسمه مسؤول شريف”.
صنع في تايوان
كان لبلدان شرق آسيا وخصوصاً تايوان تأثير قوي ومبكر على انتشار الاستهلاكية الصينية. في البداية زادت التدفقات الثقافية بين الصين وتايوان وبعد عام 1987 خففت الحكومة التايوانية القيود على البر الرئيس.
أحدثت تايوان تأثيراً عميقاً على الأنماط الحياتية الاستهلاكية في الصين من المطبخ وشاي ذي رغوة ودور النشر التايوانية وثقافة البوب وبارات الكاربوكي. وبرزت نجمة البوب التايوانية تيريزا تينغ وأدخلت موضوعات جديدة الى الموسيقا الصينية مثل الحب والحنين للماضي والرومنسية، متباينة مع موسيقى العهد الماوي التي اقتصرت على الأغاني الوطنية.
وهناك كوريا الجنوبية أيضاً فبحلول عام 2000 استوردت الصين 67 عملاً تلفزيونياً من كوريا الجنوبية.
إن ادخال ونشر الأسواق والاستهلاكية في الصين حدثا بطرق لا تعد ولا تحصى. وترتبت على ذلك آثار لا تزال تتكشف، فلا يمكن للمرء لوم تايوان في النمو الانفجاري للاستهلاكية الصينية. كما لا يمكنه لوم الولايات المتحدة ولا منظمة التجارة العالمية في ذلك. فهذا الانتعاش يعكس رغبة طال كبتها فيما لدى تايوان وغيرها. فعندما أرادت الصين الاستثمارات والتكنولوجيا التايوانية، فتحت الباب ولمح التايوانيون الفرصة واغتنموها.
جعل الوفرة هي القاعدة
يقول غيرث: قبل أن يتسنى أن تكون لديك ثقافة استهلاكية، يجب أن يكون هناك ما تشتريه بالطبع.
كانت صين ماو راكدة وفقيرة، بعبارة أخرى كان الصينيون لا يملكون إلا أقل القليل لينفقونه وخيارات الشراء كادت تكون معدومة. ومع مجيء الإصلاحات، شهدت الصين تحولاً سريعاً من الندرة الى الوفرة، مع زيادة مذهلة في عدد المنتجات المتاح شراؤها وأماكن الشراء التي وصلت إلى أصغر المدن الصينية وأقلها غنى. وتسنى للصينيين شراء كل ما يحتاجونه حتى صارت ممارسة الاختيار الاستهلاكي نشاطاً يومياً.
وتبنت الصين توسيع فرص تجارة التجزئة واستراتيجياتها وحقق ذلك أرباحاً بمليارات الدولارات، فسرعان ما بدأ عمالقة تجارة التجزئة الدوليون يتوسعون بشراسة في جميع أنحاء الصين مثل “كارفور” “ومترو وول-مارت”، بالإضافة الى السلع المستوردة المتاحة على نطاق واسع حيث تضم أرفف متاجر السوبر ماركيت الصينية كل شيء من تفاح واشنطن الى خمور كاليفورنيا ومن الليتشي التايلندي الى الزبد النيوزيلندي.
ويعطينا التاريخ الحديث للأرز تلك السلعة الصينية الأساسية مثالاً مذهلاً على تحول تجربة الشراء والاستهلاك في الصين، فكانت لا تمارس الرقابة على الجودة إلا قليلاً. وكان الأرز في أغلب الأحوال مكسوراً ومتفاوت الألوان والأسوأ من ذلك أنه كثيراً ما يحتوي على حشرات وحصى. وسمحت البيئة التنافسية للمستهلكين بالحصول على أصناف متنوعة من الأرز وتلبية تفضيلاتهم وخاصة “أرز جابونيكا”، الأكثر تفضيلاً في المناطق الثرية في شنغهاي وإقليم جيجيانغ.
وطلب المستهلكون الصينيون مثلهم مثل نظرائهم حول العالم الراحة وهذا ما حفز ظهور سلاسل متاجر الراحة التي تبيع جميع الأساسيات التي يحتاجونها، بما يلائم أذواقهم، مثل لاوسون اليابانية ونظيراتها الصينية، مثل سلسلة وولمارت الأميركية التي افتتحت أكبر عدد من المتاجر يمكنها إدارته لتحقيق الربح.
ولعله لا توجد مفارقة ساخرة تلقي الضوء بشكل أكبر على تغيّر العالم بالنسبة للمستهلكين الصينيين من حقيقة استخدام أعداد متزايدة منهم هذه الوفرة المستجدة من الاختيارات ليفرطوا في الأكل والاستهلاك، الذي تجلى أيضاً بطرق أخرى. ففي العهد الماوي لم يكن مفهوم بقايا الطعام شائعاً. أما الآن فطرح أكياس بقايا الطعام بشكل روتيني، فشنغهاي تلقي أكثر من ألفي طن من الطعام يومياً.
وفي مثال فاضح للتصرفات غير المدروسة للمستهلكين الصينيين استُخدم 90 طناً من البيرة لصنع نافورة وسط مدينة هاربين ولم يتطلب هذا العمل المثير 18 طناً من الشعير والأرز فحسب بل 1800 طن من المياه النظيفة.
التمييز السلعي والاعلانات
تحدث المؤلف في هذا الفصل عن ثقافة جديدة تجتاح الصينيين هي العلامات التجارية والإعلانات.
تطور الإعلان ليصبح صناعة هائلة في الصين تضم أكثر من 80 ألف شركة إعلان يعمل فيها أكثر من مليون شخص في الصين أكبر من نظيرتها الولايات المتحدة.
وقد نما الإنفاق الإعلاني في عام 2008 مدعوماً بأولمياد بكين الى نحو 70 مليار دولار، حتى صارت الإعلانات في كل مكان في الصين مع إدخال أحدث الأساليب الإعلامية العالمية. ولم يكن الغرض من الإعلانات مجرد توفير معلومات حول السلع والخدمات، بل المساعدة في خلق علامات تجارية لا تتضمن معلومات فحسب بل توقعات، كأن تظن أن قيادتك سيارة تويوتا بريوس تجعلك من حماة البيئة. إذن يعد الإعلان من أهم مكوّنات التميز السلعي في الصين الذي سعت إليه الصين لتصبح قوة عالمية.
يعطينا كارل الكثير من الأفكار حول سبب ظهور العلامات التجارية في الصين، منها أن الصادرات الصينية لها قيمة مضافة منخفضة. على سبيل المثال، لجهاز Ipod 30 غيغا بايت قيمة تصديرية هي 150 دولار، ولكن القيمة المضافة للعمال الصينيين تصل فقط الى 4 دولارات.
إن العلامات التجارية الصينية ضعيفة وحاولت الحكومة الصينية دعمها وإدارتها في استراتيجيتها، حيث تكمن المشكلة في أن المستهلكين الصينيين لا يثقون كثيراً في علاماتهم التجارية بسبب تقصيرها في الجودة والسلامة، والفضائح التي أضرت بسمعة الشركات المصنعة. وكان ذلك نتيجة ثانوية لثقافة تنتج الكثير من المنتجات المقلدة والمغشوشة، فلا يمكن للناس التأكد من أنهم يشترون الشيء الحقيقي وبالتالي لا يمكنهم التأكد من الاتساق والموثوقية التي هي حجر الأساس لأي عملة تجارية ومن دونها ليس لديك ما يمكن البناء عليه. لذلك سعت الصين إلى تطوير 100 ععلامة تجارية في المطاعم و50 علامة في الفنادق وعلامات بارزة في مجال الجمال. وفي صيف 2008 منحت 57 علامة تجارية لقب أفضل علامة تجارية في الصين، وأطلق الزعماء الصينيون والإعلام الصيني حملة اقتصادية قومية حضت الصينيين على شراء المنتجات الصينية.
ومن جانب آخر، كانت هناك عقبات أمام تطوير العلامات التجارية الصينية كون الصين أشبه بمجموعة من الأسواق المتنوعة لا سوق واحدة متكاملة. فهناك 400 علامة تجارية للسجائر في الصين التي تعد أكبر مستهلك للسجائر في العالم.
وفي ضوء ذلك يقول كارل “اذا كنت لا تسطيع صناعتها فاشترِها”.
فنجحت شركة تسيينغتاو للبيرة في بناء شبكة وطنية باستحواذها على 22 مصنع للبيرة محلي، وحتّمت قوة اليوان للشركات الصينية الاستحواذ على أصول أجنبية. مثال لذلك استحواذ شركة دونغشيانغ على العلامة التجارية كابا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشجعي كرة القدم البريطانيين، والآن هي علامة تجارية رائدة في عالم الملابس الصينية.
عواقب الاستهلاك البيئية
جميع التغيرات التي نراها في الأنماط الحياتية الجديدة في الصين من إنتاج واستهلاك، قد تسببت في فوضى بيئية هائلة. فغابات تتلاشى وصحارى تنتشر، مع تغطية المدن بالضباب الدخاني وانبعاثات الكربون التي تعد سبباً رئيسياً في تلوث الهواء وتغيّر المناخ ونفاد للموارد الطبيعية كافة.
فما وراء عيدان الطعام ليس مجرد شجرة مقطوعة إذ يشهد كل عام تحول ملايين الأشجار الصينية الى عشرات المليارات من أزواج العيدان الخشبية، وليست عيدان الطعام وحدها التي تمثل مشكلات بيئية، بل أيضاً ما يتناوله الصينيون من أطعمة. فتطور وازدهار الأسواق المتطرفة في الصين التي زاد فيها الطلب الشعبي على وصفات قائمة على علاجات مشهورة في الصين مثل دم السلاحف الذهبية لعلاج السرطان، وفرس البحر لعلاج الربو وأمراض القلب والعقم، وزعانف السلاحف المخللة لزيادة أعمار البشر، ولحم البوم لتحسين البصر، وزعانف القرش التي انتهى بها المآل الى أطباق الحساء الصينية الأغلى ثمناً للتقوية الجنسية الخ. كل تلك الرغبات الصينية الجامحة كان لها أثر عميق جداً وفيها استنفاد للحياة البرية والبحرية في العالم أجمع.
أما الشيء المخيف أكثر من كل ما عداه فهو التزام الصين بالاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري في الوقت نفسه الذي تندر فيه هذه الموارد أكثر فأكثر. فالصين تحرق فحماً أكثر مما تحرق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة. وهذا ما دفعها بالاتجاه نحو مناجم المعادن في إفريقيا لتغذية اقتصادها المتعطش للوقود.
وثمة مثال آخر للعواقب الكثيرة المترتبة على التوسع الكبير للاستهلاكية الصينية وهو أن الصين تتجه إلى أزمة قمامة، فهي تنتج ثلث قمامة العالم وتواجه مشكلات في معالجتها، وتضم ضواحي بكين وشنغهاي 7 آلاف مكبّ قمامة.
وقد تحولت بلدات بأكملها إلى مكبات نفايات إلكترونية؛ مثل بلدة غويو؛ التي تشغِّل أكثر من 30 ألف عامل في 5 آلاف محل عائلي للنفايات الإلكترونية. وتطرح الصين في النفايات سنوياً 28 مليون جهاز تلفزيون وغسالة، و70 مليون هاتف جوال.
لكن مشكلات الصين البيئية ليس سببها الصينيون وحدهم حيث يساهم الطلب العالمي على المنتجات الصينية الرخيصة أيضاً في خلق أزمات بيئية إضافية.
مثال لذلك: تنتج الصين ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية السنوية من الكشمير والبالغة 15 ألف طن، ويتطلب صنع الكنزة الواحدة شعر عنزتين أو أكثر. فينبغي أن يكون منظر ملايين المعز المطلوبة لإمداد هذه التجارة بالمواد الخام مخيفاً أكثر من كونه تجسيداً للحياة الرعوية.
وتؤكد صفحات الكتاب أن الحكومة الصينية والشعب الصيني يدركان المشكلات التي تشكلها الاستهلاكية وقد بذلا جهوداً كبيرة للحد منها. والأجدر ببقية دول العالم أن تفعل ما هو أكثر من المراقبة عن كثب وتبدأ في لجم أسوأ آثار الاستهلاكية مطلقة العنان كلٍ في بلده.