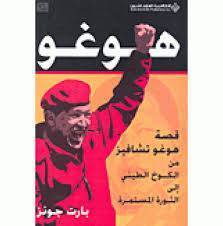قراءة: محمد يسري أبو هدور — يتناول الكتاب موضوعاً مهماً يتعلق بالحالة الفكرية والثقافية العربية الراهنة، حيث يلاحظ المؤلف أن السنين الأخيرة قد شهدت اهتماماً كبيراً بما يمكن أن نصفه بالمحاولة لإعادة قراءة التراث أو التاريخ الإسلامي، وفق منهج تأويلي حداثي.
إبراهيم السكران مؤلف سعودي إسلامي التوجه، حاصل على بكالوريوس في الشريعة وماجيستير في السياسة، وله عدد من المؤلفات والكتب التي تمحورت حول نقد الاستشراق والحداثة، ومن أهمها مصحف البحر الميت الذي قدم فيه رؤية نقدية لفكر المفكر الجزائري محمد أركون.
في مقدمة كتابه، يلفت الدكتور إبراهيم السكران نظر القراء إلى نقطتين مهمتين متعلقتين بهذا الموضوع، النقطة الأولى، وتتعلق بالمنهج، وتتمثل في أن الكثير من المفكرين الحداثيين العرب الذين طرحت أسماؤهم على الساحة فيما يخص مسألة تأويل التراث، قد تأثروا بشكل كبير بمناهج التأويل الفلسفية الغربية، وهو ما أدى إلى شيوع كتابات ومؤلفات العديد من الفلاسفة الغربيين من أمثال بيكون وهوبز وهيوم وروسو وهيغل، وبالتالي تأثر دارسي العلوم الإنسانية من العرب بهؤلاء ومدارسهم الفكرية دوناً عن غيرها.
أما النقطة الثانية، وتتعلق بالمادة العلمية، حيث يرى المؤلف أن المادة الخام التي استخدمها الحداثيون العرب في تأويلهم للتراث الإسلامي، إنما هي مستمدة بشكل كامل من أعمال المستشرقين، التي تذهب معظمها، إلى أن الحضارة الإسلامية إنما هي حضارة مستوردة، وإنها قد قامت على أفكار فارسية وقبطية وبيزنطية، ولا يوجد فيها أفكار أصيلة خاصة بها.
أجواء الفيلولوجيا
علم الفيلولوجيا، هو ذلك العلم الذي يختص بالتحليل الثقافي للنصوص اللغوية القديمة، حيث يقوم هذا العلم، على دراسة النصوص المكتوبة والمبكرة، وتحقيق نسبها، وتحليل محتواها الثقافي والحضاري، واستكشاف علاقتها بما سبقها من نصوص.
ويشير السكران إلى الالتباس الحاصل في تعريب مسمّى ذلك العلم، فالكثير من الباحثين عرّبوا مصطلح الفيلولوجيا بفقه اللغة، ولكن ذلك المصطلح المُعرّب لا يفي بقدرات وإمكانات وطبيعة المصطلح الأصلي، والسبب في ذلك أن مصطلح (فقه اللغة) هو بالأساس مصطلح تراثي، حيث قد تم استخدامه في العديد من الكتب القديمة مثل كتابات ومؤلفات ابن فارس والثعالبي، وكان معناه (علم أصول اللغة).
ويؤكد السكران على أن الفيلولوجيا كانت على الدوام من أهم الأدوات البحثية التي استخدمها المستشرقين لدراسة وفهم المشرق الإسلامي، ويجعل على رأس هؤلاء كل من غولدتسيهر ورينان ورودنسون، ويرى المؤلف أن هؤلاء المستشرقين قد استخدموا ذلك العلم في سبيل تشريح التراث الإسلامي، لإثبات أن معظمه إن لم يكن كله مقتبساً من حضارات وثقافات أقدم، ويسمّي السكران تلك العملية بالتوفيد.
ويطرح السكران سؤالاً مهماً حول شخصية الباحث العربي الذي كان له السبق في استعارة تلك المنهجية الإستشراقية، فيعترف إنه لا يملك اليقين الكافي للإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع، ولكنه يورد رأي شيخ المستشرقين الروس أغناطيوس كراتشوفسكي الذي يعتقد أن اللبناني جرجي زيدان كان هو أول الباحثين العرب تطبيقاً للفيلولوجيا في كتابه فلسفة اللغة العربية المنشور في عام 1886م.
في الفصل الثاني من كتابه، يطرح السكران تساؤلاً مشروعاً عن السبب الذي دعا المستشرقين إلى الاكتفاء بالأداة الفيلولوجية وحدها، وإهمال باقي الأدوات البحثية المطلوبة لدراسة التراث الإسلامي.
يجيب المؤلف على هذا السؤال بأن المستشرقين قد اكتفوا بالفيلولوجيا، لكونهم لا يستطيعون أن يُلموا بكلتلك العلوم والمواد المطلوبة لدراسة الإسلام، ويضرب على ذلك مثال بعلم الهرمنيوطيقيا، والذي يمثل علم نظرية التفسير في النظرية الغربية، فالمستشرقون الذين تعرضوا لتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستعانة بالمناهج الهرمنيوطيقية التي يستخدمها نظراؤهم في دراسة وتفسير النصوص الغربية، بل إن المستشرقين اكتفوا بالفيلولوجيا فحسب، لكونها أيسر لهم في التعامل والتطبيق من جهة، ولكونها تقودهم مباشرة إلى النتائج التي يريدون الوصول إليها من جهة أخرى.
وفي الفصل الثالث من كتابه، يتناول السكران بعض النماذج لعدد من الكتابات الحداثية العربية التي تأثرت بالطريقة الإستشراقية، فيضع على رأسها كتابات ومؤلفات الأديب اللبناني جرجي زيدان، ويبيّن بعض النقاط التي اقتبسها من المستشرقين، منها أنه في كتابه المشهور تاريخ التمدن الإسلامي، قد عقد مبحثاً بعنوان الميثولوجيا، وتحدث فيه عن الميثولوجيا عند العرب، وذلك برغم أن مصطلح الميثولوجيا هو من المصطلحات الحديثة التي لم يعرفها التراث الإسلامي.
ويوضح السكران نقاط التشابه والالتقاء ما بين زيدان والمستشرقين، فهناك التقاء لغوي، متمثل في اتقانه لثلاث لغات أوروبية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والتقاء ديني متمثل في اعتناقه للمسيحية، والتقاء شخصي متمثل في علاقاته المتميزة بالعديد من المستشرقين وعلى رأسهم الروسي كراتشوفسكي.
ويرى المؤلف أن أحمد أمين كان ثاني المفكرين العرب تأثراً بالمناهج الإستشراقية بعد زيدان، وان كتبه الأربعة (فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ويوم الإسلام) قد انتصرت لأراء المستشرقين في نقدهم للكثير من مواضع السيرة النبوية على وجه الخصوص، ولكن السكران يلفت النظر إلى أن أسلوب أمين كان أقل حدة من أسلوب المستشرقين، فقد كان (يعيد عرض التحليلات الإستشراقية بلغة دبلوماسية غالباً فلا يجرح القارئ ولا يثير سكينته وهو يدني تحته الطبق المسموم).
ويؤكد المؤلف أن أحمد أمين قد تعلم اللغة الإنجليزية خصيصاً لقراءة الأعمال الإستشراقية التي تناولت التراث الإسلامي، وعلى رأسها كتابات المستشرق الأميركي ماكدونالد ودائرة المعارف الإستشراقية وكتابات غولدتسيهر وفلهاوزن وبراون.
بعد ذلك ينتقل السكران إلى فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين والتي شهدت صعوداً سريعاً للمشاريع التأويلية ذات الخلفية الماركسية، ومن أشهر مفكري تلك الحقبة طيب تيزيني وحسين مروة وأدونيس وحسن حنفي ومحمد عابد الجابري.
إنبنى مشروع حسين مروة مثلاً على أعمال المناهج الماركسية والمادية التاريخية لتفسير ظهور وتطور كثير من المفاهيم الخاصة بالفلسفة وعلم الكلام والتصوف والتشيع والمنطق، وظهر ذلك كله واضحاً في كتابه الأهم (النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية).
وبرغم أن مروة قد وجه العديد من الانتقادات للمستشرقين الغربيين، فإن السكران يلفت انتباه القارئ إلى أن تلك الانتقادات كانت من زاوية الاستشراق الماركسي، وليس من زاوية التراثيين أو الإسلاميين.
ويقر المؤلف بأن مشروع مروة كان مثله مثل مشروع الطيب تيزيني محدود الأثر، وأن المشروعين لم يحققا نجاحاً أو انتشاراً على مستوى المثقفين العرب، بل بقي تأثيرهما محصوراً في دائرة المثقفين الماركسيين دون غيرهم.
أما مشروع أدونيس فهو مختلف بعض الشيء، فهو متخصص في تبيان التحولات والتغيرات الأدبية على وجه الخصوص، ولا يتجاوز تأثيره الأدباء المهتمين بالشعر والنثر.
بعد ذلك يقوم السكران بتحليل مشروع حسن حنفي، فيؤكد أن حنفي قد حاول أن يمزج ما بين المحورين الماركسي والإسلامي، وذلك من خلال “إعادة صياغة تنتهي بهما إلى مطالب الفكر اليساري، ليستثمر طاقة الحماس والتضحية في المعطيات الدينية كوقود للفكر اليساري، وهو ما يسميه إعادة بناء العلوم”.
ويرى السكران أن كتابات حنفي تحمل طابعاً متناقضاً لا يمكن إغفاله ولا التغاضي عنه، فالقارئ لمؤلفاته سيعتقد أنه يقرأ لشخصين لا شخص واحد.
ويلاحظ المؤلف أن كتابات حنفي المفعمة بالروح اليسارية، لم تأخذ حقها في الوعي اليساري المعاصر، ويفسّر هذا بأنه من الممكن أن تكون تلك الكتابات قد ظهرت في موسم بعد موسمها، أي أن ظهورها كان بعد انسحاب المشروع الماركسي الاشتراكي من الساحة الفكرية العربية.
كما ينبّه السكران إلى مفارقة مهمة وهي أن كتابات حنفي مع تأثرها الشديد بالماركسية، قد وجدت لنفسها مكاناً مهماً عند الاتجاهات النيوليبرالية الإسلامية في شرق آسيا في أندونسيا وماليزيا ونحوها، حيث استخدمها أفراد هذا التيار في سبيل المواجهة الفكرية مع ما يعتبرونه أصولية إسلامية وتزمتاً دينياً.
أما محمد عابد الجابري، فبرغم كونه قد اشترك مع اليساريين السابقين في الخلفية الماركسية، إلا أنه يختلف عنهم في مكونات ومعطيات جديدة، مما جعله – بحسب رأي السكران – يمثّل “بداية مرحلة فارقة، ومنعطف في التأريخ الحداثي للتراث”.
وتظهر الأفكار الماركسية بشكل واضح في كتابات الجابري في الكثير من المواضع، ولعل أهمها ما أورده في كتابه التراث والحداثة من أن “تاريخ الإسلام منذ قيام الإسلام إلى اليوم صراع بين الطبقات”، وكذلك رده للتاريخ السياسي الإسلامي كلّه إلى ثلاثة محددات وهي (العقيدة والقبيلة والغنيمة)، قبل أن يعود سريعاً ويفرغ هذه العوامل الثلاثة من معناها، ويجعلها كلها تابعة لعامل واحد وهو الغنيمة.
ويعترف السكران بأن الجابري في بعض الأحيان قد خرج من نطاق التبعية والهيمنة للفكر الماركسي، وذلك عندما “أعاد بعض اللحظات التاريخية المحدودة لعوامل أخرى لا اقتصادية”.
ويؤكد المؤلف على مدى تأثير المستشرقين في كتابات الجابري، وذلك بنقل بعض الاقتباسات عن الجابري، تلك التي يقول فيها إن تهمة الأخذ من المستشرقين تظل مصرة على ملاحقته دوماً، حتى أنه قد أخذ على نفسه عندما يكتب في موضوع ما، أن ينسى أو يتناسى جميع ما كتبه المستشرقون من قبل.
ويعرض المؤلف أسماء المستشرقين الذين تأثر بهم الجابري، ومنهم دي بور وأدم ميتز وكارل بيكر وماكس مايرهوف وغولدتسيهر وماسينيون وكوربان ونيكلسون وبرنارد لويس.
ويعرض السكران لعدد من النماذج الواضحة التي يظهر فيها تأثر الجابري ببعض أفكار المستشرقين، ولاسيما المسائل الفقهية والعقائدية والمذهبية.
وبعد استعراضه لتلك المشاريع التأويلية الكبرى للتراث، يتناول السكران عدداً من القراءات الحداثية الجزئية للتراث، تلك التي أخذت حقلاً محدداً أو موضوعات معينة ولم تكتب عروضاً تفصيلية شاملة، وقد اشتهر كثيرون ممن قام على ذلك، ومن أهمهم محمد أركون وفهمي جدعان وعبد المجيد الشرفي ووائل حلاق.
ويورد السكران بعض الاقتباسات من كتابات هؤلاء، لتأكيد اعتمادهم على مؤلفات المستشرقين وتأثرهم بها.
بعد ذلك يستعرض السكران بعض نماذج ما سماها بالمدرسة الأنثروبولوجية الإستشراقية، وهي تلك المدرسة التي ضمت عدداً من المستشرقين المعاصرين، الذين وجهوا جهودهم لنقد الأفكار والمفاهيم الأساسية التي انبنى عليها التراث الإسلامي.
من أهم أفراد تلك المدرسة المؤرخة باتريشيا كرون، التي بنت طرحها الرئيس على أساس عدم الوجود التاريخي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القرآن لم يكتب إلا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وكان ذلك بواسطة الحجاج بن يوسف الثقفي. كما أن باتريشيا قد أنكرت أن تكون بدايات الإسلام الأولى في مكة، وذهبت إلى أن ظهوره الأول كان في الأردن، واستندت في ذلك كله إلى الوثائق والعملات وبعض التشابهات في أسماء المدن والأقاليم. وبعد أن يعرض السكران سريعاً لأفكار تلك المدرسة ويذكر أسماء عدد من كبار روادها، يعلق على أفكارها قائلاً: “وربما ظن القارئ أنني ألقي ببعض الطرائف، ومن حقه ذلك، فهؤلاء المعتوهون بلغوا درجة من السخف يخجل منها المهرج”.
ويعرض السكران لآراء عدد من المستشرقين والباحثين التاريخيين الغربيين الذين نقدوا نظريات كرون وأصحابها بشكل واضح، واعتبروها محض هراء وسخف وتبتعد عن المنهجية العلمية الجادة الرصينة.
كما أن السكران يبيّن كيف أن أصحاب تلك المدرسة قد وقعوا في أخطاء منهجية لا تغتفر، وذلك عندما استدل الكثير منهم بالمصادر التاريخية الإسلامية وبنوا عليها الكثير من الآراء والاعتقادات، رغم نفيهم لصحتها وتأكيدهم لتزييفها في كتب أخرى لهم، وضرب نموذجاً على ذلك، بمايكل كوك في كتابه “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي اقتبس فيه من الكثير من المصادر التراثية، برغم أنه كان قد أنكرها قبل ذلك صراحة في كتابه المعنون بـ”الهاجريون”، الذي كان قد ألفه قبلها بالاشتراك مع باتريشيا كرون.
وفي الفصل الأول من الباب الثاني في الكتاب، يتعرض المؤلف لما سمّاه بتقنية التوفيد، والتي يرى أن المستشرقين قد لجأوا إليها لتفكيك التراث الإسلامي من جهة وخلخلة الروابط الكامنة في جزئياته، بحيث يبدو الأمر في النهاية وكأن جميع التشريعات والقوانين والأحكام الإسلامية، إنما هي تعود في أصولها إلى حضارات وتشريعات أخرى أكثر قدما وأصالة.
ويضرب السكران العديد من الأمثلة التي تؤكد على لجوء المستشرقين إلى تلك التقنية في معظم كتاباتهم، فكارل بروكلمان مثلاً قال إن شعيرة الصوم في الإسلام إنما هي مقتبسة من الدين المسيحي، وتغاضى عن عمد عن كل الفوارق الكبيرة والاختلافات الدقيقة والجوهرية ما بين الصوم في الإسلام والصوم في المسيحية، وأوليري يقول صراحة بأن أبو حنيفة والشافعي قد اقتبسا من الثقافة اليونانية عندما أصلا لمدرسة الرأي وعلم أصول الفقه في الإسلام.
وغولدتسيهر يؤكد على أن الأحاديث النبوية قد نقلت الكثير من الحكم الهندية والفارسية والفلسفة اليونانية.
ادعاءات المستشرقين لم تقف عند ذلك الحد، بل إنها وصلت لأن تنسب كتابات المغازي والسيرة والتاريخ إلى أصول فهلوية، فربطت ما بين كتب السيرة وكتب سير الملوك الفرس.
بل أن حتى العلوم اللغوية التي تطورت على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال بعض المستشرقين إنها إنما نقلها الخليل من صديقه ابن المقفع، الذي كان قد أخذها بدوره من التراث الفارسي والهندي، أما البعد الغيبي في الإسلام بما يشتمل من عقائد ومعجزات، فقد أرجعها بروكلمان إلى أصول يهودية.
ومن المواقف الطريفة التي يذكرها السكران، أنه برغم أن الاتجاه الإستشراقي يرى أن القصص القرآني بأكمله يعود إلى القصص الواردة في العهد القديم والكتب الدينية اليهودية الأخرى، إلا أن المستشرقين وجدوا أنفسهم أمام إشكالية حقيقية عندما وجدوا أن قصص عاد وثمود لم ترد في المصادر العبرانية، فاحتاروا في تفسير مصدرها ومرجعها الأساس وتكلفوا عبء تأويلها وتفسيرها عن طريق قراءات ملتوية واضحة الضعف والسطحية.
وفي الفصل الثاني من الباب الثاني، يتناول السكران الطريقة التي تمت بها إعادة تصنيع التوفيد عند الحداثيين العرب، ويضرب على ذلك الكثير من الأمثلة والنماذج، منها ما أورده أحمد أمين في “ضحى الإسلام”، من كون عقيدة السلف في الأسماء والصفات قد تسرّبت من العقائد اليهودية، وما أعلنه الحداثي التونسي هشام جعيط من كون القرآن مأخوذاً من الكتب السابقة، وقول الجابري بأن الحديث النبوي مقتبس من الثقافات الهرمسية والغنوصية.
بعد ذلك يوضح المؤلف أن المستشرقين قد نظروا لجميع ما ورد في التراث، وفق رؤية يغلب عليها التفسير السياسي، فقد حاولوا ان يجدوا في كل حدث أو إشارة أو موقف بعداً سياسياً يتصل ويتعلق بمسألة الصراع على الحكم والسلطة.
على سبيل المثال تيودور نولدكه، في كتابه “تاريخ القرآن”، قد فسّر اختيار الخليفة الأول لزيد بن ثابت تحديداً، للإشراف على جمع القرآن، بكونه اختياراً سياسياً هدف منه أن يفرض الخليفة سيطرته وأهواءه على الشاب الصغير، بحيث تتم عملية الجمع وفق رضا الخليفة وأوامره.
وبروكلمان فسّر انتقال الشافعي إلى مصر، على كونه محاولة لإيجاد منطقة نفوذ فكري جديدة وبكر، بعد أن كان المذهب المالكي قد فرض نفسه في الحجاز، والمذهب الحنفي فرض نفسه في العراق.
وكعادته، يورد المؤلف بعد ذلك الكثير من نماذج الكتابات العربية الحداثية، التي تظهر اتفاق جورج طرابيشي وأمين والجابري وأركون مع وجهات نظر أساتذتهم من المستشرقين، ومن الأمثلة التي يوردها السكران اقتباسه من كتاب “تكوين العقل العربي” للجابري المقطع الآتي: “ظاهرية ابن حزم كانت موقفاً سياسياً، لا بل إنها كانت بمثابة إعلان نضالي للمشروع الأيديولوجي الذي كان يختمر في الأندلس، ليكون السلاح النظري الذي تواجه به الدولة الأموية هناك خصميها التاريخيين: الفاطميين في مصر، والعباسيين في بغداد”، فالجابري هنا يرى أن المنهج الظاهري عند ابن حزم أراد به أن يكون سلاحاً للدولة الأموية ضد الفاطميين والعباسيين.
وفي الفصل التالي، يبدأ السكران في مناقشة عدد من النماذج السابقة ليبيّن تهافتها وضعفها، من ذلك ما ذكره غولدتسيهر في مسألة اختلاق الإمام الزهري لعدد من الأحاديث التي تقدس بيت المقدس، وذلك حتى يعطي لعبد الملك بن مروان مبرراً لتحويل الحج إلى فلسطين، لإضعاف نفوذ خصمه المسيطر على مكة عبد الله بن الزبير.
ويرى السكران أن تهافت رأي غولدتسيهر واضح، لماذا؟
لأن عبد الله بن الزبير قتل في 73ه بينما وفد الزهري على عبد الملك بن مروان في 82ه، وهو ما يعني أن بداية فترة الاتصال ما بين الزهري وعبد الملك، قد أعقبت حكم ابن الزبير، فلم يكن هناك داعٍ منطقي لاختلاق الحديث.
أما قول الجابري بأن الظاهرية قد نشأت في الأندلس لمد نفوذ الأمويين خارجها، فهو أمر يتضاد مع المعلومات التاريخية الواردة عن تلك الفترة، ذلك أن بني أمية في هذا الوقت كانوا يعانون من التشرذم والفرقة، وكانت سلطتهم داخل الأندلس تتعرض للاضمحلال والتحلل، وليس من المعقول أن يكونوا في هذا الوقت تحديداً ينظرون للتوسع ضد الفاطميين والعباسيين، كما يقول الجابري.
وقريب من هذا، ما كتبه نصر حامد أبو زيد في كتابه “الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية”، حيث قال إن الشافعي كان بكتاباته يقوم بمهمة سياسية لخدمة بني أمية، وما فاته أن دولة الأمويين كانت قد انتهت قبل ميلاد الشافعي أصلاً.
التأويل الحداثي للتراث: التقنيات والاستمدادات
إبراهيم بن عمر السكران
دار الحضارة-الرياض
الطبعة الأولى – 2014م
مراجعة: -محمد يسري أبو هدور
المصدر: الميادين نت