مراجعة: حسن صعب* |
التنّين الأكبر: الصين في القرن الواحد والعشرين
*تأليف: دانييل بورشتاين – أرنيه دي كيزا –
*ترجمة: شوقي جلال –
*الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالم المعرفة – الكويت): الطبعة الأولى: يوليو 2001.
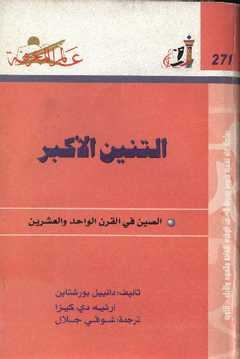
يتحدث هذا الكتاب عن أثر الصين – مستقبلاً – في الميزان الكوكبي للثروة والقوّة خلال القرن الحادي والعشرين. وهو يقدّم تحليلاً يتصف بالشمول والعمق للتحديات والفرص التي يفرضها ظهور الصين خلال هذا القرن، واحتمالات الصراع بين الصين، القوة العالمية البازغة، والولايات المتحدة التي تحاول تأكيد انفرادها بالهيمنة على العالم؛ ويعرض آراء متباينة للاتجاهات داخل الولايات المتحدة، وما يتعارض مع طموحاتها.
فالصين عام 2030 ستكون أكثر الأمم سكاناً، وأكبر اقتصاد عالمي، وقوّة عظمى بكل معنى الكلمة، وبما سيحوّل الميزان الكوكبي للثروة والقوّة خلال الألفية الثالثة. ولذا، يدعو مؤلّفا الكتاب إلى إقامة علاقات بنّاءة بين الصين والولايات المتحدة… القوّتين العظميين في عالم المستقبل؛ ويؤكد أن الصين لن تكون رأسمالية أو ديمقراطية حسب ما تتصور لها وتريد منها الولايات المتحدة، ولن تكون اشتراكية بالمعنى التقليدي.
إن المهمة الرئيسية التي يضطلع بها كتاب «التنّين الأكبر»، حسب قول المؤلفين في مدخل الكتاب (الحاضر يتخلّق)، هي تقديم الصين في ضوء أبعادها الكثيرة، وتجنّب النقد المتسرع، والعمل، بدلاً من ذلك، من أجل استكشاف وقائع حياة الصين، وهي دائماً وقائع مركّبة، وغالباً ما تكون غامضة، وتبدو متناقضة.
في الجزء الأول من الكتاب (في داخل الحرب الباردة الجديدة)، وفيه عدّة صول، يحاول المؤلّفان النظر إلى الصين عبر نافذة تكشف عن أكثر القضايا الإشكالية المطروحة على بساط البحث، أخطار الانسياق في حرب باردة مدمّرة ولا ضرورة لها بين أميركا والصين. لقد تعرضت العلاقة بين واشنطن وبكين لتحوّلات عديدة خلال العقد الأخير (من القرن العشرين)، وسادت خلال مطلع التسعينيات فترة مضيئة ومتفائلة. ثم اتسمت البيئة خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1997 بغلبة عديدة من المعارك السياسية الإيديولوجية والنزاعات الخبيثة التجارية والاقتصادية؛ علاوة على تصور الصين كشيطان يمثّل «إمبراطورية الشر» وسلوك الصين الاستفزازي على عدد من الجبهات، وبخاصة التهديدات العسكرية ضد تايوان.
يناقش الفصل الأول من هذا الجزء كيف ولماذا انحدرت كل من الولايات المتحدة والصين سريعاً جداً إلى هذه الحرب الباردة الجديدة، وما المخاطر بالنسبة للأميركيين، وما الذي يتعيّن عمله بعد ذلك، وكيف يمكن تجنّب أسوأ الاحتمالات.
ويرى المؤلفان أن «نشوب حرب باردة حقيقة مع الصين إنما يعني، على الأقل، مزيداً من النفقات الدفاعية للإنفاق على قوات أميركية مرابطة في الخارج، ويعني تعطّل جانب ضخم من الاقتصاد والتجارة، وأزمة مع حلفاء أميركا في آسيا، وقدراً أكبر بكثير من النزاعات داخل مجلس الأمن؛ وربما يعني مزيداً من الانتشار النووي، أو أنه يعني بإيجاز عالماً أكثر خطراً، وأقل قدرة على التنبوء بمستقبله».
وينقل المؤلفان عن جورج إف. ويل قوله إن «المتشائمين شبّهوا ظهور الصين كقوة عظمى بتصاعد قوة ألمانيا منذ عشرة عقود. وقد أمكن «حلّ» تلك المشكلة بخوض حربين بشعتين. وسوف يكون من الحكمة إلتماس وسائل أفضل لإلزام الصين بقواعد وقيود التعاملات الدولية. أما كيف يتحقق هذا، فذلك هو السؤال الكبير الذي يواجه الحياة الأميركية على مدى جيل كامل».
ويتحدث المؤلفان عن عام 1989 المشؤوم، الذي شهد حادثين مثيرين كان يمكن لهما أن تغيّرا طبيعة انطلاقة الأعوام السبعة عشر من العلاقات الصينية – الأميركية، أوّلهما مذبحة ميدان تيان آن مين في بكين، وثانيهما سقوط حائط برلين. ففي 4 حزيران / يونيو 1989، حُشِد الجيش الصيني لطرد الطلاب المتظاهرين ومؤيديهم من ميدان تيان آن مين (بلغوا المليون).
وجاء القرار باستخدام العنف ضد الطلاب بعد عدة أسابيع، احتلّ خلالها الطلاب الميدان الشهير؛ والحادث في سياق تاريخ الصين، ما كان له أن يصدم الأميركيين، بيْد أنه صدمهم، وعلى مستويات عديدة. حشد هائل وعنيف من المحتجين على نقيض صورة تحديث وإصلاح ودمقرطة الصين، وهي الصورة التي اعتادها الأميركيون تدريجياً. وكان الحادث صدمة لهم على وجه الدقة والتحديد، لأنه كشف على أي نحو تحولت الصين إلى النقيض.
وتمثلت نقطة التحوّل الأخرى في علاقة الصين والولايات المتحدة بانتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مع سقوط جدار برلين في ميدان بوتسدام، في تشرين الثاني / نوفمبر 1989. وهكذا بدا كأن ورقة الصين لم يعد لها قيمة في نظر واشنطن للتعامل مع روسيا، التي عمّتها الفوضى وعدم الاستقرار. لقد كانت الورقة يقيناً ذات قيمة كبرى، وقت التعامل مع الاتحاد السوفياتي المستقر والعدواني والمسلّح نووياً.
وبعد عرض المؤلّفين لأبرز مراحل التنافس والتعاون (الأميركي) مع القوة الاقتصادية العالمية الجديدة، أي الصين، يناقش المؤلفان طبيعة التحدّي الصيني كتهديد أم كفرصة، فينقلان عن مراسل الصين السابق لصحيفة نيويورك تايمز، نيكولاس كريستوف، التساؤل الآتي: هل يمكن مقارنة صعود الصين مع صعود ألمانيا في القرن الماضي؟ هناك فروق كبيرة، لكن الصين تشترك مع ألمانيا ذلك الحين في الشعور بالكبرياء المجروح، ويفيق المارد الذي مزّق وخُدِع من قِبل بقيّة العالم… والآن يعيش ثورة صناعية ويبني ترسانة أسلحة ستسمح له، خلال عقد أو عقدين، بالثأر للأخطار التي ارتكبت في حقّه.
أما مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، فيرى أنه «آن الأوان لكي نكفّ عن رؤية الصين من خلال عدسات التهديد، وأن نبدأ برؤيتها على أنها الفرصة العظيمة التي تمثّلها بالفعل».
ومن زاوية حقوق الإنسان تحديداً، في الصين، والتي يراها الأميركيون كأكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، يقول وليام أوفرهولت «يسمع الأميركيون التفاصيل الدقيقة عن انتهاك الصينيين لحقوق الإنسان على النحو الذي يريدونه هم في الحقيقة، ولكنهم يجهلون تماماً مظاهر التحسن الاستثنائية في حرية الكلام وحرية الحركة وحرية العمل… وهي مظاهر تستثير اهتمام كل من يراقب الصين عن كثب. إن الساسة الأميركيين والصحافة الأميركية يكادون يقصرون تعريفهم لحقوق الإنسان في حدود مصير حوالى 2000 من المنشقّين، ويُغفلون مظاهر التحسين في حريّة.. خمس الجنس البشري».
معايير الحكم على الصين
الجزء الثاني من الكتاب (معايير الحكم على الصين)، يعرض المؤلفان بعض السبل التي يتضافر خلالها الإرث الثقيل الذي ورثته الصين عن الماضي، وكذا حجمها السكاني الضخم، والخلفية الإقطاعية، والأرضية الشيوعية لنظامها السياسي، وغير ذلك من عوامل، بحيث تكبح وتشكّل مسار تحوّلها في المستقبل في اتجاهات مغايرة للاتجاهات الكلاسيكية التي عرفها اقتصاد السوق الديموقراطي في الغرب. إن الجميع يعرفون أن الصين «مختلفة» عن الغرب.
فالصين لديها أفكار كثيرة متناقضة عن نفسها؛ إنها تريد أن تُعامَل كقوة عظمى، ولكنها لا تزال تنتظر الاعتبارات الخاصة، التي تحظى بها البلدان الفقيرة والنامية. وتحتفظ الصين بقبضة حقيقية إزاء المنشقّين، ولكنها تسمح بدرجة مذهلة من الحريّة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وبدأت تمارس انتخابات حرّة مفتوحة على المستوى المحلي، واتخذت خطوات فعّالة لتعزيز سيادة القانون، ولكنها لا تزال تعقد محاكمات عامة لإدانة معارضي السلطة.
وتبدو الصين عند نقطة ما مندفعة بقوّة في اتجاه أساليب الحياة الأميركية، والرخاء والنزعة الاستهلاكية؛ وفي فترة أخرى تُعلن الصين أن أميركا هي العدو، وتعلو نغمة القومية الصينية، وأن كل ما هو أميركي، تقريباً، غريب.
ويبدو واضحاً أن الغرباء الراغبين في فهم حاضر الصين ومستقبلها، من الأفضل لهم أن يطرحوا جانباً، عند الباب، جميع افتراضاتهم الثقافية الخاصة بهم، مع تقدير كبير لحقيقة واقع الصين المتعدد الشرائح.
إن قيام علاقات أميركية ناجحة مع الصين يعتمد على فهم مظاهر الصعود والهبوط على المدى القصير، في سياق عملية المدى البعيد الجارية. ولدى الصين الآن سجل لفترة زمنية طولها عقدان، هي فترة المجاهدة على طريق التحديث، وإنها لعملية مشوّشة لا تنطوي على رؤية واضحة، فضلاً عن أن زعماءها ليسوا من النوع الذي ترتاح إليه أميركا. وهي مرحلة زاخرة بالتناقضات والنكسات.
ويتوقف المؤلفان عند البلوى القاتلة، أي الفساد، التي لا تكف عن تسميم الاقتصاد الصيني وتخرّب، في الوقت ذاته، القدرات الراهنة بالفعل، للمجتمع الذي أغرقته الضغوط الزائدة، ويعترف قادة الصين أنفسهم بأبعاد المشكلة، ويكافحونها بجدٍ ونشاط؛ رغبة منهم – على الأقل – في الحفاظ بقبضتهم على السلطة.
ولكن، في نظرة من زاوية أخرى للفساد، فإن بعض الأنشطة التي تندرج مظاهرها ضمن الفساد، ربما تعبّر فقط عن تطوّر اقتصاد غير رسمي. والمعروف أن أحد العوامل التي أسهمت في النمو البارز للصين، خلال الأعوام الأخيرة، هو قدرة الشركات ومؤسسات الدولة والمدن والأفراد، ممّن لهم نزوع واضح إلى تنظيم المشروعات، على انتهاز حالة الازدهار، والشروع في عمليات صنع وبيع المنتجات، وخلق قنوات للتوزيع واستئجار عمّال… إلخ.
وفي النتيجة، فإن قدراً محدوداً من الفساد يتعيّن أن يُنظر إليه باعتباره حليب الأم اللازم لإرضاع اقتصادات السوق في الصين، وكذا الناتج الحتمي للانتقال من الهيكل الماضي إلى المستقل. وهنا يظهر السؤال: هل هذا الوجه لبارونات السرقة في المجتمع الصيني ليس سوى مرحلة في عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الحديث، أم أن الفساد سينغرس بجذور عميقة في النظام، بحيث يقوّض جهود التحديث؟
القفز في البحر
في الجزء الثالث (القفز في البحر)، يعرض المؤلفان نظرة من الأرض إلى السماء عن «اختلافات» الصين عن الغرب، مع صورة إجمالية لمنظمي «المشروعات الأربعة» بحقائبهم، عدد من أغنى وأنجح رجال الأعمال الخاصّين في الصين اليوم. ويضفي الكلام هنا وجهاً إنسانياً على القضايا المعقدة المقترنة بمفهوم «الملكية» وإنشاء قطاع «خاص» حقيقي في الصين.
أحد رجال الأعمال هؤلاء، جانغ وي، هو واحد من منظّمي المشروعات الصاعدين في شنغهاي، لكنه ليس من أغنياء الصين الجدد، الذين أسرهم حبّ التظاهر بعد أن أثروا فجأة، وباتوا يتلهفون على الاستمتاع بالثروة. إنه على العكس، مثال متميز لقيم ومهارات منظّمي المشروعات الجادّة في قلب المرحلة الثانية للاقتصاد الصيني.
وتمثّل مسألة الملكية عامل تميّز مهماً يمايز جانغ كثيراً عن أقرانه من منظّمي المشروعات في العالم. فالملكية في الغرب مبدأ واضح بشكل عام، بحيث إن أي شبهة غموض يمكن حلّها وحسمها وتوضيحها تأسيساً على مجلّدات من قانون الملكية وقانون الأوراق المالية وقانون الشركات، وغيرها.
وقد تُثار أسئلة بشأن من يملك ماذا في أميركا، أو في اقتصادات سوق أخرى. ولكن توجد وسائل فعّالة للغاية للإجابة عن الأسئلة. بيْد أن الأمر في الصين ليس على هذا النحو؛ إذ ليس واضحاً من يملك فعلاً، وماذا يملك حقيقة من الكثير من الشركات الصينية، أو ما الحقوق التي تُثبتها هذه الملكية.
فعلى سبيل المثال، من الصعب أن نجد في قصة جانغ خط تقسيم واضحاً، يفصل بين عمله قديماً موظفاً حكومياً في شنغهاي، وعمله الآن رئيساً لشركة «خاصة»، وهو شارك لبعض الوقت في عملين من مشروعات الأعمال: العمل «القديم» حيث شغل منصب نائب المدير العام لشركة في شنغهاي مملوكة للدولة، تحت اسم اتحاد إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة في منطقة بودونغ في شنغهاي، والعمل الجديد الذي يحتل فيه منصب رئيس الأملاك السائلة شرق شنغهاي. ويقول جانغ: «أثار ذلك حيرة وتشوّشاً عندي، لذلك قررت التوقف عن العمل مديراً عاماً لشركة الأصول الحكومية».
وحين يُلقي جانغ نظرة إلى الخارج، شأنه شأن كثيرين من نظرائه من رجال الأعمال، فإنه يؤكد أثراً قوياً من الكبرياء الثقافي الذي يسري في عروق النزعة القومية السياسية. وهو يرى أنه «لا الولايات المتحدة ولا اليابان تجرؤ على شن حرب ضد الصين، ذلك لأن الحرب ستحرمهم من سوق الصين التي تمثّل شيئاً جوهرياً لاقتصادهم. إن الصين إذا لم تشترِ سيارات وطائرات وما شابه ذلك من الولايات المتحدة، فإنكم أنتم الذين ستضررون، ولن نتأثر نحن بشيء».
التكهّن بمستقبل الصين
في الجزء الرابع من الكتاب (التكهّن بمستقبل الصين)، يطرح المؤلفان – تأسيساً على ماضي وحاضر الصين – توقعاتهما بشأن مسار تطورات الصين مستقبلاً خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2024. كما يتأملان مستقبل النظام السياسي وعدداً من القضايا الرئيسية، مثل هونغ كونغ وتايوان، وظهور قيم اجتماعية وثقافية جديدة؛ ويبحثان في نشر إطار مرجعي جديد للصين وما الذي يعنيه هذا بالدقة بالنسبة لمشروعات الأعمال والمال وعلم الاقتصاد.
وفي السياق، لا يعتقد المؤلفان أن قمّة خطوط النزاع (بين الصين والولايات المتحدة والغرب) ستصل إلى حرب نووية أو عالمية ثالثة، كما يفترض هننغتون، الذي يفصل بين الحضارات في إطار قراءته لها. ويقدّر المؤلفان أن نشوب «صدام حضاري» بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين الغرب وآسيا، مسألة أكثر تعقداً ومرونة ودينامية، وأكثر قابلية للتغيّر من الصورة التي قدّمها هننغتون. إن الصين ليست فقط بصدد إعادة تأكيد جذورها كحضارة عظمى متمركزة حول قيم كونفوشية، بل هي كذلك تستوعب الكثير والكثير جداً من الغرب وتبدع الجديد الكثير.
ويتفق المؤلفان في هذه النقطة مع المضاربين على صعود الصين: إن التوجه بحكم الضرورة نحو التنمية الاقتصادية، والمصالح والاحتمالات الجديدة، التي ستتولد عن الحداثة والرخاء، كل هذا سيؤكد فعاليته القوية لكبح جماح أسوأ الدوافع العسكرية والسياسية للصين.
كما أن الصين بدأت مسيرة طويلة للبحث عن قيم جديدة، بموازاة التحديث الاقتصادي والاجتماعي، حسب اعتقاد مؤلفي الكتاب، اللذان ينقلان عن وانغ ويبينغ wang wuebing رئيس بنك الصين، قوله إن الفكر الكونفوشي يمكن أن يشكّل أساساً لنظام اقتصادي يستهدف النمو والربح، ويحقق – كذلك – ملاءمة مهمة وواسعة مع القيم الاجتماعية والأخلاقية والفلسفية؛ علاوة على هذا أنه يخلق إمكانات لسياسة استبدادية يمكن تخفيف حدّتها باقتصادات خيّرة النوايا، وزعماء أقوياء، ونظم تراتبية هرمية غير رسمية تحدّد المعايير المتفق عليها للأخلاق والسلوكيات العامة، من دون قدر كبير من المراقبة الديموقراطية.
ما بعد الحرب الباردة
في الجزء الخامس والأخير من الكتاب (ما بعد الحرب الباردة)، طرح المؤلفان عدداً من المقترحات المحدّدة لدفع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين نحو مزيد من الشراكة، وبعيداً عن مظاهر سوء التفاهم ذات الخطورة والذم المتبادل، على نحو ما كانت عليه الحال في الماضي القريب. إن هذه الشراكة هي من النوع الذي يعترف بالاختلافات، حيث الاشتباك يعني التفاعلية الدينامية، وليس مجرد تعبير مخفّف عن التدخل أو النزاع الذي لا يتوقف.
ولإعادة ترسيخ فكرة الشراكة الأميركية – الصينية، اقترح المؤلفان توقيع وثيقة جديدة في 27 فبراير/ شباط 2002، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لبيان شنغهاي (الذي صدر في 27 شباط/ فبراير 1972، والذي يتضمن الزيارة المهمة للرئيس الأميركي نيكسون إلى الصين، ووضع القواعد الأساسية للعلاقات الأميركية – الصينية منذ ذلك الحين). ولعلّ أنسب الصيغ سوف تفيد في آن واحد الإحساس بالتواصل وإنعاش الالتزام المتبادل بعلاقات أكثر نضجاً؛ وكلمة معاهدة تعطي صورة رسمية للغاية، وكذلك عبارة بيان مشترك وباتت الحاجة ملحّة لدى طرفي العلاقة: الولايات المتحدة والصين، إلى ميثاق جديد: ميثاق شنغهاي. ولعل ما هو أهم من دقة الكلمات الواردة في الميثاق (المفترض)، أن التطورات الديبلوماسية وإدارات شؤون الدولة اللازمة للوصول إلى هذا الميثاق، سوف تشير إلى أن الطرفين قد ابتعدا عن الهوّة التي انزلقا إليها مع نهاية القرن العشرين. وسوف يقول الميثاق للعالم إن القوتين العظميين للقرن الجديد ستدخلان العصر الجديد يحدوهما الأمل والثقة، ليُسهما معاً من أجل الوفاء بوعد عظيم: السلام والرخاء والانتعاش الاقتصادي الكوكبي.
لكن تطورات العقدين الأخيرين، وخاصة في عهد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، كشفت عن «هزالة» أو «شاعرية» بعض أفكار مؤلّفي هذا الكتاب، والتي لا تقلّل من أهميته على أيّ حال.



